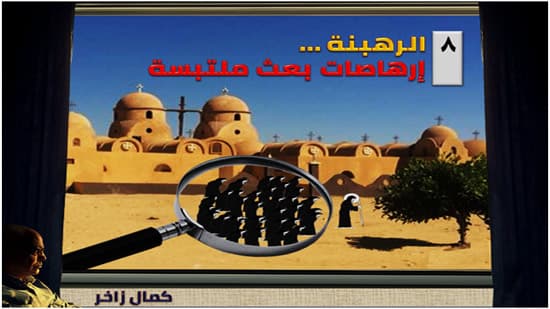- ١) ما قبل اﻷزمة
- ٢) نؤمن
- ٣) التاريخ بين الاسترداد والمؤامرة
- ٤) محاولات مبكرة للخروج
- ٥) البابا يوساب: من ينصفه؟
- ٦) أيقونات علمانية قبطية
- ٧) الدور العلماني بين التكامل والتقزيم
- ☑ ٨) إرهاصات بعث ملتبسة
- ٩) والعلمانيون يضرسون
- ١٠) العرب والانقطاع المعرفي الثاني
- ١١) جدداً وعتقاء
- ١٢) كتاب يصنع حراكاً
- ١٣) البنّاء الصامت
- ١٤) سنوات البعث
- ١٥) البابا شنودة: البدايات والصعود
- ١٦) البابا شنودة: اﻹكليريكية
- ١٧) البابا شنودة: الرهبنة واﻷسقف العام
- ١٨) البابا شنودة: تحولات وارتباكات
- ١٩) البابا شنودة: سنوات عاصفة
- ٢٠) البابا تواضروس: طموحات ومتاريس
- ٢١) تفعيل آليات التنوير
- ٢٢) الخروج إلى النهار
- ٢٣) خبرات غائمة
- ٢٤) خبرة معاصرة
- ٢٥) مسارات التفكك وسعي المقاربة
- ٢٦) التجسد: اللاهوت المغيّب
- ٢٧) لنعرفه
- ٢٨) لكنها تدور
- ٢٩) عندما تفقد الرهبنة أسوارها
- ٣٠) الرهبنة: مخاطر وخبرات
- ٣١) الرهبنة: سلم يوحنا الدرجي
- ٣٢) أما بعد
في الترتيب الهيراركي (الهرمى) الكنسي، يأتي موقع البابا البطريرك على قمة الهرم، يعاونه ويقود الكنيسة معه مجلس المطارنة والأساقفة، ولكل منهم نطاق جغرافي يتولى مسئوليته الرعوية والتعليمية يسمى إيبارشية (مقاطعة)، وتضم عددًا من الكنائس يقوم على رعايتها القمامصة والقسوس، يعاونهم فيها الشماسة.
واستقر الأمر على أن يتم اختيار البابا البطريرك والآباء الأساقفة من الرهبان، المتبتلين، بينما يتم اختيار الآباء القمامصة والقسوس والشمامسة من الخدام، المتزوجين أو المتبتلين، والمصدر الرئيس للفئة الأولى “الأديرة” بينما تكون الإكليريكيات هي المصدر الرئيسي للفئة الثانية، باستثناء الشمامسة الذين يتم اختيارهم من الصبية والشباب بعد إعدادهم وتدريبهم داخل الكنائس المحلية.
وتأسيسًا على ذلك، نحن إزاء ثلاث مصادر: الأديرة، والإكليريكيات، ومنظومة تعليم النشء -مدارس الأحد والاجتماعات النوعية- وبحسب حال المصادر تكون حالة الكنيسة، صعودًا وتراجعًا، وينعكس ذلك بالضرورة على قدرة الكنيسة على تحقيق رسالتها، وينعكس حالها بالتبعية على منظومات الرعاية والتعليم داخلها.
ويرتبط نجاح الكنيسة في رسالتها بقدر إدراكها ووعيها لماهيتها، فالمسيح هو “موضوع” إيمان المسيحية،
والكنيسة، البشر والمؤسسة، هي موضع الإيمان؛ تعيشه وتعلنه، وتطفق تبشر به كل العالم.
ومن ثم فانشغال الكنيسة، “الموضع”، بمواضيع أخرى، يقذف بها بعيدًا عن مسارها الصحيح.
وتتميز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأنها “كنيسة الشعب”، تترجم في تفاصيل يومها قيمة التكامل والتناغم، وقد حولت الزمن إلى زمن ليتورجي، توقِّع فيه تدبير الخلاص على الأيام والشهور، في إبداع وبصيرة، تشهد لها، بين القراءات اليومية والألحان الموسمية، وطقوسها وأصوامها، وآيتها الحضور الإفخاريستي الذي لا ينقطع، ولا تعرف الطبقية بين مكوناتها، وتحترم، في تراتبيتها توزيع المهام والمسئوليات، تعرف السلطان ولا تنحرف به إلى التسلط.
وإذا كنا قد تناولنا بعض من ملامح وملابسات إعادة تأسيس الإكليريكيات، ولنا عودة لما طالها من ارتباكات وتراجعات، فنحن اليوم نعرج على منظومة الرهبنة، والتي طالها ما طال الكنيسة والأقباط على إثر الانقطاعات المعرفية، والعزلة التي فرضت على المشهد بجملته، والتي أشرنا إليها قبلًا، حتى صارت الأديرة، لقرون طويلة، محلًا لروايات تلفها الأساطير تضم بين جنباتها كهول وشيوخ انقطعت بهم السبل عن الحياة العامة، لكنهم استطاعوا بالرغم من ذلك أن يحافظوا على أساسيات الحياة الرهبانية، وأن يختبروا حياة التقوى، واجتهدوا في الاحتفاظ بجذوتها مشتعلة، رغم ما عبر عليها من أنواء واستهدافات، وَهَنْت دهرًا لكنها لم تمت.
وقد انتبهت الكنيسة مبكرًا لما تملكه الرهبنة من قدرات وخصوصية، وقد عاشت النسك والترك والبتولية برؤية إنجيلية، منذ تأسيسها الأول في القرن الرابع الميلادي، وقد تجلت هذه القدرات في الدور المحوري الذي قام به مؤسسها القديس أنطونيوس، الذي خرج من عزلته بالصحراء الشرقية وقصد الإسكندرية يجول بين الناس ليثبّت إيمانهم، بينما كان البابا أثناسيوس الرسولي يخوض معاركه في “نيقية” معلنًا يقينية الإسكندرية بلاهوت الابن، ومساواته للآب، وإنسانيته الكاملة، التي بها انتقلت لنا كل مفاعيل الفداء والخلاص، وانتقلنا من دائرة العبيد إلى البنوة.
كانت الرهبنة آنئذ، حركة علمانية شعبية بحصر المعنى، فتجلى وقتها معنى التكامل بين الإكليروس في أعلى نقطة وبين العلمانيين في أبهى صورهم، وبينهما نضع ايدينا على سر كنيسة الإسكندرية أنها جمعت بين “المعرفة الدينية” و”الأخلاق الدينية” التي تترجمها أدبياتها في مصطلح “حياة التقوى”، والتي عندما تغيب نتعرض لرياح الصراع، ويتحول اختلاف الرؤى الصحي إلى معارك طاحنة مفسدة للكروم.
سعى البابا أثناسيوس لاستثمار قدرات الرهبنة لتصبح قيمة مضافة للكنيسة المؤسسة، فعرض على ق. أنطونيوس أن يبقى معه يعاونه في تدبير الكنيسة، لكنه تمسك بكونه راهبًا ومحله المختار مغارته القابعة في جبال البحر الأحمر، وأمام إلحاح البابا البطريرك، أرسل له اثنان من تلاميذه الرهبان لينضموا إلى طاقم معاونيه، ويصير الأمر تقليدًا، ينقله عنه الباباوات اللاحقين، ويرسم بعضهم أساقفة، ثم ينتهى الأمر ليصير كل الأساقفة والبطاركة من الرهبان حصرًا، إلا قليلًا.
وتجرى في نهر الكنيسة والبلاد مياه كثيرة، وتقتحمنا رياح التنوير القادمة من الغرب، وتدرك الكنيسة ما يحيق بها من أخطار، ولم يعد القصور الذاتي كافيًا لاستمرار حركة عجلتها، فتبدأ في حركة استفاقة، رأينا طيف منها مع البابا كيرلس الرابع، واستكملها البابا كيرلس الخامس، والذي امتدت حبريته لنصف قرن ويزيد (1874ـ 1927) الأمر الذي أتاح له السير في مسارات نهضوية عديدة، لكننا لا نفهم التباين بين موقفه من حراكين علمانيين دعم أحدهما بقوة، تأسيس مدارس الأحد، وناصب الآخر العداء، بقوة أيضًا، إنشاء المجلس الملي؛ لكنه يبقى علامة مضيئة في مسار التنوير.
تشهد الأديرة قدوم ثلاث شبان طلبًا للرهبنة، اثنان عام 1948، (سعد عزيز، ليسانس حقوق، الأب مكاري الصموئيلي السرياني)، (يوسف إسكندر يوسف، بكالوريوس صيدلة، الأب متى المسكين الصموئيلي السرياني)، والثالث عام 1954. (نظير جيد، ليسانس آداب، الأب أنطونيوس السرياني) يجمعهم أنهم باكورة من يقصدون الرهبنة من خريجي الجامعات، وكان كل منهم يحمل تصورًا ودافعًا مختلفًا عن الآخرين.
ويمكن للمتابع أن يقسم تاريخ الرهبنة إلى ما قبل رهبنة ثلاثتهم وما بعدها، إذ صاروا حافزًا لكثير من الشباب للاقتداء بهم، ليشهد دير السريان تحديدًا إقبالًا لافتًا من العديد من طالبي الرهبنة من خريجي الجامعات بل وبعضهم هجر كليته قبل أن يستكمل دراسته ليلتحق بالدير، وكان لشبرا ذلك الحي القاهري العريق نصيب الأسد.
ويمكن فهم الكثير من تطورات المشهد الكنسي من خلال فهم العلاقة بين هؤلاء الشباب الثلاثة فيما بينهم من جانب، وفيما بينهم وبين الأب القمص مينا المتوحد (البابا كيرلس السادس فيما بعد)، من جانب أخر.
اللافت أن الراهب الشاب أنطونيوس السرياني (عامان من الرهبنة)، والراهب الشاب متى المسكين (ثماني أعوام من الرهبنة) يتقدمان للترشح للكرسي البابوي، عقب خلوه برحيل البابا يوساب الثاني، (نوفمبر 1956)، الأمر الذي ازعج الحكام الجدد وهم من نفس جيل هؤلاء الرهبان، وأزعج شيوخ مجمع المطارنة والأساقفة، إذ توجس كلاهما من أن يكون البابا القادم منهما، وإن تباينت الأسباب، فيتم تعديل لائحة انتخاب البطريرك لتصدر بعد شهور قليلة (1957) تحمل شرطين جديدين لمن يتقدم للترشح؛ ألا تقل مدة رهبنته عن خمسة عشر عامًا، وألا يقل عمره وقت الترشح عن أربعين عامًا، فيستبعدا كلاهما، إجرائيًا. فيبادر شباب الرهبان بالدفع -عبر من لهم حق ترشيح أسماء- باسم الراهب القمص مينا المتوحد، الذي يلقى ارتياحًا من جهتي الحكم بالدولة والكنيسة، ليصبح البابا كيرلس السادس.
ويصير التساؤل هل كانت محاولة الترشح بداية المواجهة بينهما، أم كانت إحدى نتائجها؟
كان كل منهما ينتمى لمدرسة مختلفة، في قراءة مستقبل الكنيسة، المنهج والآليات، لكنهما جذبا العديد من الشباب خلفهما، لتتغير خريطة الرهبنة، وتشهد الأديرة نوعيات جديدة من قاطنيها، وتتعدد التخصصات المهنية والخبرات داخل أسوارها، وتتوسع الأديرة تبعًا لذلك في استصلاح الأراضي الصحراوية المحيطة بها، ويتبعها ظهور التصنيع الزراعي بها، وتحقق الأديرة اكتفاء ذاتيًا، وتخرج بمنتجاتها إلى الأسواق حتى إلى عواصم المحافظات، وبعضها إلى التصدير. وتصبح رقمًا مهمًا في اقتصاد الكنيسة.
يرحل البابا كيرلس السادس، 1971، ليترشح الأب متى المسكين والأنبا شنودة أسقف التعليم مجددًا للكرسي المرقسي، ومعهما آخرين، ويرسل أسقفان خطابًا للرئيس السادات يحذرانه من “الراهب الأحمر”، يشيران فيه إلى أن للأب متى المسكين ميول شيوعية، وتزامن هذا مع اتجاه نية الرئيس لتصفية الوجود السوفيتي بمصر، فيستبعد من الانتخابات(!!). وعندما يلتقى السادات بالأب متى المسكين في أزمة سبتمبر 1981 يطلعه على الخطاب.
يأتي البابا شنودة الثالث إلى البابوية، وتشهد الكنيسة توسعًا في رسامة أساقفة شباب، تحت شعار “إيبارشيات أصغر خدمة أفضل”، وتتوسع الأديرة في رسامة الرهبان كهنة، وتظهر قوائم انتظار بحسب أقدمية الرهبنة، وتزاحم أعمال الزراعة والتصنيع الزراعي والتسويق واجبات الراهب الأساسية، التي تجاوزت مفهوم “عمل اليدين، وتنفتح أبواب الأديرة للزيارات، التي تصبح إحدى محاور السياحة الداخلية على برامج شركات السياحة، لتبتلع ما بقى من وقت الراهب وربما سلامه، ويختفى شيوخ البرية، ويختفى معهم نسق التلمذة عمود الرهبنة الفقري، وتئن الأديرة وتئن الكنيسة، وينعكس هذا على المنتج الديري البشري، وعلى الدور البحثي للأديرة.
وللحديث بقية.
صدر للكاتب:
كتاب: العلمانيون والكنيسة: صراعات وتحالفات ٢٠٠٩
كتاب: قراءة في واقعنا الكنسي ٢٠١٥
كتاب: الكنيسة.. صراع أم مخاض ميلاد ٢٠١٨