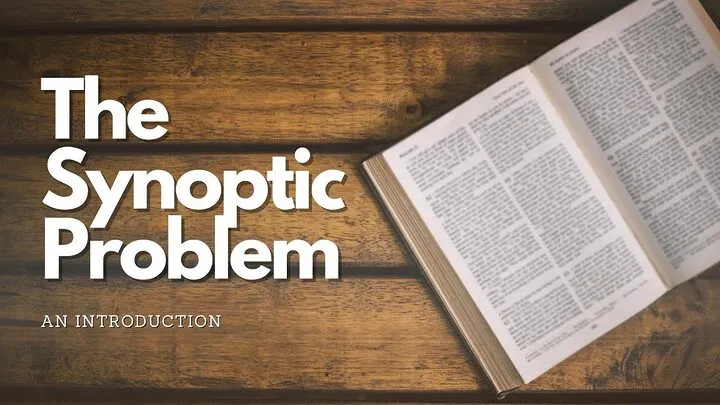المُشكلة الإزائية [1]، هي السؤال الذي يجتهد الأكاديميون في الإجابة عليه بخصوص العلاقات النصية بين البشارات الثلاثة الأولى [مرقس، متى، ولوقا].
في هذه السلسلة سوف نتعرض للمحورين الأساسيين في إجابة مجموعة جيدة من الأسئلة الرئيسية التي تحيط ببشارات العهد الجديد، وهي؛ أي الأناجيل جاء أولًا؟ وما هي علاقة متى ولوقا بمرقس؟ وهل توجد مصادر أخرى لتلك البشارات أم لا؟ إضافة إلى ذلك، تسلط السلسلة الضوء على كيفية تفاعل المسيحيين الأوائل مع نصوص البشارة، وكيف حررت الكنيسة تلك البشارات وصاغتها بمرور الزمن لتُواكب احتياجات المؤمنين في القرن الأول.
وجب التنويه على أن السلسلة ستعرض رؤوس أقلام فقط، حيث لا يمكن تلخيص قرن ونصف من البحث العلمي في ثلاث مقالات. وفي السطور القادمة سنستكشف معًا ما يمكننا معرفته عن الثلاث بشارات الأولى الملقبة بالأناجيل الإزائية، وذلك من خلال دراستها داخليًا بأدوات النقد الأدبي والتاريخي [2].
يجد القارئ المتأني لنشأة الجماعات الدينية أن النصوص الدينية لا تنشأ بمعزل عن الجماعة، بل يتشكّل النصّ المقدّس وسط الجماعة، وتقوم الجماعة بتأويله وصياغته وإعادة تحريره في العديد من المواضع وبشكل متفاعل ومستمر.
نشأت المسيحية في أوّلها كجماعة يهودية، حيث دعا يسوع بين أتباعه إلى ملكوت الله. وفي ضوء تلك الكرازة وبتأثير ذلك الشّخص، أنتجت الجماعة نصوصًا متنوعة في النّوع الأدبي [genre] والفكر اللاهوتي على مدى خمسين عامًا.
لاحقًا، قامت الكنيسة، ممثلة في الأجيال اللاحقة من التلاميذ والرسل، بجمع وتثبيت معظم هذه الكتابات خلال صراعها مع المارسيونية في القرن الثاني.
التاريخ لا يعرف جماعة كان النص فيها أسبق على الفكر. وبما أن النص لم يكن موجودًا مسبقًا، لم تكن سلطة النص فوق سلطة الفكر والجماعة نفسها.
لكل نص عدد من التأويلات، وضامن الجماعة الوحيد لصلاحيَّة النص هو أن تضع الجماعة إطارًا هرمنيوطيقيًا [3] يحكم قراءته. لذا فالاختلاف ليس خلافًا حول النصّ فقط، بل أيضًا حول المنهج الذي يصلح لتفسير النص.
مثلًا، نجد العديد من الصراعات اللاهوتية قد نشبت حول نصوص متفق عليها، ويختلف الناس في تفسيرها، وأحيانًا قد يحتكمون لما يسمى “التقليد” [التراث] أو تلك المعلومات الأساسية التي يُعتقد في نسبها لإناس معاصرين أو مقتربين من زمن التلاميذ والرسل، بل وأحيانًا لأشخاص التلاميذ والرسل أنفسهم.
تتجاوز هذه القراءة البعد اللاهوتي إلى البعد الاجتماعي والتاريخي، ولا تقتصر على المسيحية بل تشمل الجماعات الأخرى. قد يُروج أنصار مفهوم “الجماعة الكتابية” لتلك الفكرة في الحديث عن العهد الجديد، لكن يظهر ضعف تلك الفكرة متى تم تطبيقها على الجماعة اليهودية. استغرق تدوين العهد القديم قرونًا عدّة، فهل يسبق النص الجماعة في هذه الحالة أيضًا؟ وإن افترضنا إمكانية وجود تلك “الجماعة الكتابية” التالية على النصّ، الجماعة التي تتلقى الإطار الهرمنيوطيقي من النصّ ولا تفرضه عليه، فما هي أمثلة تِلك الجماعات في التاريخ؟
في الواقع إنّ الثابت هو تعدد قراءات النص، وأن الأمثلة الثلاثة الأشهر [الأديان الإبراهيمية] قد أنتجت منهجيات هرمنيوطيقية لضبط النص. أما تلك الجماعات المعادية لهرمنيوطيقا الجماعة فعادة ما تظهر لاحقًا، كما هو حال مع البروتستانت وتيار القرآنيين وبعض الجماعات اليهودية التي رفضت سلطة القراءات التقليدية. ما سبق لا يعني بالضرورة صحة تفسير هرمنيوطيقا الجماعة للنص، لكنه يؤكد أنه لا جماعة تنتج نصًا وتتداوله بدون ضابط تفسيري يحكمه.
في القرن الواحد و العشرين، يعلم جميعنا مبدأ “حقوق الملكيّة الفكريّة”، ويتم ذلك من خلال سلطة قانونية متقدمة وتكنولوجيا متطورة تُمكّن تلك السلطة من تتبع وفهرسة جميع النصوص المنشورة. ولكن كيف حافظ المؤلِّفون في العصور القديمة على حقوقهم في ظل غياب هذه الحماية؟ كيف لكاتب أن يحفظ نسب نص لنفسه؟ وكيف له أن يضمن عدم وجود تعديلات على النص بعد انتشاره؟
في غياب مفهوم الملكية الفكرية وغياب سلطة عليا تحكم الأمور وغياب التكنولوجيا، كان اللجوء لسلطة الجموع هو الحل. لجأ الكتَّاب القدماء إلى سلطة الجماهير. فقد كان انتشار العمل بين الناس بمثابة دليل على ملكيتهم له، حيث كان تعديل النص بعد انتشاره يواجه معارضة من الجماهير الذين يعرفون النسخة الأصلية.
نحن نعلم من رسالة بليني الصغير إلى ماتيروس أريانوس، أن الكاتِب بعدما ينتهى من عمله يتلو النص أمام زملائه كي يستقبل تصحيحًا لأخطائه، وفي تلك الرسالة يبدو أن بليني الصغير يربط بين “النشر” (publication) وبين التلاوة الشفاهية أمام الجموع. وبوضوحٍ أكثر يقول [4] :
لست نادمًا على مُمارستي [تلاوة النّصوص قبل نشرها]، فقد علّمتني الخبرة أن لها فوائد عدة.
لا شيئ يُرضي رغبتي في الكمال، ولن أنسى أهميّة وضع كل شيئ في أيدي الجموع. أنا موقن أن كل عمل ينبغي أن يُراجع أكثر من مرة، وأن يُقرأ للعديد من الناس إن كان المطلوب أن تحظى بقبول كامل على نطاق واسع.(R. A. Derrenbacker, Ancient compositional practices and the synoptic problem)
لقد أدرك الكُتّاب القدامى أنّه بخروج النص من أيديهم، يصير النصّ أداة بين يديّ مُستقبليه، نقرأ مثلًا في المبادئ لأوريجينوس أنّه يستحلف من يقرأ كتابه ألا يضيف للمكتوب أو يحذف منه أو يغيره، ويعده بعذاب أبدي بعيدًا عن الميراث السماوي إن خالف الأمر. إذن فالكاتب يوثق علاقته بالنصّ بتلاوته، ولكن حين صار النص في أيدي الجموع يحدث ما يُعرف أدبيًا بـ“موت الكاتب”.
موت الكاتب
هو أن يخرج النص عن سلطان الكاتب بعد تداوله، في تلك المرحلة لا يمكن للكاتب أن يشرح ما أراد أن يقول، فتبدأ الجماعة في تفسير النص بموروثهم الفكري الذي قد يتضمن شيئًا من صوت الكاتب نفسه، ومن الوارد أيضًا أن يكون مغايرًا تمامًا. الموروث الفكري في تلك الحالة يتحول لا فقط إلى مُفسر بل إلى “ضابط”، ولا يخلق فقط التفسير، بل يُخمد ما يخالفه من قراءة.
وفي محاولة لربط الجماعة لقراءتها بقصد الكاتب نفسه، تُحيل كل جماعة قراءتها إلى صوت أقدم أقرب زمنيًا ومعرفيًا للكاتب. فنقرأ في كتابات إيرينيئوس، أسقف ليون، أنّه سمع وتعلم من بوليكاربوس، أسقف سميرنا، وتلميذ يوحنا بن زبدي، تلميذ المسيح. وعلى هذا فسلطة إيرينيئوس في نقد الغنوصيين تنبع من التلمذة، أي تسلسل شرح الإيمان [5].
ومن الجدير بالذكر أن المنطق نفسه هو منطق الغنوصيين، إذ يقول باسيليدس، اللاهوتي الغنوصي، أنّه تعلم على يد جلاوكياس، تلميذ بطرس [6]، وأيضًا فالانتينوس الغنوصي سمع من ثيوداس، تلميذ بولس، والنحشيين [7] تسلموا الاعتقاد [الإيمان] من مريم، التي تعلمت بدورها على يد يعقوب أخو الرب [8].
إن كانت النصوص في عهدة الجماعات، وإن كان الجميع يحيل قراءاته إلى التقليد والتراث الشفهي، فماذا يمكن أن تخبرنا النصوص نفسها عن تاريخ تكوينها بعيدًا عن الإطار التفسيري الذي تفرضه وتفترضه كل جماعة بسلطة التقليد؟
بما أن النصوص تُحتفظ بها وتُنقل شفهيًا بواسطة الجماعات، فإنها تخضع لتأثيرات ونفوذات مختلفة قد تشكل تاريخ تكوينها وتفسيرها. ومع ذلك، يمكن للنصوص نفسها أن توفر أدلة حول تكوينها بعيدًا عن التفسيرات الجماعية التقليدية:
* اللغة واللهجة: يمكن تحليل لغة النصوص ولهجتها لتحديد أصولها الجغرافية والزمنية. يمكن أن تكشف الاختلافات أو التشابهات في المفردات والنحو عن انتقال النصوص عبر مناطق مختلفة أو الفترات الزمنية.
* المحتوى التاريخي: إذا احتوت النصوص على أحداث أو شخصيات تاريخية، فيمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد تاريخ تكوينها التقريبي. على سبيل المثال، يمكن ربط الإشارات إلى الحكام أو الأحداث المعروفة إلى فترات زمنية محددة.
* التقاليد الشفوية: على الرغم من أن التقليد الشفهي قد يؤثر في تفسير النصوص، إلا أنه يمكن أيضًا توفير معلومات عن أصولها. يمكن مقارنة النصوص بالروايات الشفوية لمعرفة الاختلافات أو التشابهات، مما قد يشير إلى التغييرات أو التعديلات التي طرأت على النصوص بمرور الوقت.
* التحليل النصي: يمكن إجراء تحليل دقيق للنصوص للبحث عن أنماط أو اختلافات قد توفر أدلة على تاريخ تكوينها. على سبيل المثال، قد تكشف التغييرات في الأسلوب أو المنظور عن مراحل متعددة من التأليف.
* الفحص المقارن: يمكن مقارنة النصوص مع نصوص مماثلة من ثقافات أو فترات زمنية مختلفة. قد تكشف أوجه التشابه أو الاختلاف عن التأثيرات المتبادلة أو التطورات المستقلة، مما يساعد على تحديد تاريخ تكوين كل منها.
من خلال الجمع بين هذه الأساليب، يمكن للباحثين استخراج معلومات حول تاريخ تكوين النصوص بعيدًا عن التفسيرات المفروضة من قبل الجماعات التقليدية. ومع ذلك، من المهم الاعتراف بأن تاريخ تكوين النصوص غالبًا ما يكون معقدًا ومتعدد الأوجه، ولا يمكن إثباته بشكل قاطع دائمًا.
بحثًا عن تاريخ أكثر دقة، حاول الباحثون مقارنة وتحليل نصوص البشارات الثلاث الأولى، بهدف تحديد تاريخ تدوينها، والوقوف على أسباب وطبيعة التناص فيما بينها. فليس خفيًا على من يقرأ الثلاث بشارات الأولي أنها تتشابه نصيًا إلى حد بعيد، ليست فقط تتشابه بل بالأحرى تتطابق في الكثير من المواضع.
في المقالين التاليين، نشرح أسباب التشابه، ونقدم بعض الأدلة البسيطة التي تدعم الفرضية الأكثر شيوعًا في الأوساط الأكاديمية؛ نظرية المصدرين.