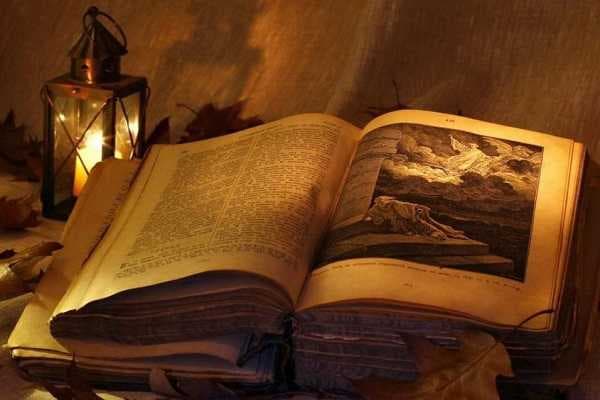- الفن القصصي في الأناجيل [١]
- الفن القصصي في الأناجيل [٢]
- ☑ الفن القصصي في الأناجيل [٣]
- الفن القصصي في الأناجيل [٤]
نواصل في هذا المقال حديثنا عن الأحوال الدينية والثقافية للمجتمع المسيحي المبكر، لنستشف ملامح البيئة التي تبلورت فيها كتابات العهد الجديد (وفي القلب منها الأناجيل الأربعة). ونحاول هنا أن نجيب عن السؤال الهام: كيف سارت علاقة الجماعة المسيحية المبكرة بجذورها اليهودية خلال القرن الأول؟
الواقع أن رسل المسيح -كما يخبرنا سفر أعمال الرسل- قد اعتمدوا بشكل أساسي على أسفار التناخ (العهد القديم) في كرازتهم بالمسيح التي توجهت بالأساس إلى بني جلدتهم من اليهود كما أسلفنا، إذ كان محور كرازتهم هو إثبات أن كافة أحداث حياة يسوع الناصري تجد لها صدى في كتب أنبياء التناخ، وأن موته بطريقة مهينة وبشعة مثل الصليب لم يكن شيئا مخزيا، بل كان خطوة لازمة لتمجيده وإعلانه لليهود ثم للعالم بوصفه “المسيا المنتظر”.
ونجد لزاما علينا هنا أن نتوقف قليلا أمام هذه المعضلة العويصة التي لا يمكننا تخيلها بمفاهيمنا الحالية، التي واجهها مسيحيو القرن الأول الميلادي في دفاعهم عن الطريقة المهينة التي مات بها يسوع الناصري (أو فضيحة الصليب Scandal of the Cross) كما اشتهرت في الأكاديميا الغربية، وذلك في مواجهة السخرية الشرسة من اليهود واليونانيين على السواء:
ففي نظر اليهود، كانت ميتة الصليب مرادفا للعنة والحرمان من رحمة الله لدرجة تعليق جسد المذنب بعيدا عن الأرض كيلا تتنجس بها، وذلك بموجب ما جاء في سفر التثنية بالتوراة:
وَإِذَا كَانَ عَلَى إِنْسَانٍ خَطِيَّةٌ حَقُّهَا الْمَوْتُ، فَقُتِلَ وَعَلَّقْتَهُ عَلَى خَشَبَةٍ، فَلاَ تَبِتْ جُثَّتُهُ عَلَى الْخَشَبَةِ، بَلْ تَدْفِنُهُ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ، لأَنَّ الْمُعَلَّقَ مَلْعُونٌ مِنَ اللهِ. فَلاَ تُنَجِّسْ أَرْضَكَ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَصِيبًا.
(سفر التثنية 21: 22-23)
أما بالنسبة للأمم من غير اليهود (وبخاصة بالنسبة للرومان)، فلم تكن عقوبة الصُّلْب مستخدمة سوى للعتيدين في الإجرام أو لمن ارتكبوا جرائم بشعة تمس أمن الإمبراطورية الرومانية كلها، التي تستلزم أن يتم عقابهم بطريقة استعراضية بشعة حتى يكونوا عبرة ورادعا لغيرهم، كقادة التمردات الشعبية أو السفاحين أو قطاع الطريق.
 ومن المثير أن هذه النظرة للصليب كأداة إعدام قد استمرت لدى الرومان حتى نهايات القرن الثاني الميلادي في الأقل:
ومن المثير أن هذه النظرة للصليب كأداة إعدام قد استمرت لدى الرومان حتى نهايات القرن الثاني الميلادي في الأقل:
فلدينا نقش جرافيتي graffiti (مخربشة) عثر عليها في منطقة تلال تدعى “بالاتين” في روما ويؤرخ لها علماء الآثار بحوالي عام 200م، يظهر فيها شخص معلق فوق صليب ويحمل رأس حمار، بينما يقف أمامه شخص آخر في وضع التعبد، وتحت النقش نجد عبارة باللغة اليونانية المنقحرة بحروف لاتينية تقول:
ΑΛΕ ΞΑΜΕΝΟϹ ϹΕΒΕΤΕ ΘΕΟΝ
“أليكسامينوس يتعبد لإلهه” !!
 ويغلب الظن بأن صاحب هذا النقش -الذي أقيمت فوقه ثُكْنَة عسكرية رومانية في عهد الإمبراطور “كاليجولا”- كان أحد الجنود الرومان الذين قصدوا السخرية ممن يدعى “أليكسامينوس” بالادعاء بأنه يعبد حمارا مصلوبا.
ويغلب الظن بأن صاحب هذا النقش -الذي أقيمت فوقه ثُكْنَة عسكرية رومانية في عهد الإمبراطور “كاليجولا”- كان أحد الجنود الرومان الذين قصدوا السخرية ممن يدعى “أليكسامينوس” بالادعاء بأنه يعبد حمارا مصلوبا.
والواقع أن تهمة (عبادة الحمير Onolatry) لم تكن جديدة على المسيحيين، فلقد شاعت من قبل على اليهود الذين اتهمهم فلاسفة الإسكندرية المناوئين لهم بأنهم يحتفظون برأس حمار ذهبي في قدس أقداس هيكلهم، وهي التهمة التي حرص المؤرخ اليهودي “يوسيفوس” على دحضها في كتابه الذي دونه ردا على الفيلسوف المصري الإسكندري “أبيون النحوي” في نهايات القرن الأول الميلادي، الذي حمل اسم (ضد أبيون)
(للمزيد حول الصراع الفكري ما بين فلاسفة الإسكندرية وما بين اليهود والتاريخ التوراتي، انتظر سلسلة لكاتب هذه السطور تحت عنوان: “لغز الخروج”)
من الطريف أن نفس التهمة قد لصقت بالمسيحيين الذين كانوا لفترة طويلة في نظر الرومان يمثلون إحدى الفرق اليهودية المارقة لا أكثر: ففي القرن الثالث الميلادي نجد أن الفيلسوف المسيحي الإسكندري العظيم “أوريجين/أوريجانوس” قد حرص على رد هذه التهمة وتفنيدها، وذلك في سياق كتابه الدفاعي الذي خصصه للرد على انتقادات الفيلسوف “كلسوس” ضد المسيحية بعنوان: Contra Celsum (ضد كلسوس)، الكتاب السابع.
أما القديس “ترتليان”، وهو من آباء كنيسة قرطاج المندثرة بشمال إفريقيا، فقد كتب في بدايات القرن الثالث عن شخص يهودي كان معاصرا مثل “اسكتش” ساخر موجه ضد المسيحيين، حيث أدى دور شخص مسيحي مرتديا أذني حمار وحوافره، ووضع فوق صدره لافتة تقول:
Deus Christianorum ὀνοκοίτης
(إله المسيحيين حمل بحمار) !!(ترتليان: الدفاعيات، الكتاب 16)
وهكذا كان على مبشري الجماعة المسيحية المبكرة أن يقنعوا كلا من اليهود والأمم بأن هذه الميتة المهينة كانت أداة تمجيد -وليست لعنة- ليسوع الناصري، وما أصعبها من مهمة!!
ويمكننا أن نشعر بمدى الجهد الذي عاناه بولس الرسول مثلا وهو يكافح لإثبات هذه العقيدة، ولنطالع مثلا ما قاله في رسالته الأولى إلى أهل مدينة كورنثوس:
لأَنَّ الْمَسِيحَ لَمْ يُرْسِلْنِي لأُعَمِّدَ بَلْ لأُبَشِّرَ، لاَ بِحِكْمَةِ كَلاَمٍ لِئَلاَّ يَتَعَطَّلَ صَلِيبُ الْمَسِيحِ. فَإِنَّ كَلِمَةَ الصَّلِيبِ عِنْدَ الْهَالِكِينَ جَهَالَةٌ، وَأَمَّا عِنْدَنَا نَحْنُ الْمُخَلَّصِينَ فَهِيَ قُوَّةُ اللهِ
(رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس 1: 17-18)
وهو ما عاد ليؤكد عليه في نفس الرسالة:
وَلكِنَّنَا نَحْنُ نَكْرِزُ بِالْمَسِيحِ مَصْلُوبًا: لِلْيَهُودِ عَثْرَةً، وَلِلْيُونَانِيِّينَ جَهَالَةً! وَأَمَّا لِلْمَدْعُوِّينَ: يَهُودًا وَيُونَانِيِّينَ، فَبِالْمَسِيحِ قُوَّةِ اللهِ وَحِكْمَةِ اللهِ.
(رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس 1: 23-24)
أما في رسالته إلى أهل مدينة غلاطية، فقد أعاد رسم مشهد الصليب -بعاره ولعنته- بنظرة لاهوتية جديدة تليق به كـ”فيلسوف المسيحية” كما يلقب:
اَلْمَسِيحُ افْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ النَّامُوسِ، إِذْ صَارَ لَعْنَةً لأَجْلِنَا، لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: «مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ عُلِّقَ عَلَى خَشَبَةٍ».
(رسالة بولس إلى غلاطية 3: 13)
وهكذا لم يصبح الصليب لعنة حلت بيسوع رغما عنه كما ظن اليهود، بل لعنة اختار يسوع أن يجوز فيها بملء إرادته ليفتدي البشرية من اللعنة التي كانت واقعة عليها بموجب شريعة الناموس الموسوي.
كيف كان موقف اليهود من الدعوة الجديدة؟
يمكننا القول بصورة عامة بأن موقف اليهود -لا سيّما السنهدرين والرئاسات الدينية- تجاه المسيحية قد اتسم بالشراسة والعداء لأسباب عدة، من بينها غَيْرَة اليهود التقليديين على شريعتهم من فكرة “المسيح المصلوب” التي رأوا فيها ما يحط من شأن ديانتهم ويمثل شركا بوحدانية “يهوه” الصارمة.
فضلا عن ذلك، فلم يكن القادة الدينيين لليهود في أورشليم بالذات بحاجة للمزيد من المتاعب من السلطة الرومانية الحاكمة التي كانت تسمح لهم -على مضض- بتطبيق شرائعهم الدينية وتأدية شعائرهم في الهيكل، ولم يكن من مصلحتهم أن يسمحوا بانتشار فرقة دينية جديدة خارجة عن سلطتهم الدينية وليس لهم سيطرة عليها.
لذلك فقد بدأت السلطات الدينية اليهودية مبكرا في محاولاتها لقمع هذه الحركة الوليدة، وكان على رأس المتحمسين لقمعها الفريسي المتشدد “شاول” الذي سيصبح لاحقا -في مفارقة دراماتيكية- فيلسوف المسيحية ورسولها الأشهر “بولس”:
وَحَدَثَ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ اضْطِهَادٌ عَظِيمٌ عَلَى الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي أُورُشَلِيمَ، فَتَشَتَّتَ الْجَمِيعُ فِي كُوَرِ الْيَهُودِيَّةِ وَالسَّامِرَةِ، مَا عَدَا الرُّسُلَ. وَحَمَلَ رِجَالٌ أَتْقِيَاءُ اسْتِفَانُوسَ وَعَمِلُوا عَلَيْهِ مَنَاحَةً عَظِيمَةً. وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ يَسْطُو عَلَى الْكَنِيسَةِ، وَهُوَ يَدْخُلُ الْبُيُوتَ وَيَجُرُّ رِجَالاً وَنِسَاءً وَيُسَلِّمُهُمْ إِلَى السِّجْنِ. فَالَّذِينَ تَشَتَّتُوا جَالُوا مُبَشِّرِينَ بِالْكَلِمَةِ.
(سفر أعمال الرسل 8: 1-4)
وهكذا تسبب اضطهاد العقيدة الجديدة في انتشار المؤمنين بها -كحبوب اللقاح- إلى خارج أورشليم وفلسطين كلها، لتبدأ بذور “المسيحية الأممية” في النمو.
وفي رسائل بولس الرسول المتلاحقة يمكننا أن نلمس مدى الصراع المرير الذي خاضه مع اليهود دفاعا عن عقيدة “المسيح المصلوب”، ويروي لنا سفر أعمال الرسل جانبا من المقاومة اليهودية الشرسة التي واجهها “بولس” ورفيق كرازته “برنابا” خلال رحلتهما الكرازية إلى مدينة “برجة بمفيلية”:
وَلكِنَّ الْيَهُودَ حَرَّكُوا النِّسَاءَ الْمُتَعَبِّدَاتِ الشَّرِيفَاتِ وَوُجُوهَ الْمَدِينَةِ، وَأَثَارُوا اضْطِهَادًا عَلَى بُولُسَ وَبَرْنَابَا، وَأَخْرَجُوهُمَا مِنْ تُخُومِهِمْ.
(سفر أعمال الرسل 13: 50)
وبرغم هذا فقد نجح “بولس” ورفيقه في اجتذاب الكثيرين من الأمميين للمسيحية:
فَلَمَّا سَمِعَ الأُمَمُ ذلِكَ كَانُوا يَفْرَحُونَ وَيُمَجِّدُونَ كَلِمَةَ الرَّبِّ. وَآمَنَ جَمِيعُ الَّذِينَ كَانُوا مُعَيَّنِينَ لِلْحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ. وَانْتَشَرَتْ كَلِمَةُ الرَّبِّ فِي كُلِّ الْكُورَةِ.
(سفر أعمال الرسل 13: 48-49)
وهكذا صدر الحكم النهائي من فم بولس على اليهود الذين رفضوا الخلاص المقدم إليهم أولا:
«كَانَ يَجِبُ أَنْ تُكَلَّمُوا أَنْتُمْ أَوَّلاً بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلكِنْ إِذْ دَفَعْتُمُوهَا عَنْكُمْ، وَحَكَمْتُمْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُسْتَحِقِّينَ لِلْحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ، هُوَذَا نَتَوَجَّهُ إِلَى الأُمَمِ. لأَنْ هكَذَا أَوْصَانَا الرَّبُّ: قَدْ أَقَمْتُكَ نُورًا لِلأُمَمِ، لِتَكُونَ أَنْتَ خَلاَصًا إِلَى أَقْصَى الأَرْضِ».
(سفر أعمال الرسل 13: 46-47)
وتأكيدا لهذا الحكم، فقد نفض “بولس” و”برنابا” غبار أرجلهما على يهود المدينة كعلامة على استحقاقهم للعقاب الإلهي نتيجة رفضهم للدعوة:
أَمَّا هُمَا فَنَفَضَا غُبَارَ أَرْجُلِهِمَا عَلَيْهِمْ، وَأَتَيَا إِلَى إِيقُونِيَةَ. وَأَمَّا التَّلاَمِيذُ فَكَانُوا يَمْتَلِئُونَ مِنَ الْفَرَحِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ.
(سفر أعمال الرسل 13: 51-52)
وفيما بعد سيحكي لنا التاريخ عن الأحداث الجسام التي وقعت لليهود خلال النصف الثاني من القرن الأول الميلادي، بدءًا باندلاع شرارة التمرد ضد الحكم الروماني التي بدأ دخانها في التصاعد منذ عام 66م، مرورا بحشد الجيوش الرومانية الجرارة لحصار “أورشليم” في نفس العام، وصولا لذروة الأحداث عندما اقتحم الجيش الروماني بقيادة “تيتوس فسبسيانوس” أورشليم عام 70م ليدمر الهيكل ويسويه بالأرض، وسط مذابح جماعية لسكان المدينة كان المؤرخ اليهودي “يوسيفوس” شاهدا عليها بحكم عمله مع الرومان.
ومنذ هذا التاريخ فصاعدا، بدأت الاتهامات المتبادلة ما بين اليهود والمسيحيين بالمسئولية عن الكارثة، حتى أعلنت القطيعة الكاملة ما بين العقيدتين عندما منع اليهود مواطنيهم المسيحيين من الصلاة في مجامعهم تماما وطردوهم في وقت ما حول العام 88م، ليتفرق طريق الديانتين منذئذ في موكب التاريخ.
وفي ظل هذه الظروف الملتبسة كانت بداية الأناجيل.