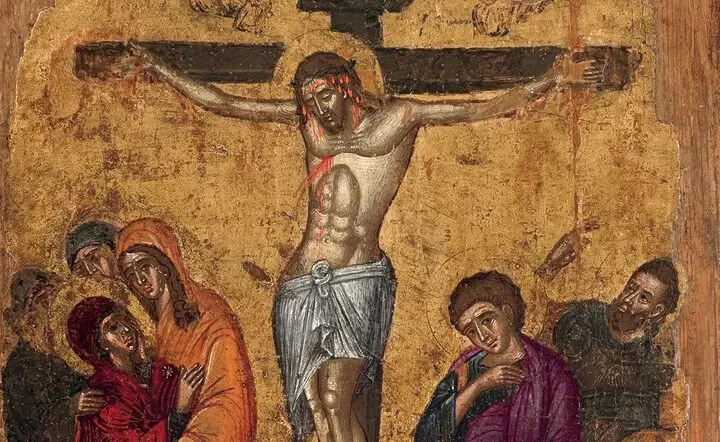على غير المُتوقع، لا يوجد ما يدل على أن المسيحيين الأوائل في القرن الأول الميلادي اعتادوا على الاحتفال السنوي بآلام المسيح وقيامته. بل كانوا يحتفلون أسبوعيًا، في يوم الأحد، بقيامة المسيح من خلال ممارسة سر الإفخارستيا.
بحلول منتصف القرن الثاني الميلادي، ظهرت طريقتان للاحتفال بقيامة المسيح، مرتبطتان بموعد عيد الفصح اليهودي كما نصت الأناجيل. الأولى هي الاحتفال به في الأحد التالي للفصح، وهو التقليد الذي انتشر في الإسكندرية وروما وأورشليم. والثانية هي الاحتفال به في نفس يوم الفصح اليهودي، أي يوم الرابع عشر من نيسان، وهو التقليد الذي كان يتبع في سوريا وآسيا الصغرى وبلاد ما بين النهرين [1]. وقد سُمي هذا الفريق بـ الأربعة عشريين
(Quadtrodecimans).
استند فريق الأربعة عشريين
في احتفالهم بالعيد في نفس يوم الفصح اليهودي إلى أن المسيح هو حمل الفصح، وأطلقوا على العيد باليونانية اسم pascha (Πάσχα)، كاشتقاق من الفعل اليوناني pascheien، بمعنى “يتألم”، وكترجمة حرفية للكلمة العبرية pesach (פסח). ويستند هذا بدوره إلى نصوص إنجيل يوحنا ورسائل بولس:
وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفًا هو واثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع ماشيًا، فقال: «هوذا حمل الله!»(إنجيل يوحنا ١: ٣٥-٣٦)
لكي تكونوا عجينًا جديدًا كما أنتم فطير. لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا.(رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس ٥: ٧)
بينما استند الفريق الأوّل في احتفاله يوم الأحد التالي للفصح اليهودي، وبالذات في الإسكندرية، إلى أن المقصود بالفصح ليس الآلام بل العبور. وقد ذكر العلامة أوريجانوس السكندري في عظته المعنونة: عن البصخة
(Peri Pascha):
معظم الإخوة يظنون أن الفصح يعني آلام المسيح، إلا أن هذا العيد لا يُدعى فصحًا بمعنى الآلام بين العبرانيين، بل بمعنى العبور. ففي هذا العيد خرج الشعب من أرض مصر.[2](أوريجانوس السكندري، عن البصخة)
كان كلا الفريقين يعتمدان في البداية على اليهود في تحديد موعد العيد سنويًا، انتظارًا لإعلانهم بداية شهر نيسان العبري. وكان الأمر سهلًا على مسيحيي فلسطين، كون تحديد بدء الشهور اليهودية، وبالتالي موعد الفصح اليهودي، يعتمد على رؤية القمر في أورشليم. ولكن كان الأمر يمثل تحديًا كبيرًا لمسيحيي البلاد الأخرى، نظرًا لأن مجتمعات يهود الشتات لم يكن يصلها خبر موعد العيد إلا متأخرًا، وبالتالي قد تحتفل بالفصح مبكرًا أو متأخرًا عن موعده.
ويزداد الأمر صعوبة في حالة السنوات الكبيسة، حيث يُتخذ القرار بإضافة الشهر الزائد في أورشليم، وقت لم يكن يتم اتباع الطريقة الميتونية في حساب التقويم مسبقًا بعد. وبالتالي، كان لا يصل الخبر إلى يهود الشتات إلا بعد فترة طويلة، مما يؤدي إلى الاحتفال بالعيد قبل الاعتدال الربيعي وقبل موعده في أورشليم بشهر كامل. وهو ما جعل المسيحيين في تلك المناطق في السنوات الكبيسة يحتفلون بالقيامة قبل موعدها بأكثر من شهر، مما يؤدي بهم إلى الاحتفال بالعيد مرتين في نفس العام [3].
ولتفادي تلك المشكلات، عمد فريق الأربعة عشريين
في آسيا الصغرى إلى اعتماد تاريخ ثابت للاحتفال بالعيد، يوافق يوم 14 من شهر أرتيميسيوس في تقويمهم [4]، والذي يوافق يوم 6 أبريل في التقويم اليولياني [5]. بينما حاول الآخرون اختراع طريقة حسابية لتحديد موعد عيد القيامة عن طريق حساب موعد أول قمر جديد بعد الاعتدال الربيعي، وهو ما أدى إلى ظهور أكثر من طريقة مختلفة في الدقة والأسلوب [6].
تاريخية طرق الحساب لعيد القيامة
أول ذكر لوجود طريقة حسابية لتحديد موعد العيد يعود إلى القرن الثالث الميلادي. فقد ذكر يوسابيوس القيصري في كتابه “تاريخ الكنيسة” أن ديونيسيوس، بابا الإسكندرية الرابع عشر [7]، أرسل رسائل فصحية يحدد فيها موعد عيد الفصح بناءً على دورة مكونة من ثمانية أعوام، وشدد في رسائله على عدم الاحتفال بالعيد قبل الاعتدال الربيعي.
إلا أن أصول هذه الطريقة تعود إلى عهد البابا ديمتريوس الكرام، بابا الإسكندرية الثاني عشر [8]، الذي ينسب إليه إنشاء الحساب الأبقطي. يذكر التراث القبطي والإثيوبي أن البابا ديمتريوس بدأ في استخدام هذه الطريقة في العام 214 م، وإن كان من الأرجح أن الدورة في البداية كانت مكونة من ثمانية أعوام [9].
كذلك، تم اكتشاف تمثال في إحدى الكنائس في روما، وعليه جدول لمواعيد قمر الفصح المكتمل وعيد الفصح، يبدأ من العام 222 ولمدة 16 عامًا، أي دورتين كل منهما 8 أعوام. بينما نُقش على الجانب الآخر للتمثال تواريخ العيد لمدة 112 عامًا. وينسب هذا الجدول إلى هيبوليتوس، الذي يُعتقد حاليًا أنه أسقف مدينة بورتوس، وهي ميناء قريب من روما. مما يدل على أن كنيسة روما كانت تستخدم طريقة مماثلة للحساب السكندري [10].
كما تم ذكر استخدام دورة مكونة من 19 عامًا، منسوبة إلى أنطوليوس السكندري اللاودكي [11]، الذي كان أسقفًا للاودكية في الفترة من 272 إلى 290 ميلادية. حيث نسب يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة هذا النص عن الفصح لأنطوليوس:
في السنة الأولى، يكون القمر الجديد للشهر الأول، الذي هو بداية كل دورة من تسعة عشر عامًا، في اليوم السادس والعشرين من شهر برمهات المصري. لكن، وفقًا للتقويم المقدوني، يكون في اليوم الثاني والعشرين من شهر ديستروس، أو كما يقول الرومان، في الحادي عشر قبل كاليندس أبريل [12] [أي أحد عشر يومًا قبل أول أبريل، وهو ما يكافئ ٢٢ مارس].[13](أنطوليوس السكندري، أسقف لاودكية، تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري)
أي أن أنطوليوس كان يستخدم لحساب الفصح طريقة مبنية على دورة مكونة من 19 عامًا، وفي أول أعوامها يكون القمر الجديد موافقًا ليوم 26 برمهات أو 22 مارس. وهي نفس الدورة السكندرية التي عرفت لاحقًا باسم الحساب الأبقطي، باختلافات طفيفة. ومن المرجح أن الجدول الفصحي الذي أعده أنطوليوس بناءً على هذه الطريقة كان يغطي الفترة من عام 258 إلى عام 352، أي 95 عامًا، وهو ما يساوي 5 دورات متكررة، كل منها 19 عامًا. ومما يدل على أن الطريقة نفسها كانت مستخدمة في الإسكندرية أن أنطوليوس أمضى الفترة الأولى من حياته هناك [14].
أما في الإسكندرية ذاتها، فلا يوجد الكثير من المصادر حول تاريخ الاحتفال بالفصح في فترة الاضطهاد، ولكن فيما بعدها، كان البابا أثناسيوس [15] يرسل رسائل فصحية يحدد فيها موعد العيد للعام القادم بناءً على الدورة الإسكندرية المكونة من 19 عامًا [16].
أما أقدم ذكر لجدول فصحي ممتد فهو جدول لمدة 100 عام، بدأ من العام 285 (أي العام الأول في تقويم الشهداء) وانتهى عام 385. وينسب هذا الجدول للبابا ثيوفيلس [17]، وإن كان لم يتم العثور على الجدول نفسه، إلا أنه توجد الكثير من الإشارات إليه في العديد من المصادر [18].
في روما، تم تطوير الدورة الثُمانية المنسوبة لهيبوليتوس إلى دورة أكثر دقة مكونة من 84 عامًا [19]. تشير العديد من المصادر إلى أن أول دورة من 84 عامًا بدأت في عام 298 وانتهت في عام 381. كانت الدورة تعتمد على تاريخ الاعتدال الربيعي في 21 مارس، مماثلًا للدورة الإسكندرية، وتقر بأن العيد يجب أن يكون بعده. إلا أنها لم تلتزم بأن يكون القمر الفصحي المكتمل بعد الاعتدال الربيعي، ولهذا كان يمكن أن يقع القمر المكتمل يوم 18 مارس، وهو ما أدى إلى خلاف في موعد العيد بين الإسكندرية وروما، رغم اتباعهم طرق حسابية متشابهة [20].
وعلى هذا، يمكن القول أنه حتى القرن الرابع الميلادي، كان المسيحيون في مناطق العالم القديم المختلفة يحتفلون بآلام المسيح وقيامته في مواعيد وطرق مختلفة.
مجمع نيقية وتوحيد عيد القيامة
نوقش الخلاف على تحديد موعد الفصح في مجمع نيقية عام 325، بهدف أن يحتفل جميع المسيحيين في موعد واحد. ونصت رسالة الإمبراطور قسطنطين إلى الأساقفة الذين لم يحضروا المجمع على ما يلي:
في هذا الاجتماع، بُحث موضوع عيد القيامة المجيد، وتقرر بإجماع الآراء احتفال الجميع بهذا العيد في كل مكان في يوم واحد. لأنه أيّ شيءٍ أليق وأكرم بنا من أن يحتفل الجميع بكيفية واحدة، وبنظام واحد، وترتيب معين، بهذا العيد، الذي نفرح به رجاءنا في الخلود؟ ولقد اتضح أوّل كل شيء أنه لا يليق أن نراعي في الاحتفال بهذا العيد المجيد عادة اليهود الذين لطخوا أيديهم بخطية شنيعة، فاستحقوا عمى بصيرتهم […] فلنسلك جميعًا، أيها الإخوة الأحباء، هذا الطريق برأي واحد، ولنتجنب الاشتراك في انحطاطهم. إنهم يفتخرون افتخارًا سخيفًا بأننا لسنا في سلطاننا مراعاة هذه الأمور دون تلقي التعليمات اللازمة منهم. وكيف يستطيع أن يعطي رأيًا سليمًا أولئك الذين، منذ ارتكابهم تلك الجريمة الشنيعة بقتل ربهم، قد أصبحوا خاضعين لا للعقل بل للعواطف الجامحة، ومندفعين بروح الجنون الذي فيهم؟ ولذلك انحرفوا عن جادة الحق في هذه النقطة وفي غيرها، حتى صاروا يحتفلون بعيد الفصح مرتين في السنة، لجهلهم طريقة التصرف الحقيقي في هذه المسألة. فلماذا نتبع أولئك الذين يتخبطون في ظلام الضلال؟ يقيناً أننا لن نرضى الاحتفال بهذا العيد مرتين في السنة[…]
إذن، فطالما كان الأمر يقتضي تصحيح هذا الوضع، لكي لا يكون هنالك شيء مشترك مع تلك الأمة القاتلة التي قتلت ربها. وطالما كان من اللائق اتباع الطريقة اللائقة التي تسلكها كل أرجاء العالم الغربية والجنوبية والشمالية، وبعض الأرجاء الشرقية أيضًا. لهذه الأسباب، يرى الجميع بإجماع الآراء في هذه المناسبة الراهنة أنها جديرة بالاتباع. وأنا شخصيًا، تعهدت أن يلقى هذا القرار موافقة فطنتكم، راجيًا من حكمتكم أن تقبلوا برأي واحد تلك العادة المرعيّة في مدينة روما وفي أفريقيا، في إيطاليا ومصر وإسبانيا وبلاد الغال وبريطانيا وليبيا وكل أرجاء اليونان، في أيبارشيات آسيا وبونطس وكيليكية.[21](قسطنطين الكبير، حياة قسطنطين ليوسابيوس القيصري)
كذلك، وجّه المجمع رسالةً إلى كنيسة الإسكندرية تضمنت فقرةً عن قرار توحيد موعد العيد:
ثم إننا نعلن لكم البشرى السارة عن الاتفاق المختص بالفصح المُقدس. فقد سُويت هذه المسألة على نحو صحيح، بحيث أن جميع الإخوة الذين كانوا في الشرق، والذين كانوا يحتفلون على غرار اليهود، صاروا من الآن فصاعدًا يعيدون الفصح، العيد الأجلّ، الأقدس، في الوقت نفسه الذي تعيد فيه كنيسة روما، وكما تعيدونه أنتم وجميع من كانوا يعيدونه هكذا منذ البداية.[22](أرشمندريت حنانيا إلياس كساب، مجموعة الشرع الكنسي)
إذن، ما تم الاتفاق عليه في نيقية هو:
أولًا: توحيد موعد الاحتفال بالعيد بين جميع المسيحيين على الموعد الذي تحتفل به غالبية الكنائس.
ثانيًا: عدم الاحتفال بالعيد مع اليهود، وعدم الاعتماد على تقويمهم في تحديده.
ثالثًا: عدم الاحتفال بالعيد مرتين في عام واحد.
ولكن كيف سيُنفَّذ ذلك، والعيد مرتبطٌ ارتباطًا مباشرًا بعيد الفصح اليهودي؟
لحل هذه المعضلة، كانت القاعدة المتبعة في الكنائس التي ذكرها قسطنطين في رسالته هي الاحتفال بعيد القيامة في: الأحد الأول بعد أول اكتمال للقمر في أعقاب الاعتدال الربيعي، والذي يوافق يوم 21 مارس وفقًا للتقويم اليولياني
.
وُضعت القاعدة بهذا الشكل؛ لأن اكتمال قمر شهر نيسان العبري (أي اليوم الرابع عشر منه) كان يقع -وقتئذ-بين يومي 21 مارس و19 أبريل.
وبناءً على ذلك، كانت القاعدة دقيقة في حساب قمر الفصح المكتمل في القرون الأولى من تطبيقها.
ماذا حدث بعد الاتفاق في مجمع نيقية؟
لم يلتزم أحد، ولم ينتهِ الخلاف كما هو مأمول بعد انفضاض مجمع نيقية والاتفاق على قاعدة حساب موحدة، حيث استمرت كل من كنيسة الإسكندرية وكنيسة روما في اتباع طريقتيهما المختلفتين في تحديد موعد العيد. وكان موعد العيد في روما مختلفًا عن الإسكندرية وبقية الشرق في أغلب السنوات التي تلت مجمع نيقية [23].
استمر الخلاف حتى طلب الإمبراطور من البابا القديس كيرلس عمود الدين، بابا الإسكندرية، إرسال رسالة إلى البابا لاون الأول (440-461)، بابا روما، لحل الخلاف. وبالفعل، أرسل البابا كيرلس رسالة إلى البابا لاون بها جدول لموعد العيد بين السنوات 437 و531، بعد تحويله من التقويم القبطي إلى التقويم اليولياني. وفند في رسالته أوجه خطأ الطريقة الرومانية في الحساب. استحسن البابا لاون الطريقة الإسكندرية، إلا أن البابا هيلاريوس (461-468) هو من تبناها وقرر البدء في استخدامها بأثر رجعي، بدءًا من سنة 456، وهي سنة نهاية الدور المكون من 84 عامًا في طريقة الحساب الرومانية.
ونفس هذا الجدول السكندري هو ما استخدمه الراهب ديونيسيوس إكسيجوس لتحديد العيد لكنيسة روما في السنوات اللاحقة، بدءًا من العام 532. إضافة إلى ذلك، قام ديونيسيوس بتحويل سنوات التقويم في جدول حساب عيد القيامة، ليصبح عام بداية التقويم هو عام بشارة مريم بميلاد المسيح، عوضًا عن تقويم الشهداء، كما سبق وأن شرحنا في سلسلة التقويم المصري القديم.
وهكذا، تبنت رسميًا كنيسة روما الطريقة السكندرية في حساب العيد، وتوحد المسيحيون في الاحتفال بموعد عيد القيامة، بدءًا من القرن السادس الميلادي، بعد حوالي مئتي عام من مقررات مجمع نيقية [24].
الدسقلية / الدسقولية / ديداسكاليا Didascalia
الدَسقَلية [25] أو الديداسكاليا Didascalia Apostolorum أي تعاليم الرسل
، هي كتاب يقدم نفسه على أنه تعاليم الرسل الاثني عشر في مجمعهم الأول في أورشليم بحضور بولس الرسول. وهناك مخطوطات كثيرة للكتاب بلغات مختلفة وباختلاف في الفصول والصياغات. من المرجح أن أصول هذا الكتاب تعود إلى القرن الثالث الميلادي، مع الكثير من الإضافات التي حدثت في عصور لاحقة [26].
تختلف أهمية هذه النصوص وحجيتها بين الكنائس المختلفة في الشرق والغرب؛ فهناك من لا يعترف بها مطلقًا، وهناك من يضعها في منزلة التراث، وهناك من يعتبرها من المصادر الأساسية للقوانين الكنسية. ورد في هذا الكتاب، ضمن ما ورد، قاعدة للاحتفال بعيد القيامة. ففي الفصل الثلاثين من النسخة العربية [27]، ورد النص التالي:
لأجل أنه يجب علينا نحن المسيحيين أن نجتهد ليوم الفصح، وأن لا نعمله في أسبوع غير الذي يتفق فيه مع الرابع عشر من القمر.[28]
يجب عليكم، يا إخوتي الذين اُشتروا بدم المسيح الكريم، أن تعملوا أيام الفصح بكل اجتهاد واهتمام عظيم، على أن يكون بعد طعام الفطير، الذي هو الخامس والعشرون من برمهات [بعد الاعتدال الربيعيفي المخطوطة اللاتينية، والذي يكون في زمان الاعتدال الربيعي، وهو الخامس والعشرون من برمهاتفي مخطوطة عربية أخرى]. لكي لا تصنعوا ذكر الألم مرتين في السنة، بل مرة واحدة في السنة تصنعون هذا، لأجل الذي مات عنا مرة واحدة.
واحترسوا أن لا تعيدوا مع اليهود، فإنكم الآن ليس لكم معهم مشاركة، لأنهم ضلوا وغلطوا بعدم الحق، وظنوا أنهم كاملون. لكنهم ضالون في كل أمر، ويفرقون الحق. وأنتم تحفظون مجتهدين من طعام الفطير الذي للربيع، الذي يُحفظ في الخامس والعشرين من برمهات. واحترسوا إلى الحادي والعشرين من القمر لكي لا يقع الرابع عشر من القمر في أسبوع آخر، فتكون ضلالة إذا وُجدتم تصنعون الفصح دفعتين في السنة بغير علم.
وهكذا أيضًا عيد القيامة المُقدسة التي لمخلصنا يسوع المسيح، لا تعملوه في يوم آخر بالجملة، بل في يوم الأحد فقط.[29](الدسقلية العربية، الفصل ٣٠)
إذن، تتفق الدسقلية مع ما أُقرَّ في مجمع نيقية من حيث أن الاحتفال بعيد الفصح/القيامة يجب أن يكون في الأحد الأول بعد أول اكتمال للقمر بعد الاعتدال الربيعي، الذي يوافق في التقويم القبطي للشهداء 25 برمهات (الذي كان يوافق يوم 21 مارس في التقويم اليولياني، وأصبح الآن يوافق 3 أبريل في التقويم الغريغوري المستخدم حاليًا).
الفصح والعصور الوسطى
رغم الاستقرار على القاعدة وطريقة الحساب، لم يسلم الأمر من بعض الخلافات، إذ تفرقت الكنائس إلى فرق مختلفة في الشرق. ففي كتاب تاريخ الإنطاكي ليحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي (975 – 1066)، يرد ذكر خلاف وقع بين مسيحيي مصر ومسيحيي الشام على موعد عيد الفصح:
في سنة سبع وتسعين وثلاثمائة، الموافقة لسنة ألف وثلاثمائة وثمانية عشرة للإسكندر [30]، كان بين سائر النصارى اختلاف في سائر الأقاليم في حساب الفصح. وذلك أنّ بعضهم رأى أن فصح النصارى في السنة المذكورة كان في ستة أيام خلت من نيسان [المقصود شهر[34]أبريلمن شهور الروم]، وهو الخامس عشر من [هلال] رجب، ورأى بعضهم أنّ الفصح فيها كان يوم الأحد الذي يليه، وهو الثالث عشر من نيسان، وهو الثامن والعشرون من [هلال] رجب […] حينئذٍ اتّفق جميع النصارى الذين بمصر من الملكية [31] والنّسطورية [32] واليعقوبيّة [33] على أنّ فصح اليهود يوم السبت في خمسة أيام نيسان، وهو الرابع عشر من رجب، وفصح النّصارى يوم الأحد غده. ورأى أهل بيت المقدس الرأي الثاني، واعتمدوا عليه، ووصلت كتبهم وكتب أهل الشام إلى مصر يتعارفون منهم ما اتّفقوا عليه. وكتب أرسانيوس بطريرك الإسكندرية إلى أهل بيت المقدس بما صحّ عنده فيما اتّفق عليه رأي أهل مصر، وأنّه الصواب الذي يجب أن يُعوّل عليه. فلمّا وصلت إليهم كتبه قبلوها.(يحيى بن سعيد الأنطاكي، تاريخ الأنطاكي)
إلا أن هذه الخلافات البسيطة، إن حدثت، فقد ظلت في حدود الأسبوع الواحد بين الطوائف المختلفة، نظرًا لاختلافات بسيطة في جداول الحساب الفصحي بينها. ولم يتسع الخلاف إلا في أعقاب الإصلاح الغريغوري في القرن السادس عشر.