حملة قادها الراهب واﻷب يحنس السرياني على الصورة المرفقة، بعد أن أضفى أحد المعاصرين ابتسامة وقورة على وجوه كل من يسوع وأمه مريم في إحدى اﻷيقونات الشهيرة.
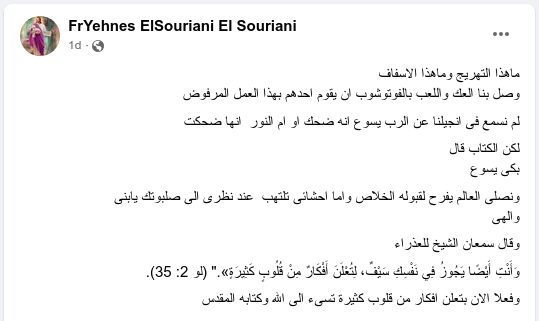 وصف اﻷب الراهب هذا العمل بالتهريج والعك، وإننا
وصف اﻷب الراهب هذا العمل بالتهريج والعك، وإننا لم نسمع في إنجيلنا عن الرب يسوع أنه ضحك أو أم النور أنها ضحكت، لكن الكتاب قال: بكى يسوع
.
ثم أكمل طارحا قناعاته بشكل قاطع أن هذا العمل يسيء إلى الله وكتابه المقدس
.
 في منشور تال، كانت أفكار السرياني أكثر وضوحا في رفضه، حيث قال:
في منشور تال، كانت أفكار السرياني أكثر وضوحا في رفضه، حيث قال: نقل ثقافة العالم وإسقاطها على الأيقونات هو عمل شيطاني، ومرفوض بشكل قطعي، بلاش فزلكة، وبلاش اللعب في المسلمات، وبلاش الخلط بين الفرح الروحي والضحك
.
وفي الحقيقة ربما يكون العكس هو الحادث! فاﻷب الراهب يضع خطًا فاصلًا وحادًا بين الفرح وبين الابتسام، فاﻷول لديه مقبول والثاني غير مقبول، مع أن الثاني هو أحد دلالات اﻷول! كيف يمكن للمرء أن يفرح دون ابتسامات؟ وما معنى الفرح دون أقل مظاهر الفرح؟ وماذا عن داود النبي الذي كان مفهوم الفرح لديه مرتبطًا بالرقص والعزف والهرولة بشكل ارتجالي دون قيود الملوك؟ من وضع هذه الفواصل الحادة التي قد تصل بنا لفرح حبيس الصدور ﻻ يغادرها وإﻻ عُدّ ممنوعًا؟ وﻻ نفهم لماذا يصر البعض على صناعة عداوة بين المقدس وسعادة اﻹنسان، وﻻ أرى لكل هذا أي تأصيل إيماني أو ﻻهوتي بل أعده “ثقافة موت” حاربها المسيح بثقافة الحياة، وعلى خطواته ينبغي أن نسير.
الإنسانيّة امرأة يلذّ لها البكاء والنحيب على أبطال الأجيال. ولو كانت الإنسانيّة رجلاً لفَرِحت بمجدهم وعظمتهم… الإنسانيّة طفلة تقف اليوم متأوّهة بجانب الطائر الذبيح، ولكنّها تخشى الوقوف أمام العاصفة الهائلة التي تصهر بمسيرها الأغصان اليابسة وتجرف بعزمها الأقذار المنتنة… الإنسانيّة ترى يسوع الناصري مولوداً كالفقراء، عائشاً كالمساكين، مهاناً كالضعفاء، مصلوباً كالمجرمين، فتبكيه وترثيه وتندبه… وهذا كلّ ما تفعله لتكريمه.(جبران خليل جبران: “يسوع المصلوب”، صفحة من كتاب: “العواصف”)
لنصطلح أولا:
الفن ليس مقدسًا، هو إبداع بشري حر وقائم على الخيال المحض، يتبارى فيه الفنانون في “أيقنة” (بمعنى وضع عدسة مكبرة، أو إطار) على “لقطة ثابتة” مرسومة أو منحوتة، وذلك وفق أدوات ومدارس فنّية ذات سمات وخصائص متباينة تختلف بالعصور والمنطقة الجغرافية. كل صورة تحمل رأيًا -شخصيًا وإنسانيًا- مذيّلًا بتوقيع الفنان وتُعدّ جزءًا من حرية اﻹبداع اﻹنساني. حريتنا نحن، البشر، في الاعتقاد، والتصوّر لما هو معنوي غير مرئي، وتوثيق لكل ما نتصوره بشكل بصري كي يستطيع اﻵخرون رؤية ما نتخيله أيضًا.
بطريقة أخرى، أعمالي الفنية -بالنسبة لي- هي: شهادة على ما تخيّلت منفردًا.
الفن ﻻ تحكمه قواعد ثابتة، وﻻ توجد ضمانات مقدمة من الله أو رجاله بعصمة الفن. ربما تكون تعقيدات الفنان أكبر من أن تفهمها أجيال بِرُمَّتها. على سبيل المثال، وفي اللوحة نفسها، الطفل يسوع لم يرتد التاج الذهبي الملوكي يومًا، وهو القائل راشدًا: مملكتي ليست من هذا العالم، بينما الفنان غير مقيّد بنص ديني، ويرسم قناعاته الذاتية في المسيح كملك منتصر، حتى وإن أخبرتنا اﻷناجيل أن إكليل يسوع الوحيد كان من أشواك.
الفن أكبر من الحدود، وجسرٌ مسكوني أممي إلى لغة غير منطوقة. فمثلاً، وفي نفس اللوحة، القديسون ﻻ يمشون بدوائر صفراء حول رؤوسهم، بل هي رمز (وثني اﻷصل، مأخوذ من الشمس، وباﻷدق تعبير بشري فني تم التوافق الجمعي عليه قبل اﻷديان التوحيدية) لهالة الروح، كنوع من التجسيد الفني لمسألة معنوية مثل القداسة. وهكذا في باقي فنون اﻷيقونات بمختلف مدارسها. اﻷمر أشبه بلغة حوار ﻻ يفهم ديناميكياتها إﻻ المتخصصون، لكن يمكن للكل لمس تأثيرها واﻹحساس بجمالها وروعتها حتى وإن لم يدرس هذه اللغة (أعني لم يتخصص أو يمارس الفن، خصوصاً أن اﻷمر أساسه موهبة من السماء)، فإن لم تملك حسّاً فنيًا أصيلًا، فلا جدوى مأمولة من دراسة مفرداتها ولغتها.
الأيقونة الطقسية ونسخها المقلّدة:
من بين لغة اﻷيقونات الفنية المتعددة، هناك جزء يُسمى “اﻷيقونات الطقسية”، ومعناها التاريخي يعود للمؤسسة الدينية (التقليدية بالطبع، لأن غير التقليدية ترى في “فن اﻷيقونة” شرًا لا خيرًا، كما هو الحال في الإسلام أيضًا). وأقصد بالمؤسسة هنا أن طبقة اﻹكليروس/ الكهنوت، قد انتخبت جزءًا من هذه الفنون البشرية، ورأت أنها وافقت معايرًا أخرى للدقة العلمية بجوار كونها “إبداعًا فنّيا”، فدشنتها… أي عمّدتها… ولهذا طقوس مقدسة تصير من بعدها اﻷيقونة حاملة لبركة الكنيسة على العمل اﻹنساني، وتُعامل معاملة خاصة من المؤمنين (المسيحيين) بعد أن صارت ممسوحة بزيت الميرون المقدس، والمتوارث لمئات السنين من ذخائر ﻻمست جسد المسيح واستُخدمت في تطييبه. هي هنا، بالتدشين، قد صارت مقدّسة.
ﻻ تنعكس القداسة على نُسخ الأيقونات المقلّدة المُباعة في المكتبات، وﻻ بالطبع على نسخها الرقمية التي يضعها البعض بديلًا لصورة المِلفّ الشخصي. المسيحيون هنا أحرار في تعليق صور “دينية” في منازلهم وبيوتهم وممتلكاتهم من باب التزيّن، أو إعلان الهُوِيَّة، أو حتى إعلاء الهُوِيَّة الدينية فوق الهُوِيَّة الشخصية كما تفعل النساء المنغلقات اجتماعيًا على منصات مصممة للتواصل الاجتماعي… لكن ليس هذا أبدًا من باب القداسة، ﻻ في اﻷيقونة وﻻ في رافعها… تمامًا كما أن وضعك صورة لنسر بري ﻻ يعني أنك تستطيع الطيران، بل هو إفصاحٌ عن شخص يفتقد الحرية التي تتجلى في نسور البراري.
أتصور أنّ نُسخة اﻷيقونة المُقلّدة، والمُعلقة في المنازل، أشبه بأن يُعلق أحدهم صورة لأبيه الراحل، أو يضع تمثالًا لأحد اﻷسلاف من باب الذكرى. فاﻷيقونة هنا مناطها الاستحضار للذكريات وليس القداسة. أي أنّ الاعتداء هنا -جدلًا، وإن حدث وسمينا هذه اللغة الفنية اعتداءًا كما يفعل المتطرفون- هو اعتداء على الملكيّة اﻷدبيّة والفكريّة للفنان راسم الصورة، واعتداء على ممتلكات مالك اللوحة الفنية. اعتداء على ممتلكات خاصة أو رؤية خاصة، لكنه ليس اعتداءً على مُقدسات جماعية، تمامًا كما أن تمزيق صورة أبيك أو جدك أو تنينك المُجنّح أو منظر طبيعي للنيل أو إحدى الفلاحات اللاتي “يملأن القلل” المعلقة في صالون منزلك، هو بالتأكيد ليس اعتداءً على اﻹنسانية!
بعد التوكيد على كل النِّقَاط السابقة، فاﻷمر واضح في كون اﻷيقونات “ثقافة عالم” استخدمتها الكنيسة، وليس العكس. الكنيسة هي التي تذهب إلى ثقافات البشر وثقافة العالم “وتُعمّدها”، وليس العكس! خاصةً أن مُعظم اﻷيقونات التاريخية لها مسار تاريخي أوروبي يعود لعصر النهضة، ويحمل بصمات فنانين معروفين بإبداعاتهم وخيالهم المتحرر، في مقابل جمود وانغلاق المؤسسة الكهنوتية. فلوحة العشاء اﻷخير مثلًا، رسمها ليوناردو دافنشي، وسقف كنيسة السيستين الذي يمثل بداية الخلق وسقوط آدم من الجنة، هو لمايكل أنجلو. أفخر أيقونات العذراء ويسوع هي لرافاييل سانزيو. هذا الثلاثي، ورابعهم دوناتيللو، ليسوا مجرد مسميات لسلاحف النينچا، بل هم رباعي الفنانين الخالد اﻷشهر واﻷشرس لكنيسة روما، ونقطة التحول الفارقة من العصور الوسطى إلى عصر النهضة.
ﻻ يوجد بين الفنانين النهضويين اﻷربعة وكنيسة العصر الوسيط إﻻ كل اختلاف، كما يختلف اﻹبداع ذاته عن الثقافة الجمودية، فقد أصر دوناتيللو على أن ينحت تمثال داود بأعضائه التناسلية ومؤخرته عارية، وأصر ليوناردو على رسم الذات اﻹلهية في جدارية “خلق آدم” على سقف كنيسة السيستين. لكن في هذا العصر، النهضوي بامتياز، كانت الكلمة العليا للتخصص الفني وليس للكهنة أو الرهبان أو جماعة دينية منغلقة، بعد أن قال الوباء اﻷسود كلمته وراح ضحيته ثُلث سكان أوروبا!

لنختلف ثانيًا:
منذ تسعة عشر جيلاً والبشر يعبدون الضعف بشخص يسوع… ويسوع كان قويّاً ولكنّهم لا يفهمون معنى القوّة الحقيقيّة… ما عاش يسوع مسكيناً خائفاً، ولم يمت شاكياً متوجّعاً، بل عاش ثائراً، وصُلِبَ متمرّداً، ومات جبّاراً.(جبران خليل جبران: “يسوع المصلوب”، صفحة من كتاب: “العواصف”)
عندما يقول الكتاب المقدس بكى يسوع
فهو تعبير عن اﻷلم في موقف عصيب ومحدد، وليس تعبيرًا عن حالة من التعاسة الدائمة وعبوس الوجه أو الكآبة التي يجب أن تقترن بالمسيح طيلة حياته (وربما يطلبون العبوس والكآبة في كل من تبعه أيضًا، وإﻻ اتهموهم بعدم الإيمان!)
خطورة هذا الطرح من اﻷب يحنس ليست فقط في الطرح ذاته، بل في شخص صاحبه. هو ببساطة راهب وكاهن رهبان يتحدث في شؤون عالم يتخاصم معه ومع لُغته، وقد يختلط اﻷمر على العامة فيظنون رأيه رأي الكنيسة والمؤسسة والدين ورأي المسيح شخصيًا. وكل هذا محض افتراء يجب أن يُردع بحسم في مجال الرأي الشخصي. يفضّل العلمانيون منع اﻹكليروس تمامًا عن التعقيب بآرائهم الشخصية حتى ﻻ يسيء العوام فهم “صراعاتهم” ونزعاتهم المعادية للفن (الذي ﻻ يفقهونه، ومع ذلك يستخدمونه في جمع النقود!)، بينما يتفضّل الليبراليون باﻹصغاء للطرح بشكل ذاتي، بغض النظر عن شخص صاحبه، قبل الاشتباك والتفاعل بالتأييد أو النقدـ وأيضًا بغض النظر عن شخص صاحبه لإيمانهم بأﻻ مقدّس فوق النقد. وهو ما سأجتهد فيه في السطور المتبقية.
لم يهبط يسوع من دائرة النور الأعلى ليهدم المنازل ويبني من حجارتها الأديرة والصوامع، ويستهوي الرجال الأشداء ليقودهم قسوساً ورهباناً… بل جاء ليبث في فضاء هذا العالم روحاً، جديدة، قويّة، تقوّض قوائم العروش المرفوعة على الجماجم، وتهدم القصور المتعالية فوق القبور، وتسحق الأصنام المنصوبة على أجساد الضعفاء المساكين… لم يجئ يسوع ليعلّم الناس بناء الكنائس الشاهقة، والمعابد الضخمة، في جوار الأكواخ الحقيرة، والمنازل الباردة المظلمة… بل جاء ليجعلَ قلبَ الإنسانِ هيكلاً، ونفسَه مذبحاً، وعقلَه كاهناً.(جبران خليل جبران: “يسوع المصلوب”، صفحة من كتاب: “العواصف”)
تجزئة المسيح مخلّة به
التركيز على “المسيح الباكي” هو عقائديا تركيز على “الموت” دون “القيامة”، أما ﻻهوتيا فهو تركيز قصير النظر يخلو من الإسخاتولوچي [علم الآخرة، وهو أحد علوم اللاهوت المسيحي] وكأنما قيمة المسيح لديك انحصرت في يوم الجمعة دون سبت، دون أحد، دون استقراء لما بعد الموت… تركيز انتقائي على ساعات و أيام، مع إهمال لثلاثة وثلاثين عاما من “حياة يسوع” اﻷرضية، بل وألفي عام بعدها من حياة يسوع وحركته الفنية في خيال البشر من عشاقه بمختلف الشعوب والعصور.
يسوع يتحرك في فن اﻷيقونات… هو حيّ فيها… هذه حقيقة وليست جملة أدبية شعرية! فهو أشقر ذو عيون زرقاء عند الرسام اﻷوربي، وأسمر ذو عيون سوداء عند اﻷقباط، مجعّد الشعر عند الأفارقة، ومسحوب العينين عند الفلبينيين، باسم الثغر عند الباسمين، وعابس الوجه عند العابسين والنكديين… من ذا المجنون الذي يريد حبس تصورات العالم في تصوّره الشخصي؟
فإن كان بولس الرسول يقول كل الكتاب صالح للتعليم، فنحن من بعده نقول: كل المسيح بكل حالاته صالحة للتعليم أيضا! ومن السخف حقيقة فرض “المسيح الباكي” المجزأ المخل، على المسيح الذي ظل طيلة حياته يجول بين الناس مبتسمًا للجميع يمسح دموع الحزانى وصانعا للحالمين أملا بحياة أفضل.
للكنيسة كل الحق في انتخاب “المسيح المحايد الوجه” في أيقوناتها الطقسية. هذا بخلاف كونه حقها فهو حكمة مفهومة للجميع تسمح بتأويل “حياد الوجه” إلى مختلف الحالات المتعددة في خيال المؤمنين… لكن وبالتوازي، للفنان المسيحي الحق -والحرية أيضا – في التعبير عن مسيحه كما يراه، بعيدًا عن أي طقس مرتب ومهندم، دون أن يجبر على التوافق مع القناعات الاجتماعية لغيره… بل ومن حقه أيضا -إن أتقن لغة الفن- التحاور مع الفنان الأقدم بلسان الفن وإضافة التراكمات التعديلية على من سبقه… مثل إضافة ابتسامة الفرح على وجه صانع الفرح، ونقطة ارتكازنا فيما أسماه أبائنا الرسل وكتبة اﻷناجيل: “البشارة المفرحة”.
بالنهاية، أقول لهذه الفنان الفيسبوكي المجهول، واضع البسمة على وجه رموز الفرح المسيحي: ﻻ تبتئس وﻻ تحزن لجهلهم وﻻ عددهم، بل اغفر لهم لأنهم ﻻ يعلمون ماذا يفعلون. قم واحمل إضافتك التراكمية ودافع بكل قوة عن حقك ورؤيتك ولغتك المتفردة التي ﻻ يشوبها عوار اﻹساءة… هي لغة مفهومة لي، ولغيري من حماة الحياة ومحبي الجمال، ولقد أرسلت إليك لتحيتك عليها وعلى روعتها…
فسامح هؤلاء الضعفاء الذين ينوحون عليك لأنّهم لا يدرون كيف ينوحون على نفوسِهم،
واغفر لهم لأنّهم لا يعلمون بأنّك صرعت الموتَ بالموتِ ووهبتَ الحياةَ لمن في القبور.(جبران خليل جبران: “يسوع المصلوب”، صفحة من كتاب: “العواصف”)
واﻵن، يا أيتها النسخ الرهبانية الكريمة… أما آن الوقت لنصير أفرادًا؟
مورنينج من ده يا وﻻد الكئيبة!



