جريمة بشعة حدثت في منطقة اللبيني، بشارع الملك فيصل بالجيزة: شخص قتل ٣ أطفال وأمهم بإجبارهم على تناول سم كيميائي، منهم طفل رفض، فألقى به في مصرف اللبيني. التفاصيل يمكن معرفتها من الصحافة، وأفضل تغطية للحادث برأيي قدمها موقع مصراوي [1]، وأنصح بها من يريد الاطّلاع على تفاصيل الجريمة، لأن هذا المقال ليس عن الحادث وإنما عن جرائم التوجيه والقيادة النفسية للقارئ والتي قامت بها البوابة الإلكترونية لحزب الوفد في أثناء تغطيتها للحادث [2].
أصدقاء أعزاء انتقدوا غياب المهنية في المانشيت [عنوان الخبر] [3]، وتناول آخرون بشكل موسع شيطنة المرأة عبر استخدام تعبيرات معينة تلوم الضحايا [4]. لذلك، لن أكرر انتقاد “القيادة الاجتماعية” في الخبر، بل سنتوسع في لفت النظر أن هذه “صحافة حزبية”، وبالتالي من الأصوب أن نتعلم منها وفيها القراءة السياسية، حتى لو كنّا نقرأ عن حادثة غير مُسيسة… الأهم عندي إعطاء نموذج لاستقراء الأيديولوجيا عبر الإطار وطريقة العرض للمانشيت وحده.
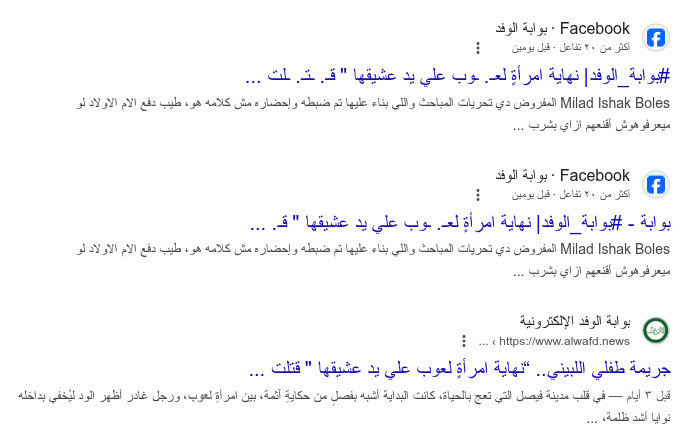
القراءة السياسية للخبر
الحيلة القادمة تعلمتها من المرحوم د. جهاد عودة، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة حلوان. وتعلمتها منه على المقهى بالمشاهدة والمعايشة لسلوكه اليومي الذي لم يتغير لسنوات. كان -رحمه الله- دائم الشراء للطبعة الأولى من كل الجرائد القومية، يفتحها ويمر بعينيه لا يقرأ خبرًا واحدًا، ثم يتركها. فقد أخذ من الجريدة مراده بالفعل! والحيلة باختصار: لما يكون قدامك جرنال رسمي، قومي، حزبي، حكومي.. أقرأ المانشيات فقط وإرمي الجرنال.. إرميه، لأن مالوش لازمة غير في المانشيتات وبس.
متن الخبر وجودته هي مسؤولية الصحفي أو المحرر على أقصى تقدير. أما المانشيت فليس من الصحفي أو مُحرر الخبر، بل هو من الـديسك
[5]. يتعامل الصحفيون مع هذه الحقيقة كقاعدة مفهوم حكمتها، حيث أن الديسك يضم طبقة أرفع ثقافة وأكثر تخصصًا ومهنية يفرزون عناوين الأخبار في الصحيفة بالكامل لاختيار مفردات تحقق سياسات أفضل للصحيفة ككل. وكل هذا صحيح بالطبع، لكن بالنسبة لرئيس قسم العلوم السياسية فهذا المكتب هو مكتب سياسي يستطيع منه قراءة التوجهات والتعليمات السياسية المعطاة لصحيفة محددة وتظهر في طريقة العرض لا الأخبار ذاتها. وبطريقة أخرى؛ هو لا يبحث عن الأخبار في الصحيفة، بل يستقرئ سياسة صانع القرار من الصحيفة.
للتبسيط، يمكن اعتبار قراءتك لمتن الخبر دافعها الفضول المعرفي للحقيقة.
أما كتابة المانشيت فهي تعكس توجهات المؤسسة الصحفية، وما الذي تريده، أو أين تريد أن تذهب بك!
والأمرين ليسا واحدًا كما تتصور.
المرحوم د. فرج فودة كان له جملة ذهبية: ميهمنيش عايزني أركب إيه، المهم عايز توديني على فين
. (وكان يقصد سياسة الدولة وإلى أين تقودنا)
في القراءة السياسية، ولأنك غير معني بالحقيقة بل معني بـ عايز تاخدني على فين؟
، لا يقرأ السياسيون الخبر كيلا ينهمكوا في البحث عن الحقيقة. لا توجد حقيقة يمكن إيجادها في الخبر، وإنما هي سياسة الصناعة للخبر.. إذن، نقرأ المانشيت فقط.
بالطبع التفاصيل أكثر تعقيدًا في عالم د. جهاد عودة السياسي، فالطبعة الأولى هي الأهم، لأنها تصدر ليلًا على عجلة، وما ينطبق على “الطبعة الأولى”، النسخة الأولى من مانشيت الوفد قبل تعديله (المانشيت تم تعديله بعد إستياء القراء، راجع الهوامش للتفاصيل)، ولكي تستطيع قراءة “سياسة دولة” في التعامل مع “حدث” معين، فيكفي استعراض الجرائد الرسمية القليلة وقراءة المتشابه في طريقة التعامل مع هذا الحدث المعين. لكن حتى الاختلافات البسيطة جدًا بين العناوين لنفس الحدث، هي مدخل أكثر تعقيدًا يمكن أن ينبأك بفوارق الأجهزة المعلوماتية المختلفة التي تتحكم في طريقة العرض لكل صحيفة. الأمر يحتاج هنا لمعلومات أعمق عن نشأة وتكوّن وتمويل الجريدة (القومية الرسمية!).
والأمر يزداد حرفيّة بمعرفتك أن ذاك المًحرر يتلقى تعليماته من ذلك الجهاز المًعين، أو من له سلطة التعيين في الصحافة عند الجهاز الأمني، والتعقيدات تزيد إن أردت أن تكون يقظًا لأنه في المعتاد فكل هذا في حالة سيولة وتنقلات، ومن ثمّ، فكل ما تعرفه قد يتغير في العام التالي. في الحقيقة ليس سهلًا أن تكون صديقًا لرئيس قسم العلوم السياسية أو أن ترى بعينية. فالمهنيّة والممارسة اليومية لسنوات هي من نحتت عقله بهذه الكيفية. لكن يكفيني أن تأخذ فكرة عامة وسأكون قانعًا بذلك. أما لو أردت دراسة إبستمولوجية [معرفية] أعمق، ولماذا لا توجد حقيقة في الخبر، فأنصحك بقراءة سلسلة: التأريخ في ضوء ما بعد الحداثة [6].
قراءة اجتماعية لحزب سياسي
هناك مشكلة ضخمة لو صدّقنا ادعاءات أي حزب عن نفسه بمعزل عن نشاطه الواقعي. والقصة هنا في العالم السياسي ليست معنية بالقيم البسيطة الخاصة بالأفراد، مثل المصداقية
أو مدى ازدواجية المعايير
، أو الاتساق مع الذات
، لأننا نتحدث عن تجمّع أفراد ذوي ذوات متعددة في مؤسسة، لذلك، فالأمور هنا تُقاس بأدوات علم الاجتماع، لا علم النفس كالأفراد، خصوصًا لو كنا نتحدث عن “حزب سياسي”.
قدرات الحزب السياسي ببساطة هي مدى قدرته على اتخاذ مواقف متباينة (أو متناقضة)، لأن ذلك يكسب الكيان الاعتباري للحزب بأكمله “مرونة” تمكنه من التماهي مع عدد أكبر من المتغيرات وتلبية احتياجات أوسع لفئات متعددة. وبالتالي، يعيش الحزب أو الأيديولوجيا فترة أطول طالما يراها الناس نافعة في تحقيق مصالحهم (حتى ولو وهمًا).
وعلى هذا، فالسياسي المحترف لا يفصح عن أيديولوجيته لكي يتمكن من التنقل بين الأيديولوجيات المختلفة وتغيير الحزب، وحتى تغيير فئة الناس التي يخدم مصالحها لو وجد فئة ناس أكثر (أقوى) منها، وبالتالي معهم ضمانات أكبر لدعمه في الانتخابات أو مقعد السلطة بشكل عام.
ربما ترى انتهازية
في ذلك، وسأجيبك: أنتَ على صواب. لكن الانتهازية مشروعة في العالم السياسي طالما أنت قادر على تبرير موقفك الجديد. وتقنيًا، أنت لن تبرر تحوّلاتك للجميع، أنت ستبرر للكتلة الجديدة الأقوى، القادرة على فرض رؤيتها على الكتلة الأقدم التي تهالكت وأصبحت أضعف. فالميديا هنا هي: أداة لتشكيل الوعي، وليست آلية للحقيقة كما قلنا سابقًا.
أيضًا، لاحظ أن المجتمع ليس كله سياسيين، المجتمع به فئات أخرى مثل المفكرين والمثقفين. فدور المفكرين لا يقل أهمية عن دور السياسيين، ولكنهم يؤدون عملهم بطريقة معاكسة، إذ يعلنون عن أيديولوجياتهم بشفافية، ودورهم هو مهاجمة السياسيين ونقد تناقضاتهم وإلزامهم بمسؤولياتهم. وعلى الرغم من العداء الظاهر بين الفئتين، فإن علاقة السياسي بالمفكر هي كعلاقتك بمرحاض بيتك، السياسي لا يطيق المُفكر ولا يستطيع أن يستغني عنه في الوقت نفسه. فبدون المفكرين، ليس هناك سقف للأحلام يبدأ السياسي بالتفاوض على الممكن منه، وبيعه لأتباعه.
حزب الوفد [الليبرالي؟]
قولًا واحدًا، حزب الوفد ليس ليبراليًا، وإنما تأطيره السليم هو نمط “ديني متسامح”. هذا يبدو واضحًا حتى من شعاراته الدينية كالهلال والصليب. فالحزب ذو منشأ ديني، ولم يعرّف الوفد نفسه يومًا بأنه ليبرالي، فمصطلح الليبرالية جديد على السياسة المصرية. وعندما نرجع لسنة ١٩٨٤، سنجد أن فؤاد سراج الدين شخصيًا نزل الانتخابات بصورة وهو يحمل سبحة
، وله تصريحات رسمية في حملته الانتخابية يؤكد فيها على التزام الحزب بالاشتراكية وبمبادئ الشريعة الإسلامية وبأهمية إعادة مصر للمحيط العربي والإسلامي وبرفض كامب ديڤيد. ومنذ ذلك الحين، حجز الوفد لمرشحيه رمز النخلة. وشعار خوض الانتخابات هو: أصلها ثابت وفرعها في السماء
.
مرجعيتنا في القادم هو علم الاجتماع، وسأستند لورقة بحثية للأستاذ د. محمد الحلواني، كتبها بغرض مناقشتها في المؤتمر الوطني الأول لـمصريون ضد التمييز الديني
، والذي عُقد في حزب التجمع بعدما منع الإسلاميين إقامته في مكانه الطبيعي بنقابة الصحفيين عام ٢٠٠٨، وكان مُقررًا أن أقدم وأناقش هذه الورقة بالإنابة، لكن حالت ظروف الوقت وتغيير المكان أن تحظي بمناقشة كافية، ولذلك، وبالتنسيق مع المُنظمين، قدمت الورقة البحثية باقتضاب في ١٢ أبريل ٢٠٠٨، وتم طبعها ضمن كتاب ضخم حوى وثائق المؤتمر من إعداد د. محمد منير مجاهد [7].
يقول علم الاجتماع أنه يمكن تمييز 4 أنماط أو صيغ من إدارة الاختلاف بين البشر، تختلف باختلاف نمو المجتمعات وتحضرها:
1. النموذج الأصولي: قائم على الـ Confrontation [التصادم مع الآخر
]، ويعتقد بامتلاك الحقيقة، ويدعو لجعل المعايير والقيم الدينية مُلزمة للأفراد بشكل جماعي وليست اختيارية. ويستعين بالتمايز الطائفي وتقسيم تقريبي للعالم إلى “نحن وهم”، “جند الله وجند الشيطان”، “فسطاط الإيمان وفسطاط الكفر”، أو “الأرثوذكسية وفرق الهراطقة”.
2. النموذج العلماني: قائم على الـ Relativism [نسبية الحقيقة
]، ويعتقد بتنوع الأفكار ونسبيتها، وعليه، لا يعطي لأحد الحق في امتلاك الحقيقة، ويدعو إلى حرية اختيار القيم الملائمة بشكل طوعي وليس إلزامي. ويرى أن الاعتقاد بالحق لا يعني أن الآخرين على ضلال، وبالتالي فهم ليسوا أعداء. وبين العلمانيين والأصوليين اختلاف معروف حول منهجية التفكير.
3. النموذج الديني المتسامح: قائم على الـ Forgiveness [الغفران للآخر
]، ويعني التسامي والغفران للآخرين خطيئة “الاختلاف”، لأني أنا أنظف منك، وديني أمرني أن أكون أنظف منك. ويعبر عنه الخطاب القرآني “من شاء فليكفر”، والخطاب المسيحي “أحبوا أعداءكم”، ورغم ما يفرزه الخطاب الديني المتسامح من بشاشة، إلا أنه يصنف الآخر كـ”كافر” في الخطاب الأول، وكـ”عدو” في الخطاب الثاني! بالطبع لا يدعو الخطاب إلى قتال أو عنف، لكنه يصنع حاجزًا بين المتسامح والآخرين.
حزب الوفد يوضع هنا، في النموذج الأخلاقي المتسامح مع الآخرين الأوغاد. نشأ التيار الأخلاقي تاريخيًا لمعاداة العلمانية، وزعم أنها قادتنا إلى السقوط والانحلال وترك الدين، وأن الدين هو الوعاء الأخلاقي الذي يمكن استخدامه في قيادة البشر إلى الأفضل.
4. النموذج الليبرالي: قائم على الـ Tolerance، ولا يمكن ترجمتها للعربية ترجمة دقيقة، وأغلب المترجمين يترجمونها تسامح
خلطًا بينها وبين النموذج الديني المتسامح. أهم ملامح هذا النموذج هي الاعتراف بالخبرات الروحية المُخالفة، وإحتمالية الخلاص والتنوير فيهم وفي الأخرين أيضًا. لكن ما يعنينا هنا أن الليبرالية نشأت في عصر ما بعد الأيديولوجيات، وليس من طبيعتها أن تتخذ الرموز الدينية كشعار لتصدر الحزب السياسي، كما في رمز حزب الوفد.
لو فهمنا كل ما سبق، وقتها سنفهم لِمَ ثقافة حزب الوفد دينية وشعبوية، ولِمَ قام بعمل تحالفات مع الإخوان المسلمين (الذين رفضهم الليبرالي فرج فودة، رحمه الله، واستقال من الوفد وأسس حزب المستقبل). وسنفهم أيضًا ما هو دقيق في المانشيت مثل “امرأة لعوب”، و”عشيقها”، و”أكواب الهلاك الشيطانية”، لأن كل هذه توصيفات وأحكام دينية مسبقة [أصولية]، وليست موجودة في المفردات والأدبيات الليبرالية.




