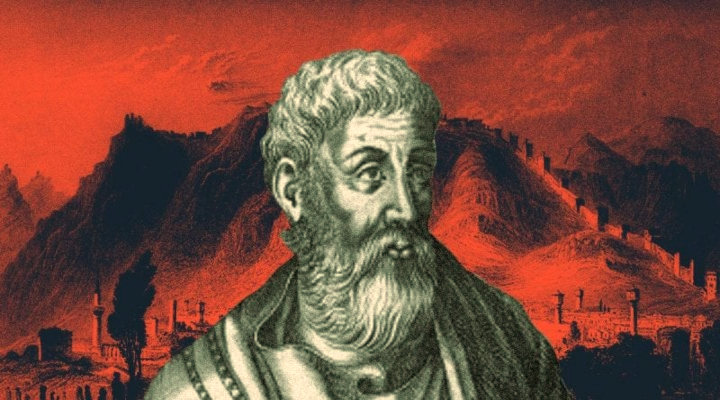لم يمض أكثر من عامين على عودته إلى مسقط رأسه أنطاكية، حتى عُهد إلى ليبانيوس، الأربعينيّ وقتها، بافتتاح الألعاب الأولمبية الأنطاكية عام 356م، بخطاب طويل له، تخطّى المناسبة، وأرّخ لمفصل حضاريّ أساسي، ببلاغة قلّ نظيرها في تاريخ اللغة اليونانية التي كُتب بها هذا الخطاب. حافظت أنطاكية، عاصمةُ سوريا الرومانية في ذلك الوقت، على تنظيم الألعاب مدة أطول من أي مدينة أخرى، إلى يوم إلغائها النهائي عام 520م.
في أنطاكية، كما في سواها، كانت هذه الألعاب محور تجاذب بين الوثنية الآفلة، التي تدافع عن نفسها بطرائق شتى، وبين المسيحية الصاعدة، والمنقسمة على نفسها بضراوة. كانت الألعاب لا تزال تحظى برعاية الأباطرة المتنصرين حين ألقى ليبانيوس خطابه. أمام الجماعات المسيحية في المدينة، فاشتد استهجانها للألعاب واحتفالياتها، وبعد نجاحها مطلع القرن بإلغاء مسابقة المجالدين (المصارعة الدموية بالسيف ضد مجالد آخر أو ضد حيوان بري)، صار مطلب قادتها الروحيين إلغاء الألعاب الأولمبية الأنطاكية ذاتها.
امتياز أنطاكية على كل المدن
أما ليبانيوس وغيره من وثنيي المدينة، فتمسكوا بهذا التقليد الأولمبي كاستمرارية للماضي في الحاضر، معتبرين الألعاب مناسبة مزدوجة، رياضية ودينية في آن واحد، فالإكليل الزيتوني الذي يناله الرياضي الفائز هو بركة من الآلهة، وعلى رأسها زيوس وأبولو. وتبرّم ليبانيوس من علمنة الألعاب الأولمبية، واستاء من التوسيع المتكرر لـ”البلثريون” حيث تقام المسابقات التمهيدية، التي يفترض حسب التقليد أن تُحصر بالخاصة على أن تُترك النهائيات للعامة. وتعامل مع الموسم الأولمبي كاستحقاق لإبقاء تقاليد المدينة اليونانية حية في أنطاكية.
طاف ليبانيوس سنوات طويلة بين أثينا والقسطنطينية ونيقوميدية ونيقية لطلب العلم والفلسفة والبلاغة، وذاع صيته كمعلم في المدرسة السفسطائية الثانية، ومرجع في البيان والبلاغة وفنون المحاججة، وأحد أهم مُمتلكي التراث الكلاسيكي الإغريقي في ذلك الوقت. ورغم قناعة ليبانيوس بأن المسيحية تهدد أُسس التمدن كما يفهمه، فإن تلامذته تنوعوا بين من سار على نهجه في الوثنية، مثل الإمبراطور يوليانوس الجاحد، أو من اختار الطريق المعاكس تمامًا، مثل القديس يوحنا فم الذهب.
فضل ليبانيوس مدينته أنطاكية على سائر المدن، واختار الرجوع إليها في سن الأربعين. حجر الزاوية عنده هو الوطنية بالمعنى الإغريقي القديم، أي انتماء المرء إلى مدينته. في الوقت نفسه، ارتبط هذا الانتماء عنده بالانتساب إلى مشروع تهلين الشرق، بمعنى إعادة تمدينه على النمط اليوناني الهليني، الذي أطلقه الإسكندر المقدوني وورثته المنقسمون فيما بينهم.
كسليل عائلة ثرية سابقًا في أنطاكية، ظل ليبانيوس يرفض تعلم اللاتينية، وتعالى بالتوازي على السريانية، متمثلاً بالكامل بالثقافة اليونانية، مع أنه لم يكن من أصل يوناني خالص. فكما يلاحظ جلانڤيل داوني: اسم ليبانيوس نفسه لم يكن يونانيًا، بل احتوى على الجذر السامي “لبن” ومعناه أبيض، ويظهر هذا الجذر في اسم جبال لبنان. أما المؤرخ الفرنسي پول ڤيين، فيعرّفه بـ السوري العاشق لمدينته اليونانية أنطاكية
.
في مديح أنطاكية على منبر الألعاب الأولمبية، الذي يُعرف بـأنتيوكوس
، وهو من عيون الأدب اليوناني في العصر القديم المتأخر، يستعيد ليبانيوس أساطير منشأ المدينة، بإرادة من الآلهة، في المكان الذي شرب فيه الإسكندر المقدوني من نبع ذكّره بحليب أمه أولمبيا. فأنطاكية أسسها وريث الإسكندر في المشرق سلوقس نيكاتور الفاتح في ربيع 300 قبل الميلاد، كإحدى الشقيقات الأربع [تترابوليس
] في المشروع الاستيطاني اليوناني-المقدوني للشمال الغربي السوري، وسماها على اسم والده، واستخدم لبنائها أنقاض أنتيجونيا القديمة. أما المدن الثلاث الأخرى فهي سلوقية بيريا، المرفأ البحري المتصل بأنطاكية، واللاذقية (لاوديكية)، على اسم والدة الإمبراطور، وأفاميا، على اسم زوجته.
لا يكتفي ليبانيوس بشرح أفضلية أنطاكية على المدن السورية، بل يركز خطابه على إظهار رفعتها نسبة لأثينا وروما والإسكندرية، وخاصة بالنسبة إلى العاصمة الإمبراطورية القسطنطينية، التي حنق عليها لكونها سلبت مدينته امتيازاتها. أطنب في امتداح جماليات المدينة الطبيعية والعمرانية، والربط بين مناخها المعتدل واعتدالها السياسي، والتجانس بينها وريفها، وعلاقتها بنهر العاصي وقربها من البحر. شدد “الأنطاكي” على أن مدينته وريثة أثينا برابطة الدم، إذ أن قسمًا أساسيًا من المستوطنين الأوائل قدم من أثينا، وبالتنظيم السياسي، لكونها أكثر من أبقى على مؤسسات المدينة اليونانية القديمة في عصره، تحديدًا من خلال مجلس شيوخها الواقف حجر عثرة أمام تزايد نفوذ الولاة الرومان، ولكونها موئلاً للبلاغة والفصاحة، ما دامت اللغة اليونانية الكلاسيكية تحافظ على نقائها فيها مقابل اختلاطها بغيرها حتى في أثينا نفسها.
تلميذ ليبانيوس: الإمبراطور المُغامر
انتمى ليبانيوس بكل جوارحه إلى المشروع اليوناني في سوريا. أما علاقته بالإمبراطورية الرومانية فظلت إشكالية؛ فهو من ناحية يُعلي من القيمة الحضارية اليونانية حتى يكاد يُدرج الرومان بين البرابرة، ومن ناحية أخرى يتعامل مع الرومان على أنهم درع حماية الحضارة إزاء البرابرة، لكنه يندد بظلم الولاة منهم في سوريا، واضطهادهم للمجتمعات الريفية فيها، معتبرًا ذلك خروجًا عن الشرائع الرومانية، كما يفاخر بالذين من أصل سوري وتبوؤوا المراكز الرفيعة في إدارة الإمبراطورية.
مما يلاحظه پول ڤيين هنا، أن ليبانيوس السوري، في الوقت الذي اعتبر فيه نفسه يونانيًا إزاء الرومان، رغم تحدره إثنيًا من انتماءات مختلفة، فإنه في الصراع الروماني الفارسي يتصرف كروماني صميم. فابن أنطاكية التي غزاها ونهبها الفرس مرارًا، كان يمني النفس عند كل مواجهة بين هذين الخصمين اللدودين، بمشروع تمديني “يوناني” جديد لبلاد فارس، ولو بالواسطة الرومانية. بناءً على ذلك، يرى پول ڤيين أن ليبانيوس أسهم في دمج الهوية اليونانية بالبوتقة الإمبراطورية الرومانية، وما كان ينقصه إلا المسيحية لتشكيل ما سيشكل لاحقاً ثالوث الهوية البيزنطية.
لأجل كل هذا، كانت سعادة ليبانيوس لا توصف حين آلت الإمبراطورية عام 361م إلى تلميذه الشاب يوليانوس، الذي عُرف بـ”المرتد” أو “الجاحد” في كتب التاريخ، لكونه عقد العزم على إحياء الوثنية، بخلاف المسار الذي سلكته الأمور منذ قسطنطين. فعادت دماء القرابين تُسفح على مذابح المعابد القديمة، والناس تبتهل لآلهتها، في وقت كان المعمّرون وحدهم لا يزالون يذكرون الأزمنة الوثنية السابقة. اشترك كل من ليبانيوس ويوليانوس في نفس النظرة الطهورية إلى الوثنية، التي ترمي إلى إبعادها عن كل شبهة لذائذية ومجون. آمن يوليانوس بتناسخ الأرواح، واعتبر نفسه الإسكندر المقدوني العائد لاجتياح فارس، وعرّج على أنطاكية عشية حملته. كان ليبانيوس في استقباله، لكن الإمبراطور لم يرتح لإعراض أهل أنطاكية عن الدين القويم، فقد وصلها يوم ذكرى مقتل الإله أدونيس، وكان يتصور أنه حين يدخل معبد أبولون في دفنة التابعة لأنطاكية، سيرى شبانًا بيضًا أطهارًا يحملون الخمور والزيوت والبخور ويقدّمون الذبائح. لكنه حين دخل المقام لم يجد شيئًا من هذا، وظنّ أنه لا يزال خارج المقام إلى أن نبّهه الكاهن أن المدينة لم تقدم قربانًا إلا أوزة واحدة جاء بها من بيته.
ضدّ عصابات الرهبة
يخيب الأمل سريعًا حين يُقتل الملك الفيلسوف يوليانوس الجاحد في حملته العسكرية على الساسانيين، فتسري شائعة أنّ فارسًا مسيحيًا من جيشه هو الذي رماه بالسهم، وهذا ما اقتنع به ليبانيوس نفسه في تأريخه للحدث [1]. تستأنف الإمبراطورية الرومانية من بعده تاريخ تحوّلها المسيحي، وتعود لتقويض الحرية الدينية الوثنية شيئاً فشيئًا، ابتداءً من منع القرابين الحيوانية. يسلك الوثنيون مسارات مقاومة مختلفة، مُدركين أنّ إعادة فرض الوثنية كديانة رسمية لم تعد ممكنة بعد رحيل يوليانوس، ولابد من إنقاذ ما يمكن إنقاذه من التراث القديم، والتكيّف قدر الإمكان مع الواقع المسيحي الجديد، والأهمّ، عدم استعداء الأباطرة المسيحيين أكثر.
في هذا السياق المحموم، انبرى ليبانيوس لكتابة رسالته من أجل المعابد
في أواخر الثمانينيات من القرن الرابع، دفاعًا عن التراث الحضاري الوثني الذي من واجب الإمبراطور الروماني حمايته، ولو تنصّر، لما يزخر به هذا التراث من صروح جميلة تُكسب المدن جمالها، ولحماية النظام العام في الوقت نفسه. هاجم ليبانيوس الرهبان المتشحين بالسواد، الذين يأكلون أكثر من الفيلة
ويزاولون الحرب في زمن السلم
، ويقودون العصابات المسلحة، ويتصرفون من تلقاء أنفسهم، ويحرمون الأرياف وأهلها من بركة الآلهة، فيسود الغم ويقل الإنتاج وتضعف موارد الإمبراطورية.
عندما كتب ليبانيوس رسالته، كانت القرابين الحيوانية للآلهة محظورة، أما تقديم البخور لها فكان لا يزال مسموحًا. ولم يكن هناك بعد أي مرسوم إمبراطوري بهدم المعابد (وهو ما سيتأخر حتى سنة 399 م بالنسبة إلى المعابد الريفية، وسنة 435 م بالنسبة إلى المدن). لذلك، ركز الحكيم الأنطاكي على أن حملة التهديم التي طالت يومها معابد أفاميا
ودمرته، كانت خارجة عن القانون، في حين أن الوثنيين كانوا يلتزمون بقانون منع الأضاحي في المقامات، ويكتفون بالبخور فيها، ولا يعرفون من القرابين إلا ما يأكلونه في مآدبهم.
المدنيّة بين ليبانيوس وفم الذهب
لا تزال معظم أعمال هذا الفيلسوف السوري الأنطاكي باللغة اليونانية في غير متناول أهل المشرق اليوم، في وقت تراكمت الدراسات والأبحاث عنه حول العالم. دافع ليبانيوس عن الوثنية الآفلة، ولو أنه فقد الأمل بإعادة إحيائها كدين إمبراطوري من جديد. دافع عن الخبازين وصغار الكسبة والمزارعين واليهود من أبناء مدينته حين أصابهم اضطهاد. ترك لنا عددًا من أهم نصوص الأدب السياسي التي ظهرت في هذه المنطقة من العالم، منها خطابه المتخيل إلى الإمبراطور ثيؤدوسيوس عام 387م، يوم أدى عصيان في المدينة، تخلله جر تماثيل الإمبراطور وزوجته في الوحل، على خلفية مواجهة جُباة الضرائب الإضافية، إلى نزع امتيازاتها ونقل عاصمة الولاية إلى اللاذقية وإقفال الميادين والمسارح والحمامات واعتقال الوجهاء، ما أدى إلى فرار قسم كبير من أبناء المدينة، بينهم تلامذة ليبانيوس.
مع هذا، فالرسالة كُتبت بعد نيل المدينة العفو، وليس قبله. ويتخيل ليبانيوس فيها نفسه في بلاط الإمبراطور يوجّه له الكلام، وهذا محض خيال، إنما الغاية هي ما في طيّات الرسالة. فما يشرحه ليبانيوس عن طريق هذا الأسلوب، هو أن من طبيعة المدن أن تخرج على ولاتها، والدهشة تكون حين لا تفعل ذلك. وعلى الإمبراطور أن يغفر لها، لأنه عليه أن يغفر للمدن العاصية بشكل عام، فالفتن مثل الزلازل والكوارث الطبيعية، ليست موجهة ضده بشخصه. وفي الفتنة تكون المدينة ممسوسة بجنون، أسيرة قوة غامضة، خاصة أن المعابد القديمة مقفلة أو مدمرة، ولم تعد توفّر شبكة الأمان اللازمة.
ويمرر ليبانيوس هنا، كما يلاحظ پيير لويس، أن إغضاب الآلهة ليس من مصلحة الإمبراطور المسيحي ثيؤدوسيوس. الفتن بالنسبة للمدن كالأمراض للبدن، ظاهرة غير مستحبة، لكنها طبيعية، مألوفة، مكررة، وهي أقل في تاريخ أنطاكية مقارنة بسواها خاصة الإسكندرية والقسطنطينية. الإشكالية، كما يطرحها ليبانيوس، هي كيفية ترويض غضب الأباطرة في عصر ما بعد الوثنية. بالنسبة إليه، المسيحية لا تفي بالواجب، وهو يمرر ضمنيًا أن مثيري الفتنة في المدينة هم من المسيحيين، الذين يستغلون ثقة الإمبراطور بهم.
فتنة 387م نفسها كان لها توظيف آخر في تلك الفترة، على لسان القديس يوحنا فم الذهب، تلميذ ليبانيوس ونقيضه الأيديولوجي. سخر فم الذهب من فرار الوثنيين من المدينة عندما قدم جنود الإمبراطور لتأديبها: أين هم أولئك الرجال أصحاب الطيالسة الطويلة واللحى العريضة، الذين كانوا يتمشون شامخي الأنوف في الأندية العمومية وفي يدهم عصا؟ أين هم في ساعة الأحزان والذعر؟ لقد هجروا المدينة عند حلول الخطر وفرّوا إلى المغارات والأودية
.
في موازاة احتفاء ليبانيوس بمدينته كبقية باقية للعالم الحضاري الوثني اليوناني المشرقي القديم، كانت الغلبة للمشروع المسيحي لأنطاكية كمدينة مقدسة حيث دُعي المؤمنون مسيحيين أولًا
كما جاء في أعمال الرسل بالعهد الجديد. تراجعت السردية الممتدة من الإسكندر المقدوني حتى ليبانيوس، لصالح سردية الآباء المؤرخين للكنيسة، التي تجعل كنيسة أنطاكية المؤسَّسة من قبل بطرس الرسول أمَّ كنائس الأمم، وأول كنيسة تأسست في المسيحية لا تقتصر على المتحدرين من أصل يهودي.
في الوقت نفسه، لم يذهب عناد ليبانيوس للحفاظ على التراث اليوناني سدىً؛ فالإمبراطورية الرومانية في قسمها الشرقي ستعود شيئًا فشيئًا إلى هذا التراث، وتتحول إلى إمبراطورية رومانية يونانية بامتياز، أكثر مما كان ليبانيوس يُمنّي النفس يوم كتب إلى تلميذه الإمبراطور يوليانوس: كُن يونانيًا
.
القاسم المشترك الأساسي بين ليبانيوس ويوحنا فم الذهب، رغم الخصومة الأيديولوجية بين الحكيم الوثني وتلميذه المسيحي، هو أن أنطاكية بالنسبة إليهما صارت تعني هوية يونانية؛ إذ كان ربط الهوية الأنطاكية بالثقافة السريانية أمرًا لا يُفكر فيه على الإطلاق. عنت أنطاكية لديهما هوية لا سريانية ولا لاتينية. كان هذا قبل أن تتسرين المدينة أكثر في القرون التالية، في خضم الهجرة من الأرياف إليها، وكل ذلك قبل عصر الفتوحات العربية، مع أن الصراع العربي البيزنطي عليها استمر قرونًا أيضًا.