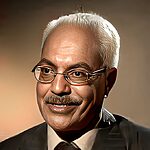- كنيسة اليوم.. كلمة أخيرة
- هواجس الذوبان
- للنهضة جذور وللسياسة رأي
- البابا كيرلس ونقطة الانطلاق
- البابا شنودة والرئيس
- البابا شنودة والكنيسة
- زمن التغيرات المتسارعة
- الرهبنة: الواقع والأمل
- الجدل الكنسى: الجذور والمخاطر والحلول
- أنسنة الإكليروس
- التعليم؛ التوثيق والصراع
- إشكاليات التعليم
- ☑ الأراخنة العلمانيون وتدبير الكنيسة
- هل يمكن لكنيسة أن تنتحر؟
- كنيسة تنتحر [٢]
- كنيسة تنتحر [٣]
- كنيسة تنتحر [٤]
لا أعرف متى تسلل إلينا تقسيم كنيسة جسد المسيح الواحد إلى إكليروس وعلمانيين. هذه الثنائية التي اقتحمتنا، وحملت معها رياح التمييز، وأخذتنا إلى تراتبية طبقية. وكان من الطبيعي أن تمتد هذه التراتبية الطبقية إلى المكون الإكليروسي نفسه، ليس فقط في الترتيب الهرمي السلطوي، بل بين الكهنة المتزوجين والكهنة الرهبان، مخالفةً لطبيعة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي تعلم أن كليهما، الإكليروس والعلمانيين، معًا “شعب الله”، ولا تقر الفصل التعسفي بينهما، ولا تعرف الطبقية داخل رتب الإكليروس. فهم بكل تراتبيتهم كهنة لله، يمارسون ذات الصلوات ونفس الطقوس، والشاهد سر الأسرار “الإفخارستيا” الذي ينتهي بنا إلى تحول الخبز والخمر إلى جسد ودم حقيقيين ليسوع المسيح، حقيقيين وليس ماديين، بحلول الروح القدس عليهما. يستوي في هذا أصغر كاهن في أقصى قرية ونجع مع الأساقفة والمطارنة، حتى البابا البطريرك. وحضور العلمانيين شرط أساسي في إقامة سر الإفخارستيا، ولا يستقيم إتمامه في غيابهم. ولهذا تسمى كنيستنا “كنيسة الشعب”.
وبامتداد تاريخ الكنيسة، كان العلمانيون قوةً ناعمةً للكنيسة، وسبقوا الرسل والتلاميذ في إعلان المسيح للأمم. وهذا ما يؤكده سفر أعمال الرسل حين يخبرنا بحضورهم يوم الخمسين من كل الأمم والألسنة.
الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب إستفانوس، فاجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية، وهم لا يكلمون أحدًا بالكلمة إلا اليهود فقط. ولكن كان منهم قوم، وهم رجال قبرصيون وقيروانيون، الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب.(سفر أعمال الرسل ١١: ١٩-٢١)
ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبلوس، إسكندري الجنس، رجل فصيح مقتدر في الكتب. كان هذا خبيرًا في طريق الرب. وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب. عارفًا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع. فلما سمعه أكيلا وبريسكلا أخذاه إليهما، وشرحا له طريق الرب بأكثر تدقيق.(سفر أعمال الرسل ١٨: ٢٤-٢٦)
ونلاحظ هنا دور أكيلا وبرسكيلا في شرح طريق الرب بأكثر تدقيق، ولم يكونا من التلاميذ، ولم يحملا أية رتبة إكليروسية.
وفي تتبعنا لتوصيات القديس بولس، نجده يوصي الكنيسة في رسالتين بالاهتمام بثلاث خادمات جاهدْن معه في الإنجيل.
أوصي إليكم بأختنا فيبي، التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخريا، كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين، وتقوموا لها في أي شيء احتاجته منكم، لأنها صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضًا.(رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية ١٦: ١-٢)
أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكرا فكرًا واحدًا في الرب. نعم، أسألك أنت أيضًا، يا شريكي المخلص، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل، مع أكليمندس أيضًا وباقي العاملين معي، الذين أسماؤهم في سفر الحياة.(رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي ٤: ٢-٣)
ويحدد معالم الخدمة في الكنيسة بتدقيق في رسالته إلى أهل أفسس:
وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين،(رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس ٤: ١١)
ويعود فيؤكد التكامل في نفس الإصحاح:
كيلا نكون فيما بعد أطفالًا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال. بل صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس: المسيح، الذي منه كل الجسد مركبًا معًا، ومقترنًا بمؤازرة كل مفصل، حسب عمل، على قياس كل جزء، يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة.(رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس ٤: ١٤-١٦)
ويلحّ القديس بولس على هذا المفهوم بإصرار واستفاضة في رسالته الأولى إلى كورنثوس:
ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة. فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد. ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه، قاسما لكل واحد بمفرده، كما يشاء. لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضًا.
لأننا جميعنا بروح واحد أيضًا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودًا كنا أم يونانيين، عبيدًا أم أحرارًا، وجميعنا سقينا روحًا واحدًا.
فإن الجسد أيضًا ليس عضوًا واحدًا بل أعضاء كثيرة. إن قالت الرجل: «لأني لست يدًا، لست من الجسد». أفلم تكن لذلك من الجسد؟ وإن قالت الأذن: «لأني لست عينًا، لست من الجسد». أفلم تكن لذلك من الجسد؟ لو كان كل الجسد عينًا، فأين السمع؟ لو كان الكل سمعًا، فأين الشم؟ وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء، كل واحد منها في الجسد، كما أراد. ولكن لو كان جميعها عضوًا واحدًا، أين الجسد؟ فالآن أعضاء كثيرة، ولكن جسد واحد.(رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس ١٢: ٧-٢٠)
وفكرة البناء الواحد يؤكدها القديس بطرس في رسالته:
كونوا أنتم أيضا مبنيين -كحجارة حية- بيتًا روحيًا، كهنوتًا مقدسًا،[…]وأما أنتم فجنس مُختار، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب.(رسالة بطرس الرسول الأولى ٢: ٥، ٩)
لعل السؤال هو: هل يمكن تصور كنيسة بلا رعية؟
الكنيسة هي الناس، ومنهم يخرج الخدام، بدءًا من خدمة فصول مدارس الأحد وحتى البابا البطريرك، مرورًا بالكهنة والراهبات والأساقفة. وهم خدّام للناس الذين خرجوا منهم.
في تقديري أن إشكالية ثنائية الإكليروس والعلمانيين بدأت على استحياء مع التطور الذي لحق بالأديرة، بالتحاق الشباب الجامعي بالرهبنة، والذي بدأ بدخول الأستاذ سعد عزيز المحامي [1] والدكتور يوسف إسكندر [2]. وكلاهما ترهب عام 1948، ثم لحقهما سنة 1954 الأستاذ نظير جيد [3]. وإن سبقهما بنحو عشر سنوات ويزيد الأستاذ فهيم شنودة المحامي، والذي ترهب عام 1939 بدير البرموس باسم الراهب فرنسيس شنودة البرموسي، لكنه لم يبرح ديره حتى رحيله ولم يشتبك مع إشكاليات الكنيسة.
كان رجل الساعة في تلك المرحلة الراهب مينا المتوحد (مينا البرموسي) الذي وجد شباب أربعينيات القرن العشرين فيه ملجأً ومرشدًا يحتضنهم ويتابع خطواتهم نحو الرهبنة. وعنده تبدأ تباشير استعادة كنيسة الصلاة الدائمة، وإحياء صلوات الإچبية والتسبحة. وحين يصير بطريركًا باسم البابا كيرلس السادس، تجد كل الأطراف فيه النموذج الرهباني الذي ظل حبيس الكتب التراثية، فيلتفون حوله ويتابعون قداساته اليومية، ويهرعون إلى صالونه المفتوح لاستقبالهم بلا قيود أو حواجز. وتنتعش الكنيسة، وتضع قدميها على طريق العودة لكنيسة الآباء.
وقد تعرضنا في هذا الطرح لطيف من مناخات الخدمة عنده، وكيف فتح الباب لشباب الرهبان ليجدوا مكانًا في دائرته، وعندما يجلس تلاميذه على الكرسي البابوي، وكراسي الأسقفية بالتبعية، تشهد الكنيسة تقليصًا متتاليًا للمشاركة العلمانية في تدبيرها، بشكل متدرج، ليس فقط في تحجيم المجلس الملي، بل في إسناد مفاصل إدارة الكنيسة للإكليروس، وبالأكثر للآباء الرهبان، لينتهي الأمر بحصر عمل الكوادر المدنية العلمانية في الأعمال التنفيذية فقط.
وحتى الأخيرة، شهدت مزاحمة الإكليروس، سواء في مجالس (لجان) الكنائس، أو في تولي الكاهن مهام البناء والتشييد والتجديد، وجمع الأموال اللازمة، والتي تبتلع وقته وجهده على حساب مهام الرعاية، فتحولت الكنيسة من “كنيسة الشعب” إلى “كنيسة إكليروسية”. وكان من الطبيعي أن تصطدم الكنيسة بالدولة بعد اختفاء همزة الوصل (العلمانيين)، وكانت أحداث سبتمبر 1981 إحدى نتائج هذا الاصطدام. وكان من الطبيعي أن تتفاقم المشاكل الأسرية، ومغازلة الإلحاد لشبابها المفتقر إلى تعليم مسيحي أرثوذكسي، وتفشّي الطلاق في عدد غير قليل من الأسر.
ولهذا ولأسباب أخرى، منها تراجع الأديرة بسبب التهاون في ضوابط القبول وغياب الشيوخ أو إقصائهم، كما بيّنا سابقًا، تعاني الكنيسة، التي انفرد الإكليروس بإدارتها، من تداعيات مرتبكة. فالأسقف يحتاج، بطبيعة الحال، إلى خبرات في الإدارة والأمور المادية والمالية، والعلاقات مع الجهات الرسمية والدولة، والمواقف السياسية، والتوسع العمراني، ورعاية المعوزين والشباب. وهذه خبرات تتوفر عند العلمانيين بحكم تنوع تخصصاتهم وتجاربهم الحياتية، ومشاركتهم في تدبير الكنيسة يعفي الأسقف من حرج الانغماس فيها، مما يُجور على مسؤوليات الرعاية والتعليم.
ومن يتابع دفتر أحوال الكنيسة يلحظ تنامي أزمة الثقة بين طرفي المعادلة، الإكليروس والعلمانيين، وبروز أزمة التناقض الجيلي والخطوط المقطوعة بين الأجيال، وتحول العلاقة داخل كثير من الكنائس من الأبوة والبنوة إلى التسلط من جانب والتمرد من جانب آخر. وهنا تبرز الحاجة إلى خدمة المصالحة.
وتظهر الحاجة إلى تكوين مجالس علمانية حول الأسقف، تتمتع بالابتكار واستشراف الحاجات الرعوية، وتخفف عنه الأعباء الكثيرة التي تثقل كاهله.
وغير خاف أن العلماني أكثر قدرة على التعرف والاشتباك مع العالم الحديث، وأكثر قدرة، بحكم التنوع المعرفي، على التعرف على مشاكله وتحليلها ومناقشتها ووضع حلول لها، لكونه عضوًا فاعلًا في بيئته الاجتماعية وبثقافة مسيحية. والعلمانيون، بطبيعتهم في مجتمعاتهم، هم شهود الكنيسة في دوائرهم الخاصة والعامة، وهم مدعوون من الله أن يكونوا خميرة الروح القدس التي تخمر العجين كله.
ونجاح وتحقق الدور العلماني يقوم على اتحادهم الحيوي بالمسيح أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثبت فيّ وأنا فيه هذا يأتِي بثمر كثير، لأنكم بِدونِي لا تقدرون أن تفعلوا شيئًا.
[4].
وفى دراسة متعلقة بدور العلمانيين فى الكنيسة يوصى الباحث العلمانيين: أن يجعلوا من جميع أعمالهم تقدّمات روحية، ويكونوا شهودًا للمسيح في دوائره بامتداد حياتهم، وتمدهم أسرار الكنيسة، ولا سيما الإفخارستيا المقدسة، بطاقة الإنجاز لحساب المسيح، وتغذيهم بتلك المحبة، التي هي بمثابة الروح لكل عملهم.
تأسيسًا على ثلاثية الإيمان والرجاء والمحبة التي هي اعظم وصايا الرب ليكن عملهم من أجل مجد الله ومن خلالهم تعرف دوائرهم الإله الحقيقي وهو هدف الرب يسوع وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.
[5].
وغياب الدور العلماني في تدبير الكنيسة أنتج زيادة عدد الكهنة لسدّ حاجة من يدير عمارتها وصيانتها هندسيًا، ومتابعة العمل مع المقاولين، وخدمة الأسر المحتاجة، ومتابعة أزمات الأسر الحديثة التكوين، والمصالحات الأسرية، وتدبير عمل للعاطلين، والتواصل مع الجهات الحكومية والأمنية لحلّ المشاكل القانونية والإدارية، وتدبير الأموال اللازمة لسدّ احتياجات الكنيسة والأسقف. وينتهي الأمر بنا إلى كنيسة تفتقر إلى الرعاية وتعاني من ترهل التعليم، واستبداله بالتعليم الانطباعي، المنبت الصلة بتعليم الآباء المميز لكنيستنا، ترهل محتشد بالحكايات وحديث المعجزات التي تدغدغ المشاعر، والتي تزول مع أول خطوة خارج الكنيسة.
وأنتج هذا الغياب ما نشاهده من أوجه صرف غير منضبطة وغير مبررة، أبرزها الرحلات المكوكية إلى الغرب، والمبالغة في مظاهر الحياة الأسقفية، والمقرات والملابس الإمبراطورية الدخيلة والمفارقة للحس القبطي، والاحتفالات الشخصية، كالمولد والرهبنة والتجليس الأسقفي، عند عدد غير قليل من الأساقفة. يحدث هذا من شخوص توفر لهم قدر من التعليم الجامعي ويعيشون بأقدار مختلفة من معطيات ومنتجات الحداثة، ويقبلون في الوقت نفسه مظاهر حياة العصور الوسطى.
نختتم طرحنا في لقاء قادم يحمل تصوّرات الخروج بالكنيسة إلى النهار، والمصالحة المنتظرة داخلها، وعودتها إلى رسالتها التي تأسست لأجلها.
صدر للكاتب:
كتاب: العلمانيون والكنيسة: صراعات وتحالفات ٢٠٠٩
كتاب: قراءة في واقعنا الكنسي ٢٠١٥
كتاب: الكنيسة.. صراع أم مخاض ميلاد ٢٠١٨