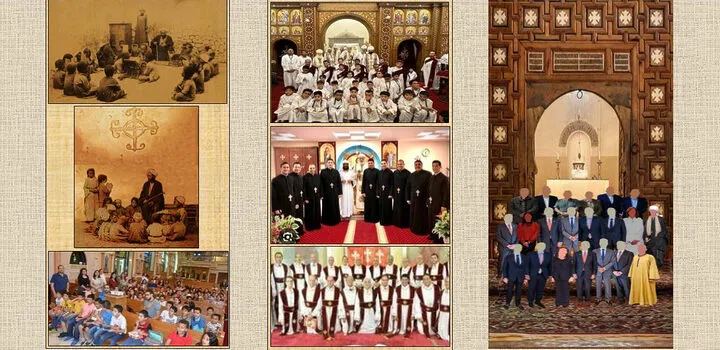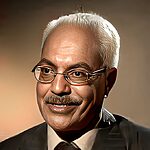- كنيسة اليوم.. كلمة أخيرة
- هواجس الذوبان
- للنهضة جذور وللسياسة رأي
- البابا كيرلس ونقطة الانطلاق
- البابا شنودة والرئيس
- البابا شنودة والكنيسة
- زمن التغيرات المتسارعة
- الرهبنة: الواقع والأمل
- الجدل الكنسى: الجذور والمخاطر والحلول
- أنسنة الإكليروس
- التعليم؛ التوثيق والصراع
- ☑ إشكاليات التعليم
- الأراخنة العلمانيون وتدبير الكنيسة
- هل يمكن لكنيسة أن تنتحر؟
- كنيسة تنتحر [٢]
- كنيسة تنتحر [٣]
- كنيسة تنتحر [٤]
“لأَعْرِفَهُ” الكلمة المفتاحية لهدف وغاية ومنهج التعليم المسيحي الأرثوذكسي، وهو تعليم لا يقوم على المعرفة المجردة، ولا يطلبها لذاتها، إنما هي مرتبطة بشخص ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لذلك فهو المعلم الأساسي بل هو، بحصر المعنى، المعلم الأوحد لأسرار الملكوت، كما يخبرنا الإنجيل بغير مواربة اَللهُ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ قَطُّ. اَلابْنُ الْوَحِيدُ الَّذِي هُوَ فِي حِضْنِ الآبِ هُوَ خَبَّرَ.
، أي هو الذي أعلن لنا ماهية الله، بعد أن كان إلهًا محتجبًا، شوهته الأساطير، وقد انتبهت الكنيسة مبكرًا لأهمية لاهوت التجسد، وأهمية الفهم الصحيح لطبيعة المسيح، وسجلوا هذا في أدبياتهم، ونقلوها بالتتابع الجيلي فيما يعرف بـ”التقليد”، وعلينا أن ننتبه إلى أن التقليد هنا مختلف تمامًا عن التراث، لذلك حرصت الكنيسة على “رسولية التعليم”، في مواجهة التعاليم التي حاولت أن تخلط بينها وبين النظريات الفلسفية التي شاعت في القرون الأولى للمسيحية، وكان لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية دورًا بارزًا في الدفاع عن الإيمان المستقيم.
فالتقليد ليس بديلًا عن الإنجيل وتعليم الآباء الرسل، ولا هو تعليم مواز، بل هو سور حماية لهما لتأكيد أن ما نؤمن به هو عين ما كانت تؤمن به الكنيسة الأولى وتعيشه، وفي هذا يقول القديس بولس الرسول في رسالته الأولى لكنيسة كورونثوس وَأُعَرِّفُكُمْ أَيُّهَا الإِخْوَةُ بِالإِنْجِيلِ الَّذِي بَشَّرْتُكُمْ بِهِ، وَقَبِلْتُمُوهُ، وَتَقُومُونَ فِيهِ، وَبِهِ أَيْضًا تَخْلُصُونَ، إِنْ كُنْتُمْ تَذْكُرُونَ أَيُّ كَلاَمٍ بَشَّرْتُكُمْ بِهِ. إِلاَّ إِذَا كُنْتُمْ قَدْ آمَنْتُمْ عَبَثًا! فَإِنَّنِي سَلَّمْتُ إِلَيْكُمْ فِي الأَوَّلِ مَا قَبِلْتُهُ أَنَا أَيْضًا
.
لذلك نقول إن التقليد هو التسليم، بامتداد تاريخ الكنيسة. وحتى لا تترك الكنيسة الإيمان المسلَّم لنا مرة، عُرضة لإضافات أو حذف أحد، أجملته في ليتورجيتها، القداسات والتسبحة، التي توجز لنا لاهوت التجسد والفداء. وتشرح واقع المحبة الإلهية التي رفعت عنا حكم الموت كعقوبة وحولت العقوبة لنا خلاصًا
.
والليتورجية هي الدرس الدائم والقائم، الذي لا يمل من تذكيرنا بقصة الحب الإلهي التي تختتم بالشركة الافخارستية في كل مرة، والكنيسة عبر ممارساتها، وطقوسها، تضع أمامنا خبراتها تأسيسًا على منهج القديس يوحنا الذي عرفناه الذى رأيناه ولمسته أيدينا
، وتترجم هذا في ترتيبات الصلاة والصوم والعبادة وعمل الرحمة باعتبارها أدوات تعليمية حياتية. ليس فقط بهدف أن نتمثل بالمسيح بل أن نعيشه.
لم تقع الكنيسة في فخ الجمود بل قدمت لنا في ليتورجيتها نموذجًا للتفاعل مع الحياة والثقافة والبيئة وهذا يظهر جليًا في ترتيب القراءات اليومية التي تضعها في قداس الموعوظين، والموجه بالأساس للمقبلين على الايمان وقبل اقتبالهم للمعمودية، ويضمها كتاب “القطمارس”، ويتلى يوميًا بامتداد السنة، الذي لم يتم ترتيبه وجمعه لقراءاته بشكل عشوائي، أو حتى عبر وحدة الرسالة بينها، بل ربطته بالحياة اليومية والمواسم والمناخ، تقدم فيه الدعم اللاهوتي مستمدًا مما قاله وفعله وعلَّم به الرب يسوع المسيح وتناوله تلاميذه في رسائلهم، في حكمة بالغة توثق العلاقة بين المتلقين وبين الكنيسة، التي تعيش معهم يومهم وحياتهم، ليس فقط في الصلوات التي ترفعها من أجل النهر والزرع والمناخ، بل وفي قراءاتها التي تُعمِّد ما يعيشه وتدخله في دائرة اهتمامها وتوجيهها، والكنيسة تقسم قراءاتها حسب مناسباتنا الحياتية:
ـ قطمارس السبوت والآحاد الذي يدخلنا، باعتباره يختص بقراءات يوم الرب، إلى دوائر معرفة الرب يسوع في لاهوته وفي تجسده.
ـ قطمارس الظهور الإلهي.
ـ قطمارس الصوم الكبير.
ـ قطمارس البصخة.
ـ قطمارس الخماسين.
وهنا لابد أن أحيي العمل الموسوعي -المُجهِد- الذي قدمه لنا الأب القمص كيرلس عبد المسيح -كنيسة السيدة العذراء بالفشن (بني سويف) ـ في موسوعة كتب “حكمة الآباء المصريين في ترتيب قراءات السنة الليتورجية”.
وفي سياق القراءات يأتي “السنكسار” وهو الكتاب الذي يرتب تذكيرنا بسير القديسين، سواء في يوم رحيلهم أو في كرازتهم، أو في ذكرى تأسيس كنيسة، أو غيرها من أعمالهم الجليلة، كخبرات حية عاشتها الكنيسة تترجم كم صنع بها الرب وتمجد، ولا يمكن أن ينفردوا بالمشهد خلوا من الرب يسوع، بل تضعهم الكنيسة أمامنا كنماذح نقتدي بهم، كتوجيه ق. بولس في رسالة العبرانيين: أذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله. انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بايمانهم.
كان الانقطاع المعرفي الذي أشرنا إليه كثيرًا، الذي داهمنا أكثر من مرة عبر تاريخنا المديد، مع كل انتقال لنا من لغة إلى أخرى -رضاءًا وقهرًا- هو العامل الأهم في ارتباكات التعليم، حتى إلى التشوش والغموض، وهو ما انتبه له رواد التنوير في العصر الحديث، وقد هالهم ماوصلنا إليه من جمود وتراجع، فكانت الصحوة التي تزامنت مع إطلالة القرنين التاسع عشر والعشرين، وتكللت في العقود الأخيرة منذ منتصف القرن العشرين بتنامي السعي لترجمة تعليم الكنيسة والآباء التي دونت في القرون الأولى للمسيحية باليونانية، مباشرة، وليس عبر لغات وسيطة، الذي يبعث الطُمَأنينة في قلوبنا تفاعل أجيال جديدة مع هذا التوجه، فراح نفر منهم بهدوء وبعيدًا عن الصخب، يتقنون يونانية الآباء ويعكفون على تَرْجَمَة أعمالهم، وتوثيقها في كتب معاصرة شكلت ظاهرة إيجابية كشفتها أروقة مَعْرِض القاهرة الدولي للكتاب 2025، وهو ما ستجني الكنيسة ثماره في عودة الوعي ومن ثم عودة الروح خلال السنوات القادمة.
وحسب واحد من أهم الباحثين اللاهوتيين المعاصرين، الدكتور جورج حبيب بباوي، فإن الفكر الأرثوذكسي اليوم يواجه ثلاثة أخطار رئيسية شاعت بيننا وهي:
أولًا: الفكر اللاهوتي الذاتي الذي يعتمد على خبرة ومعرفة ذاتية دون أن يوضع هذا الفكر على أساس ما جاء بالتقليد الكنسي.
ثانيًا: الفكر اللاهوتي الكتابي الذي يكتفي بالكتاب المقدس وحده دون أن يراجع ما شرحه الآباء لنصوص الكتاب بعهديه.
ثالثًا: الفكر اللاهوتي العقلاني الذي يعتمد على المنطق والمعرفة البشرية دون أن يضع الليتورجية في اعتباره كأساس للممارسة الروحية السليمة.
ويطلق الباحث تحذيره:
نحن هكذا نترك الأرثوذكسية ونبتعد عنها لأننا نترك مصادرها الأصيلة وننطلق من قاعدة تصوراتنا الخاصة وفكرنا الذاتي أي أننا على وشك أن نصبح غير أرثوذكس دون أن ندرى.(الأب متى المسكين، الخدمة)
وفي حديثه عن خدمة التعليم يقول الأب متى المسكين إن:
دروس التعليم هي دروس حياة، حياة أبدية تعد الشاب لا لمواجهة أسئلة الناس بل أسئلة نفسه، وترفعه لا فوق مستوى الآخرين ليتعالى بالمعرفة، بل ترفعه بالحق فوق مستوى أهوائه وشهواته ونزواته ليكون أصغر الكل والمستمتع بالمتكأ الأخير، لا تؤهله لمعرفة الكلام وكتابة الكتب بل تؤهله للتعرف على نعمة المسيح لكشف خطاياه وعيوبه.(الأب متى المسكين، الخدمة)
ويستطرد الكاتب:
هي دروس لا تلقن للعقل على مستوى الحفظ وتكديس المعلومات بل هي قيادة وريادة فى ميدان الروح يتحول فيها الكلام والنصح والتوجيه والتوبيخ إلى إيمان ورجاء وحب، يعمل ويظهر فى السلوك والأخلاق والطباع؛ حيث وسائل الإيضاح لا تعود أوراقًا وأخشابًا وألوانًا، بل برهان الروح فى القلب وإحساس الضمير وظهور المسيح فى أعماق النفس وعشرة الآباء والأنبياء والقديسين ومعايشة قصص الكتاب كما هي يومًا بعد يوم. والامتحانات والجوائز لا تعود مجرد صور وهدايا، بل النجاحات والإخفاقات التي يعيشها الخادم ويوجهها المخدوم تجاه وصايا المسيح وتعاليمه، وحيث لا يعود الدرس ميعاده ساعة بل يمتد ليغطي حاجة العمر كله، والامتحان في نهاية السنة لا يشهد قط على كفاءة التلميذ بل يوم الدينونة.(الأب متى المسكين، الخدمة)
واحدة من إشكاليات التعليم الخلط بين خدمة بناء الإنسان حال حياته وسط الناس وفي مشاغله ومسؤولياته اليومية، وهي خدمة يتحملها المدعو للكهنوت، وبين بناء من يختار العزلة والرهبنة كنسق حياة، وهي خدمة يتحملها المدعو للرهبنة.
الخلط بينهما أنتج لنا جل ما نعاني منه من ارتباكات وهواجس بل ومتاعب حياتية، نعاني منها في الكنيسة وفي البيوت بل وعلى المستوى الشخصي عند الخدام على اختلاف مواقعهم الكنسية، وبين المخدومين في حياتهم الروحية والعملية.
لذلك جاء تنبيه الأب متى المسكين على ضرورة التفريق بين دعوة الكهنوت ودعوة الرهبنة
فالمدعو للكهنوت والخدمة بين الناس يبني قلبه وفكره وكل حياته على سيرة الرسل القديسين، واضعًا أمام عينيه باستمرار سيرتهم في الجهاد المتواصل لخدمة المؤمنين ليلًا ونهارًا، في وقت مناسب وغير مناسب، وما يلزم لذلك من قطع المشيئة والتنازل الكامل عن كل الحقوق الشخصية، والأمنيات والأحلام التي تتعارض مع جهاد الخدمة، حتى ما بدا منها صالحًا في حد ذاته، كالاستغراق في الوحدة والبعد عن الناس والعزوف عن الكلام، إلا إذا كان بالقدر الذي يزيد الخدمة قوة ونجاحًا، أي أن يكون ذلك لا بدافع مجرد استرضاء النفس، بل لإصلاح عجزها، وبالنهاية لزيادة كفاءتها للخدمة.(الأب متى المسكين، الخدمة)
فيمَا يرى أن المدعو للرهبنة:
عليه أن يبنى قلبه وفكره وكل حياته على سيرة الآباء القديسين واضعًا أمام عينيه باستمرار وصيتهم الأولى والعظمى أن يبتعد عن العالم والرئاسات، وأن لا تستهويه الخدمة بين الناس مهما كانت الإلحاحات، وهكذا عليه أن يتمسك بتعاليمهم تمسكًا لا هوادة فيه وإلا سيجد نفسه فى النهاية راهبًا بلا رهبنة يعيش تحت اسمها ولا يحمل نيرها، يتكلم باسمها وهو غريب عن دعوتها.(الأب متى المسكين، الخدمة)
ويضع الأب متى المسكين أصحاب الدعوتين أمام خطر يتهددهما:
فكما يحارب الراهب بحب الخدمة، يحارب الكاهن والخادم بحب الوحدة، وكلا الحربين هما إلحاح من اللاشعور للهروب من الواقع، وذلك إنما يكون بسبب إخفاقات عارضة لا ينبغي أن ينهزم الإنسان أمامها، إذ بمجرد أن يتشدد الإنسان بالله ويقف أمامه مجددًا عهده متشجعًا بالأمثلة الحية التى سبقته، فإنه يُقبِل على دعوته بغيرة ونشاط ويعود فيرى فيها كل راحته وسلامه وإكليله.(الأب متى المسكين، الخدمة)
ويختتم نصيحته للكاهن وللراهب بقوله:
ليس هذا معناه أن لا يتثقف الراهب بكلمة الإنجيل كل يوم وبكل عمق وإخلاص، ولا أن يمتنع الكاهن وخادم الإنجيل أن يتربى تحت أقدام الآباء وتعاليمهم وعفتهم وزهدهم، على الراهب أن يجعل من الكلمة نورًا للسيرة الرهبانية الزاهدة المتعففة، وعلى الكاهن أن يجعل من سيرة الآباء وزهدهم برهانًا لصدق الكلمة التى يخدمها ويبشر بها، مشجعًا له وللذين يجاهدون معه للشهادة وسط العالم ضد العالم.(الأب متى المسكين، الخدمة)
كنيستنا غنية ومستنيرة بخبرات الحياة في المسيح التي ترجمتها في طقوسها وليتورجيتها، وزخم حيوات قديسيها، وتفكيك إشكاليات التعليم المعاصر يكون بطرحها على فكر الكنيسة في عصور توهجها، عندما كانت تعيش المسيح بعيدًا عن الرؤى الشخصية الضيقة.
وما زالنا على وعد بلقاء نستكمل فيه كلمتنا الأخيرة بشأن كنيسة اليوم.
صدر للكاتب:
كتاب: العلمانيون والكنيسة: صراعات وتحالفات ٢٠٠٩
كتاب: قراءة في واقعنا الكنسي ٢٠١٥
كتاب: الكنيسة.. صراع أم مخاض ميلاد ٢٠١٨