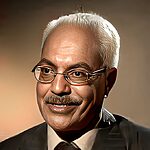- كنيسة اليوم.. كلمة أخيرة
- هواجس الذوبان
- للنهضة جذور وللسياسة رأي
- البابا كيرلس ونقطة الانطلاق
- البابا شنودة والرئيس
- البابا شنودة والكنيسة
- ☑ زمن التغيرات المتسارعة
- الرهبنة: الواقع والأمل
- الجدل الكنسى: الجذور والمخاطر والحلول
- أنسنة الإكليروس
- التعليم؛ التوثيق والصراع
- إشكاليات التعليم
- الأراخنة العلمانيون وتدبير الكنيسة
- هل يمكن لكنيسة أن تنتحر؟
- كنيسة تنتحر [٢]
- كنيسة تنتحر [٣]
- كنيسة تنتحر [٤]
منذ السطر الأول في طرحنا هذا، أكدنا أننا لا نسعى للتأريخ أو حتى رصد الأحداث الجسام في مسيرة ومسار الكنيسة، ولا لطرح قضايا لاهوتية. وأوضحنا أننا نسعى للبحث عن المقدمات التي قادتنا إلى الحالة التي نحن فيها، من صراعات ومصادمات وتشتت، كانت في بعضها تهدد وحدة الكنيسة وسلامها، وكانت مرشحة لتهديد بقائها، وهو أمر جلل، ولا أظن أن أحدًا يقبل أو يحتمل هذا.
ظن البعض، في مناخات الأزمة، أنها فرصة للانتصار لجناح ضد آخر. وبدا الترقب والتحفز واضحًا فيما حملته بعض التعليقات عقب نشر حلقات هذه الدراسة، بين مهلل ورافض. وبعضها في الجناحين لم يكلف نفسه عناء القراءة، ولعل أكثرهم لم يلتفت إلى العنوان الرئيس، الذي يقول: كلمة أخيرة
. وهي أخيرة لارتباطها بعمر طال حتى اقترب بي من أبواب الثمانين، وهو أمر لو تعلمون ثقيل. وجدت معه أنه يجب عليَّ أن أقول كلمتي بما اختزنته الذاكرة قبل أن أمضي أو قبل أن يداهمني ألزهايمر، لعلها تصادف يومًا من يلتفت إليها، ويفككها ويترجمها إلى فعل يقيم الكنيسة من عثرتها، بعيدًا عن الانحيازات الضيقة التي تلفنا. وقد يكون واقفًا هناك على الشاطئ الآخر للمتوسط أو المحيط، إذ يتملكني هاجس أن التصحيح سيأتي من أبناء الكنيسة هناك، ربما لأنهم عاشوا صدمة الاستنارة الفكرية مع ثقافات تلك البلدان، التي انتقلت من الشخوص إلى الكيانات، تمامًا كما حدث معنا في كل مرة باغتتنا فيها حملات تلك البلاد ونموذجها الحملة الفرنسية، التي كانت في واحدة من تداعياتها انطلاق شرارة التنوير. وأبناء الكنيسة هناك يجمعون بين الأصالة والمعاصرة، في احتماء بالزخم القبطي الذي لم يبارحهم.
واحدة من الملاحظات على عصر البابا شنودة، الذي يغطي نصف قرن، أنه عصر التطورات، بل القفزات العلمية والتقنية المتسارعة، خاصة في العقدين الأخيرين، التي انعكست على تشكيل ذهنية الأجيال المعاصرة، وعلى طريقة التعاطي مع المعلومة والفكرة، ومفهوم الدين في مجمله، حتى أدت إلى ظهور موجات الإلحاد. وكانت هذه التطورات تستوجب أن يواكبها تطور في التعامل مع هذه الأجيال، وقد تغير عندها مفهوم الأبوة. وهنا تكمن واحدة من معضلات الكنيسة، فهي بحكم تكوينها “كنيسة تقليدية محافظة”، شأن كل الكنائس الرسولية، لكنها لم تلتفت إلى هذه الفجوة، كما فعلت كنيسة أنطاكية. ويتضح ذلك بسهولة عندما نقارن بين تجربتين فيهما: لدينا تجربة “مدارس الأحد”، وعندهم تجربة “الشبيبة الأرثوذكسية”. وتكشف أدبيات التجربتين عن الحراك المتباطئ في الأولى، والتثوير الفكري في الثانية، الذي يجمع بين الالتزام بالثوابت الإيمانية وأدوات نقلها للأجيال الجديدة من علوم الفلسفة والمنطق والتواصل. وقد وظفتها كنيسة أنطاكية في مخاطبة شبابها، بل واهتمت بدفعهم للمشاركة في الشأن العام بفاعلية. كانت العقبة عندنا أن منطلقات الصحوة جاءت على أرضية رهبانية، بنت حراكها على العزلة والنسك، وأن التعاطي مع العالم هو أصل كل الشرور.
كان البابا شنودة مؤمنًا بمشروعه، وبدأ في ترجمته منذ اللحظة الأولى كأسقف تعليم، وهو موقع استحدثه البابا كيرلس السادس. فيه حشد أسقفه كل مواهبه وقدم للكنيسة شكلًا مختلفًا في مسارات الوعظ، وفيما أتصور أنه أول أسقف يؤسس لاجتماع مرتبط باسمه في الكنيسة القبطية. أدرك عطش الناس للإجابة على أسئلة تؤرقهم اجتماعيًا ودينيًا وأسريًا، فقسم اجتماعه الأسبوعي إلى قسمين: الأول للإجابة على أسئلة الحضور، والثاني للموضوع الذي اختاره. كسر كل تابوات عظات ذاك الزمان، فتكلم مع الناس بلغة يفهمونها، بعد أن جردها من قيود ومعضلات المحسنات البديعية ورتابة الإلقاء، دون أن يفقد فصاحة اللغة. لم يبدأ اجتماعه بحملة إعلانية أو ضجيج.
أتذكر أن البداية كانت في قاعة مطعم الكلية الإكليريكية، وكان الحضور يتراوح بين خمسين إلى سبعين شخصًا، معظمهم من طلبة الإكليريكية وأصدقائهم. سرعان ما انتشر خبر الاجتماع حتى ضاق المكان برواده، فانتقل إلى القاعة اليوسابية (قاعة الأنبا رويس) بالكلية الإكليريكية، ثم انتقل إلى الكنيسة المرقسية، البطريركية القديمة، قبل أن تنتقل إلى مقرها الحالي بالعباسية، حيث انتقل إليها الاجتماع لاحقًا في الدور الأول، وهو لا يزال على حالته الخرسانية.
كان السبب في كل هذه التنقلات تزايد الإقبال الشعبي، والشباب في القلب منه. وتبدت حنكة الأب الأسقف في اختيار موعد الاجتماع مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، الإجازة الرسمية للطلبة والموظفين، الكتلة الأكبر المستهدفة. وفي الموضوعات التي اختارها في مرحلة بداية الاجتماع، كانت تأملات في مزامير السواعي، خاصة تلك التي تمس احتياجات الناس. وتبث الأمل في نفوسهم، وتؤكد استجابة الله لهم.
كان الاجتماع فرصة ليبدي الأسقف الشاب رأيه فيما يحدث في الكنيسة وفي المجتمع وفي الدولة، عبر إجاباته على أسئلة الاجتماع، وأيضًا من خلال القضايا التي تتناولها موضوعاته. وبالتوازي، كانت مجلة “الكرازة”، التي تصدر عن أسقفية التعليم ويرأس الأسقف تحريرها، تعزز طرح رؤاه، في استكمال لما كانت تتبناه مجلة “مدارس الأحد” التي رأس تحريرها وهو علماني قبل أن يقصد الدير طالبًا الرهبنة. وقد أدرك مبكرًا أهمية الإعلام في خدمته، مسموعًا ومُشاهدًا في الاجتماع، ومقروءًا في المجلة. وقد خاض العديد من المعارك الفكرية والسياسية عبر صفحاتها، حتى ضاق البابا كيرلس بالأمر، فأصدر تعليماته بعودة الأسقف إلى ديره، فانصاع للأمر وتوقف الاجتماع وتوقفت المجلة.
تعود المجلة ويعود الاجتماع مجددًا بعد تنصيبه بطريركًا. ويواصل البابا الجديد معاركه عبرهما في مرحلة اختلفت فيها التوازنات، وشهدت ظهور الجماعات الإسلامية على الساحة السياسية، وكانت ترى في البابا الجديد عدوًا لرسالتها وسعيها. وغير بعيد عن مقر البابا، كان هناك أحد شيوخ تلك الجماعات، وهو الشيخ عبد الحميد كشك، الذي جعل من البابا واجتماعه هدفًا يترصده ويهاجمه ويؤلب الجماهير عليه أسبوعيًا في اجتماعه الذي يعقده يوم الجمعة أيضًا، في مسجد عين الحياة بشارع مصر والسودان، الذي كان على مرمى حجر من الكاتدرائية.
صار يوم الجمعة يومًا ملتهبًا يهدد أمن وسلامة الشارع، فكان أن تم الاتفاق مع البابا على تغيير موعد اجتماعه ليكون الأربعاء، وتجري في النهر مياهًا درامية كثيرة، وضاق رئيس الدولة بالبابا وردود أفعاله كممثل للأقباط، كما أرادت الدولة حسب تحليل الدكتور ميلاد حنا، أنها اختزلت الأقباط في الكنيسة، واختزلت الكنيسة في الإكليروس، واختزلت الإكليروس في البابا، ليصبح ممثلًا لهم أمامها. يضيق الرئيس بالبابا، فيعلن في خطابه المأساوي في 5 سبتمبر 1981 قراره بإلغاء القرار الجمهوري الذي يقضي بتعيين الأنبا شنودة بابا للكنيسة، ووقف اجتماعه، ووقف صدور مجلة الكرازة. واعتقال الشيخ كشك، الذي دأب على مهاجمة السادات في خطبه، ضمن الرموز الدينية والسياسية التي شملها قرار الاعتقال، الذي شمل أكثر من ألف وخمسمائة شخص من كافة التيارات السياسية والفكرية.
نقترب من البابا في مواجهاته، لنجده قد أفرغ الدائرة حوله من الداعمين الحقيقيين، سواء من أقرانه في مشوار الصعود، أو من المؤمنين بضرورة تطوير العمل الكنسي الرعوي والتعليمي، خاصة بعد عودته من الإقامة الجبرية في الدير، وإلغائه القرارات التي اتخذتها اللجنة الخماسية، خاصة فيما يتعلق بعودة بعض الكهنة المبعدين. وبدأ في التوسع في رسامات أساقفة جدد، جلهم من الشباب الغر، يفتقرون لمقومات الرعاية، ولم تكتمل تلمذتهم الديرية بعد، الأمر الذي انعكس سلبًا على الخدمة والعمل الكنسي.
لم تحقق تجربة تقسيم الإيبارشيات النتيجة المرجوة لأسباب موضوعية. فقد استتبع إقامة الأسقف على عدد محدود من القرى، أن يتجه سعيه لتدبير وتأثيث مقرًا لإقامته، يتحمل أعباءه الرعية. كما توسع في رسامات الكهنة بغير قواعد منظمة، وفي بعض الحالات، يقوم الأسقف بتكليفهم بالنزول إلى القاهرة والإسكندرية لجمع تبرعات لتغطية الأعباء، وهم صاغرون. وتشهد الكنيسة ظاهرة الاحتفال بكل مناسبات الأسقف، يوم رهبنته، ويوم رسامته، بل ويوم ميلاده. وتشهد جريدة “وطني” إعلانات تصل إلى مساحة صفحة كاملة لتهنئته بكل مناسبة منها. وفي محاولة للتشبه بالبابا، ينشئ الأسقف اجتماعًا أسبوعيًا حتى لو لم تكن لديه موهبة الوعظ. وكما في القاهرة، كذلك في الأقاليم، يتم تقليص الدور العلماني لحساب الإكليروس، الذي يعاني بدوره من الطبقية. فاليد العليا للأسقف، فيما الكاهن منفذ لتعليماته دون نقاش. وتفاقمت أزمة الكهنة لتسري بينهم دعوة لتكوين نقابة لهم تدافع عن حقوقهم وتتصدى لعسف الأسقف وامتلاكه السيطرة عليهم دون محاكمة ودون توفر قواعد قانونية متفق عليها تنظم التأديبات الكنسية. لكن الدعوة قوبلت برفض تام، فالكنيسة لا تتشبه بالعالم (الشرير)، والأسقف يرشده (الروح القدس) في تدبيره لإيبارشيته.
في القاهرة، تبدو الأمور مبشرة مع مجيء البابا الجديد، إذ يعلن عن ضرورة عودة المجلس الملي إلى دوره المهم في إدارة شؤون الكنيسة المادية، التي لا يجب على الإكليروس الانشغال بها. بالإضافة إلى ذلك، يكون المجلس حلقة وصل بين الكنيسة والدولة، بما يضمه من خبرات مدنية وسياسية. وعندما تدور عجلة الانتخابات، يتم توزيع منشورات على الناخبين تحمل قائمة يروج موزعوها أنها القائمة التي تحظى برضا البابا، وترافقها نصيحة من كهنة مراكز الاقتراع: “مش عاوزين حد يدخل المجلس من معارضي البابا لسلام الكنيسة”. وكانت النتيجة متكررة في كل دورات المجلس: نجاح قائمة البابا حصرًا.
اللافت تفرد هذه الانتخابات بإجراءات خاصة بها. فالجمعية العمومية للناخبين يعاد تشكيلها مع كل انتخابات، إذ تعلن وزارة الداخلية في كل مرة عن فتح باب القيد في قوائم الناخبين، الذين لم يتجاوز عددهم في كل المرات الثمانمائة ناخب. ثم يفتح باب القيد في قوائم المرشحين. هكذا يأتي المجلس الملي العام، ثم يبادر البابا بسيامتهم شمامسة، الأمر الذي اعترض عليه كثيرون، ومنهم أساقفة، لعل أبرزهم الأنبا غريغوريوس، أسقف البحث العلمي؛ لأن سيامتهم شمامسة، وهي رتبة كهنوتية، تخضعهم كنسيًا لتعليمات وتوجيهات البابا، الأمر الذي يمثل قيدًا على ممارستهم لمهامهم.
في سياق تجربة تقسيم الإيبارشيات ونتائجها، اقترح البعض، عبر أوراق بحثية قدمت للبابا آنذاك، أن يعاد النظر في قواعد تحديد النطاق الجغرافي للإيبارشية ليتطابق مع التقسيم الإداري للدولة. فيكون لكل محافظة مطران ويتبعه عدد من مساعدي الأب المطران برتبة (خوري إبسكوبس) بحسب الكثافة المسيحية فيها. يضم مقر الإيبارشية جميعهم، ويشكلون مجلسًا للإيبارشية برئاسة الأب المطران. ويشكل مجموع المطارنة مجلس الكنيسة الأعلى، برئاسة البابا البطريرك.
ويحقق هذا النظام أكثر من فائدة، منها تخفيف الالتزامات التي تفرضها إقامة أسقف لكل مدينة أو عدة مدن، مقرًا وكرسيًا وهيئة مساعدين. وعلى مستوى الكنيسة، يوفر لها مجلسًا [مجمعًا] أكثر تجانسًا يملك مساحة أوفر للحوار والتوافق واتخاذ القرار. لكن أحدًا لم يتفاعل معه أو يستجب له، ليبقَ الحال على ما هو عليه، بل ويزداد تفاقمًا. فلم تعد الأديرة مفرخة للرهبان المعدين لتلك المهمة، رغم زيادة المقبلين على الرهبنة، التي تزامنت مع إقصاء شيوخها، وقصر اعتراف الرهبان على الأسقف رئيس الدير، ليدخل الرهبان في دائرة القولبة، وتختفي الخصائص الذاتية لكل دير.
وعلى عكس المستقر في الأديرة، تتوسع في رسامة رهبانها كهنة، بل وتعد لذلك قوائم انتظار، وتشرع أبوابها للزيارات الفردية والجماعية بلا ضوابط. وتنخرط في المشروعات الإنتاجية وتتوسع فيها، لترتبك الحياة الديرية بين نذور الراهب وانشغاله بالعمل في تلك المشروعات، التي لا تجمعها إدارة عليا تنسق بينها وتوزع ريعها على بقية الأديرة، وعلى المعوزين، وعلى الإيبارشيات الأكثر احتياجًا.
خبرات أساقفة التعليم كشفت له قصور الكلية الإكليريكية الأساسية -القسم النهاري الداخلي- عن تغطية احتياجات الخدمة، فعدل كبطريرك عن رسامة خريجي هذا القسم. فذهبوا يبحثون عن فرصتهم بالأقاليم، فيما ركز اختياراته على القسم المسائي الذي يضم خريجي الجامعات من مختلف التخصصات. ولم يكن هذا القسم آنذاك يزيد عن مستوى اجتماع شباب مكبّر، ويفتقر إلى المعايشة الحياتية كما كان القسم النهاري (الداخلي). واتجه لإقناع الدفعات القديمة من أمناء الخدمة بالرسامة الكهنوتية لتسريع سد الفجوة وتوفير كوادر لها خبراتها في الخدمة، وكانوا في خط مواز قد تبوأوا مواقع متقدمة في وظائفهم المدنية، التي يفقدونها ونفقد معها التوازن على الخريطة العامة.
من يتابع تلك الحقبة يلمس تقليص الدور العلماني [المدني] في خريطة التدبير الكنسي. فاختفاء المجلس الملّي وتدجينه أدى إلى انفراد قيادات الإكليروس بهذا الدور. وما الصدام بين السادات والبابا في جانب كبير منه إلا واحدا من تداعيات هذا الانفراد، بعد اختفاء حائط الصد الطبيعي بإقصاء الأراخنة، واختلاط ما لله بما لقيصر. وامتد حصار الدور العلماني ليقبع في دائرة العمل التنفيذي الذي يخضع لرؤية الأسقف منفردًا، بغير التفات لخبرات المدنيين من شعب الكنيسة. تتراجع الخبرة وتتقدم الثقة كمعيار للاختيار، وتتسلل الأزمات إلى الكنيسة.
كان عصر البابا شنودة عصر التغيرات السريعة والعاصفة في الفضاء العام التقني والعالمي والسياسي، وفي الفضاء الكنسي الذي شهد قفزات متسارعة في مد الغطاء الكنسي داخل مصر وخارجها، حتى إلى أقصى المسكونة، سعيًا لتعميق أواصر العلاقة مع أبنائها وربطهم بكنيستهم ووطنهم. ولا يمكن إغفال ما قدمه لكنيسته ووطنه.
تجربة البابا شنودة تبقى تجربة إنسانية عميقة الأثر، اجتازت قممًا وقيعانًا. لا يمكن اختزالها في الاختيار بين الأبيض والأسود، وقد حفلت بالكثير مما امتد أثره إلى اليوم، إيجابًا وسلبًا، شأن كل التجارب الإنسانية الكبيرة.
وما زال الاقتراب من كنيسة اليوم قائمًا، فإلى لقاء.
صدر للكاتب:
كتاب: العلمانيون والكنيسة: صراعات وتحالفات ٢٠٠٩
كتاب: قراءة في واقعنا الكنسي ٢٠١٥
كتاب: الكنيسة.. صراع أم مخاض ميلاد ٢٠١٨