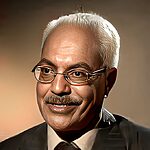- كنيسة اليوم.. كلمة أخيرة
- هواجس الذوبان
- للنهضة جذور وللسياسة رأي
- البابا كيرلس ونقطة الانطلاق
- البابا شنودة والرئيس
- ☑ البابا شنودة والكنيسة
- زمن التغيرات المتسارعة
- الرهبنة: الواقع والأمل
- الجدل الكنسى: الجذور والمخاطر والحلول
- أنسنة الإكليروس
- التعليم؛ التوثيق والصراع
- إشكاليات التعليم
- الأراخنة العلمانيون وتدبير الكنيسة
- هل يمكن لكنيسة أن تنتحر؟
- كنيسة تنتحر [٢]
- كنيسة تنتحر [٣]
- كنيسة تنتحر [٤]
لا نتعرض هنا للقضايا اللاهوتية التي كانت محل جدل بين رموز المرحلة، فهي من الدقة التي تفرض على من يفككها أن يكون باحثًا لاهوتيًا أكاديميًا، يطرحها على فكر الكنيسة الأولى وعمادها الإنجيل وتعليم الرسل والتقليد المحقق المسَلّم لها، تمامًا كما حدث في مجامع الكنيسة المسكونية في القرن الرابع، التي نحتت لنا قانون الإيمان النيقاوي القسطنطيني، الذي اعتمدته كل الكنائس حتى بعد الانشقاق، ومازال كل المسيحيين يرددونه في صلواتهم الليتورچية والشخصية.
وفي تقديري أن صراعات أعمدة الكنيسة المعاصرة، انطلقت من منطلقات شخصية ثم بحث بعض أطرافها على غطاء لاهوتي يبررها أمام الرعية والعالم، فذهبوا يتسقطون لبعضهم كلمة هنا أو جملة هناك، يبنون عليها مواقفهم، فكانت النتيجة أن أفيالنا أوغلت في الصراع -المعلن أو المتوارى خلف جدران مواقعهم- فيما تحطمت حنطتنا تحت أقدامهم الثقيلة.
كانت الحقيقة التي لا نقترب منها أن بدايات الخلافات كانت وهم علمانيون في بواكير اشتباكهم مع الشأن الكنسي، ولم ينخرط أحدهم في البحث الأكاديمي، وشكلوا معارفهم من قراءات لاهوتية متناثرة وشحيحة في ذاك الزمان، بعضها من أصول غير أرثوذكسية، اختلطت بتصوراتهم واستيعابهم، يتقدمها حماسهم في السعي لإقالة الكنيسة من عثرتها، اتفقوا في الهدف واختلفوا على الطريق.
وبينما هم كذلك انقسموا بين الرهبنة والتكريس، وبينهما تشعبت الطرق، فمن ذهب للرهبنة اعتنق الإصلاح في تقويم الهرم الإكليروسي، ودعم قبضته، فيما كان من اختاروا التكريس يرون أن التصحيح لا يأتي إلا من خلال إعادة التواصل مع الفكر الآبائي في الكنيسة الأولى، فذهبوا للتنقيب عن إنتاجهم اللاهوتي الموثق باللغة اليونانية، التي عكفوا على إتقانها بمثابرة وجلّد، بعضهم حوَّل مساره للرهبنة، بعد المتاعب التي حاصرت حركة التكريس، مع الاستمرار في ترجمة وتعريب الفكر الآبائي في قلاليهم، بينما بقى بعضهم في التكريس خارج الأديرة، واستطاعوا أن يحموا حراكهم بتأسيس مراكز بحثية بغطاءات قانونية. كان همها ترجمة كتب ووثائق وفكر الآباء.
لم يستطع أي من الفريقين مد خطوط التواصل بينهما، وتعمق الشرخ الذي وصل في بعضه إلى القطيعة، والمجاهرة بالصراع، وبقي الأمر على هذا الحال حتى نجح فريق الإصلاح التراتبي في الوصول إلى مقاليد إدارة الكنيسة، لتتغير التوازنات، ومن ثم إدارة الاختلاف، ونعاني من تداعيات علاقة السلطة بالمثقف، وتضج عقولنا بين الفرقاء، ونعاني خارج دوائرهم، من عديد من المتاعب مع تصاعد التيارات الإسلامية، وتَبني استهداف الأقباط والتضييق عليهم، الأمر الذي دفع بسعي الحفاظ على البقاء وحماية الهوية القبطية إلى مقدمة سعى الأقباط، فيما يتفاقم صراع فرقاء المصلحين خلف الأبواب المغلقة، تحمل إشاراتها المباشرة أو المتوارية كتبهم وعظاتهم. وكانت الغلبة بطبيعة الحال لجناح السلطة.
بعيدًا عن هذا نتابع رحلة البابا شنودة في موقعه الجديد “بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية”، التي تبدأ يوم الأحد ٣١ أكتوبر ١٩٧١ بعد صلوات القداس الإلهي، يبدأ القائمقام، الأنبا أنطونيوس، مطران سوهاج، مراسم إجراء القرعة الهيكلية، حسب اللائحة المعدلة لانتخاب البابا البطريرك، التي انتهت باختيار الأنبا شنودة أسقف التعليم، ويرصد كتاب “تاريخ مدارس الأحد في مئة عام” أحداث تلك الأيام، صدر القرار الجمهوري الخاص بالبابا (اعتماد نتيجة الانتخابات وتعيينه)، في صبيحة اليوم التالي، أول نوفمبر ١٩٧١، وفي يوم ٨ نوفمبر ١٩٧١ توجه البابا المختار الأنبا شنودة إلى القاهرة لمقابلة السيد رئيس الجمهورية محمد أنور السادات في بيت الرئيس بالجيزة، وكانت المقابلة ودية.
وفي الأحد 14 نوفمبر يتم تجليس وتنصيب الأنبا شنودة على الكرسي المرقسي.
يقوم البابا بزيارات متتابعة، عام ١٩٧٢، لأغلب الأديرة، في وادي النطرون ومنها دير الأنبا مقار، وكذلك أديرة البحر الأحمر وفي عودته منها يزور الجبهة الحربية التي كانت تستعد لحرب أكتوبر ويلقي على الضباط والجنود كلمة وطنية داعمة. ويهتم بتعمير أديرة الصعيد، وتطوير الاحتفالات بأعياد القديسين لتتحول من “موالد شعبية” إلى احتفالات روحية.
يفتتح البابا رسامات الأساقفة من رفاق المسيرة وكبار خدام مدارس الأحد، ويشرع في تكليف لجنة لمراجعة السنكسار وأخرى لمراجعة الكتب الطقسية وثالثة المدائح والترانيم التي تتلى في التوزيع في القداس الإلهي، وتنقيح الأبصلمودية الكيهكية، كتاب التسبحة، وعهد هذه المهام بالترتيب للأنبا يوأنس، أسقف الغربية، والأنبا غريغوريوس، وكل من الدكتور يوسف منصور والأستاذ حلمي رفلة.
كانت رؤية البابا أن تركيز الخدمة في نطاقات جغرافية صغيرة يؤدى إلى نتائج أفضل في الرعاية والتعليم، والخدمات الأخرى، وساعده على تطبيق هذه القاعدة توالى رحيل الآباء المطارنة إذ كان أغلبهم طاعنين في السن، وكانت إيبارشياتهم مترامية الأطراف وتضم أكثر من محافظة، فمع رحيل الأب المطران يتم تقسيم إيبارشيته إلى عدد من الإيبارشيات تضم الواحدة منها عددًا من مراكز وقرى المحافظة، وبجوار هذا التقسيم توسع البابا في رسامة الأساقفة العموم، بدون أن يحمل تقليد رسامتهم مسؤوليات محددة كما كان الحال عند البابا كيرلس السادس، وهي خبرة تحتاج إلى دراسة موضوعية تعظم إيجابياتها وتقلص سلبياتها.
في تقرير إحصائي قام البابا كيرلس برسامة 21 أسقفًا، منهم مطران الكرسي الأورشليمي (القدس)، وثلاثة أساقفة عموم لهم مهام محددة، وأسقفان للسودان وأسقف لإفريقيا، إضافة إلى رسامة بطريرك (جاثليق) لكنيسة إثيوبيا، بامتداد إثني عشرة سنة هي مدة حبريته (مايو ١٩٥٩ ـ مارس ١٩٧١).
بينما قام البابا شنودة برسامة ١١١ أسقفًا (٨٢ داخل مصر، ١ القدس، ٤ السودان وإفريقيا، ١٢ أوروبا، ٦ الولايات المتحدة الأمريكية، ١ كندا، ٣ استراليا، ٢ أمريكا الجنوبية). بامتداد ٤٠ سنة هي مدة حبريته (١٤ نوفمبر ١٩٧١ – ١٧ مارس ٢٠١٢).
واصل البابا اهتمامه بالأسر الجامعية التي تخدم شباب الأقباط بالجامعات، التي دعمها وهو أسقف للتعليم، وكانت قد بدأت في الخمسينيات برعاية الدكتور شفيق عبد الملك الأستاذ بطب عين شمس والأستاذ بمعهد الدراسات القبطية وقد تولى عمادته فيما بعد، وشكل لها البابا لجنة تنفيذية عام ١٩٧٤. وقام برسامة أسقف عام للشباب، يواصل ضمن مهامه مهام أسقف التعليم في دوائر الشباب.
تتوسع الكنيسة في رسامة أساقفة لخدمة المصريين بالخارج، الذين عرفوا بأقباط المهجر، التي أسس الخدمة فيها الأنبا صموئيل، أسقف الخدمات، في حبرية البابا كيرلس السادس، كان الهدف تواصل الكنيسة مع أبنائها ومد مظلة رعايتها لهم، وجاءت رسامة البابا شنودة لأساقفة لهم في سياق دعم تواصلهم مع الوطن الأم، ومد خدمة الكنيسة لأجيالهم التالية، وكان للمصريون بالخارج دور بالغ الأهمية في دعم مصر بعد حرب 1967 وكان دينامو هذا الدعم الأنبا صموئيل عبر تواصله معهم، ويعد أقباط المهجر أحد أهم دوائر دعم الكنيسة المصرية، وفى ظني أن الإصلاح الحقيقي للكنيسة سيأتي من أقباط المهجر، لأنهم يضمون رموزًا لها ثقلها من خدام الكنيسة من الرعيل الأول الذين أسسوا كيانات ثقافية تضع في أولوياتها دعم الكنيسة.
وفى ظني أن تقسيم الإيبارشيات والتوسع في رسامة الأساقفة العموم وخدمة الشباب وإيبارشيات المهجر من الموضوعات الموجبة للفحص والتقييم، والمراكمة الواعية، التي تدفعني لتناولها في سياق طرحي هذا في مقالات تالية.
دعونا نواصل تتبع رحلة البابا شنودة التي اصطدمت سفينته بدوامات وعواصف السياسة، حتى وصلت إلى إعلان رئيس الدولة عزله وتحديد إقامته في سبتمبر ١٩٨١، لنبدأ مرحلة جديدة تمتد لنحو ثلاث سنوات، وفيها تدار العلاقة بين الدولة والكنيسة من خلال لجنة تشكلت من خمسة أساقفة بقرار رئاسي من الدولة، تضم الأنبا مكسيموس، مطران القليوبية، والأنبا غريغوريوس، أسقف البحث العلمي، والأنبا يوأنس، مطران الغربية، والأنبا أثناسيوس، مطران بني سويف، والأنبا صموئيل، أسقف الخدمات، الذي أُغتيل في حادث المنصة ٦ أكتوبر ١٩٨١، فيتم تعيين الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة عوضًا عنه.
قوبل قرار تعيين اللجنة الخماسية بغضب شعبي لكن أدبيات أفراد اللجنة تسجل أنها كانت تعود في قراراتها قبل إصدارها للبابا في ديره، وإن كانت قد تصدت لبعض المشاكل العالقة، في سبيل حلها داخل الكنيسة فيما رأته أمرًا تنظيميًا لا يحتاج ولا يرقى للعرض على البابا، الأمر الذي لم يسترح له البابا، وانعكس هذا على قراراته بعد عودته إلى مقر كرسيه بالقاهرة، وكان منها تغيير سكرتير المجمع وإسناد الموقع للأنبا بيشوي، أسقف دمياط، الذي ظل فيه لدورات متعاقبة حتى رحيل البابا، ورقي إلى رتبة “مطران”، وأطلق البابا يد الأنبا بيشوي في الكنيسة ليصبح رجل المرحلة بلا منازع، وكان عصا البابا الغليظة، لتشهد الكنيسة سلسلة ممتدة من محاكمات الكهنة التي تنتهى بإيقاف الكاهن عن الخدمة، أو قطعه من الشركة وتجريده من رتبته الكهنوتية، وكان أبرز هؤلاء القس إبراهيم عبد السيد الذي تم إيقافه دون أن يصدر بحقه أية قرارات سالبة لكهنوته أو عضويته الكنسية، وبقي على رتبته الكهنوتية حتى وفاته، وكانت أزمته محل تناول الصحف بشكل كبير، يذكر أنه قدم أكثر من طلب أن تكون محاكمته علنية ولم يُستجب له، ولم تكتمل محاكمته حتى وفاته.
وقد تناولتُ قضية المحاكمات الكنسية في أكثر من مقال بمجلة “مدارس الأحد” كان أخرها عن ملابسات إيقاف الراهب القس أغاثون الأنبا بيشوي، الذي عين سكرتيرًا للبابا وكان شاهدًا على محاولات الدولة التواصل مع البابا لإثناءه عن قرار عدم صلاة عيد القيامة 1980 بالكاتدرائية وعدم استقبال المهنئين الرسمين، والاعتكاف بالدير، وتم نقله للخدمة بكنيسة أبي سيفين بمصر القديمة، ثم في يونيو ١٩٩٤ صدر بحقه قرارًا بالإيقاف، وجاء المقال ضمن ملف خصصته المجلة لمناقشة أزمات الكنيسة وقتها، في عددها الصادر في أغسطس ١٩٩٤ الذي على أثره اصدر البابا قراره بعدم اعتراف الكنيسة بالمجلة.
بعد الرسامات الأولى للأساقفة، التي اختيرت من رفاق الطريق من القامات المخضرمة صاحبة الرؤية والخبرة، تأتي الرسامات التالية في أغلبها بمعايير مختلفة عن سابقتها، يتقدمها معيار الثقة مع غياب الخبرة، وكانوا من الشباب الذين لم يمكث جلهم في الدير سوى سنة إلى ثلاث سنوات على أقصى تقدير، الأمر الذي انعكس سلبًا على إدارتهم لإبارشياتهم التي أقيموا عليها، وكان لهم الغلبة في المجمع، ولكل هذا كانت قرارات المجمع التي يصيغها سكرتيره تصدر بالتمرير، بما فيها قرار قطع الدكتور چورچ حبيب بباوي، وكانت نصيحة السادات للبابا كما صرح بها في واحدة من خطبه بيِّض لحاهم يا شنودة
، ودفع البابا الثمن، كما حدث مع رحبعام بن سليمان. ويحدث تحول في فهم طبيعة عمل الأسقف ودور الكنيسة من طبيب ومشفى يداوي المخالفين إلى قاض ومحكمة تتعقبهم وتعاقبهم. بل وتمد هذا الدور لتتعقب كل من لا يستريح له مدبروها.
وعندما يتقدم العمر بالبابا تظهر الصراعات بين دائرة الأساقفة القريبة منه، لعل أبرزها سباق الأنبا بيشوي، مطران دمياط وسكرتير المجمع والأنبا يوأنس، سكرتير البابا آنذاك، في السعي للاستحواذ على رضا البابا، ثم يتطور الأمر إلى رسامته أسقفًا عامًا في موقعه ضمن طاقم السكرتارية، ليصبح عين وأذن سكرتير المجمع عند البابا ويحاصر مساعي غريمه.
على صعيد آخر تظهر عبقرية البابا شنودة الكنسية، والسياسية، في قراره التاريخي بزيارة الڤاتيكان ولقاء بابا روما ـ البابا بولس السادس ـ التي تمت في ١٠ مايو ١٩٧٣ بعد نحو عام من توليه موقعه، لينهي قطيعة ممتدة لنحو خمسة عشر قرنًا بين الكنيستين، والاتفاق على إعلان أو بيان يعلنا فيه القضايا اللاهوتية والكريستولوچية، المشتركة، والتأكيد على مواصلة الحوار حول القضايا الخلافية، لكنه قوبل بمعارضة شيوخ المجمع حال عودته فتم تجميد تفعيل الإعلان.
مازال للطرح بقية يحملها مقال مقبل.
صدر للكاتب:
كتاب: العلمانيون والكنيسة: صراعات وتحالفات ٢٠٠٩
كتاب: قراءة في واقعنا الكنسي ٢٠١٥
كتاب: الكنيسة.. صراع أم مخاض ميلاد ٢٠١٨