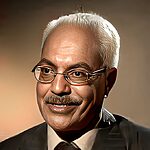ما نعرفه عن الحضارة المصرية القديمة نزر يسير، ليس فقط قياسًا على ما كانت عليه، بل قياسًا على ما تعرفه الجامعات العالمية وما توفره الكتب الدراسية للمراحل التعليمية الأساسية قبل الجامعية في الدول الأوروبية، فمازلنا نجهل سر منحوتاتهم التي تعاملت مع صخور عصية على النحت، صلادة وصلابة، فيما استطاع المصري القديم أن يطوعها لتبرز دقائق التشريح في المجسم حتى لتكاد أن تنطق.
ولم نستطع أن نكشف أسرار علم التحنيط عندهم، ولا سر الأهرامات بكتلها الثقيلة التي يزيد وزن الحجر الواحد منها عن الطن من الكيلوجرامات، كيف نحتت وكيف رفعت وكيف تشكلت بهذا التدقيق الهندسي.
ولم نسبر غور متون الأهرام ومخطوطات المعابد التي تسجل علومهم وما وصلوا إليه، وتركنا الأمر للأساطير لتقدم لنا تفاسير غيبية لكل هذا، ولعلنا مازلنا نتذكر ما كتبه الأستاذ أنيس منصور تأسيسًا على ما ذهبت إليه تأويلات الأساطير، عن بناء الأهرامات واستدعى كائنات من عوالم أخرى وينسب لها هذا العمل المعجز، وسجل هذا في كتابين؛ “الذين هبطوا من السماء”، و”الذين عادوا إلى السماء”.
عدم معرفتنا تعود إلى أمرين؛ الأول هو الانقطاعات المعرفية التي غشيتنا أكثر من مرة بامتداد تاريخنا، والثاني القراءة الدينية المجتزأة للحضارة المصرية القديمة واسباغ التحريم عليها بناء على ما سُجل في الكتب المقدسة من أحداث ذات صلة، وهي بالضرورة أحداث عن حقبة محددة من التاريخ المصري لا تنسحب على كل ذلك التاريخ.
يأتي الانقطاع المعرفي مبكرًا، بعد اضمحلال الحضارة المصرية القديمة، الذي شهدته مصر في دورتين، الأولى الاضمحلال الذي أعقب انهيار الدولة القديمة في نهاية الأسرة السادسة، ثم يأتي الاضمحلال الثاني بعد الدولة الوسطى. واللافت في كليهما حسب الباحثين في التاريخ المصري القديم أنهما جاءا بسبب عدة عوامل سبقتهما وقد أجملوها في أربعة محاور:
• ضعف السلطة المركزية.
• الانقسام السياسي.
• الغزو الأجنبي وهجرة أجانب من دول مجاورة واستقرارهم فيها (الهكسوس مثالًا).
• انهيار الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
استطاعت مصر أن تسترد عافيتها وتعيد توحيد مقاطعاتها، حتى حدث الغزو الروماني (30 ق. م) وفي أعقابه تتحول مصر إلى مقاطعة رومانية، وتشهد حلول اليونانية لغة محل اللغة المصرية القديمة، وهنا يتأكد الإنقطاع المعرفي، مع تراثنا المصري القديم.
ثم في غضون القرن الخامس الميلادي تشهد مصر والعالم صراعًا لاهوتيًا ينتهي بانقسام الكنيسة عقب مجمع خلقيدونية، 451م.، (مؤتمر رئاسي يضم كل أساقفة الكنيسة في العالم)، وفي أعقابه تقرر كنيسة الإسكندرية مقاطعة اليونانية واعتماد القبطية لغة، فتتحول من لغة العوام إلى لغة رسمية، وتعتمدها الكنيسة لغة لعباداتها وصلواتها، بل وتعتمد اسمها الجديد “الكنيسة القبطية”، لندخل في انقطاع معرفي جديد، يباعد بيننا وبين الحضارة المصرية القديمة.
ثم يتجدد الانقطاع المعرفي والحضاري الأكبر في غضون القرن العاشر الميلادي، بعد استتباب الحكم والسيطرة للعرب، وفيه يتقرر التحول القسري من القبطية إلى العربية، وتتراجع القبطية لتنحسر وتنحصر في الصلوات الكنسية، لكنها تفسح مساحة لتعريب الصلوات والطقوس، ويبدع الأقباط في التعامل مع اللغة العربية لتصل إلى إحدى ذراها في في القرن الثالث عشر، الذي يطلق عليه “العصر الذهبي للأدب المسيحي العربي” حسب توصيف الدكتور عزيز سوريال عطية، أستاذ تاريخ العصور الوسطى، وأحد مؤسسي جامعة الإسكندرية، ومعهد الدرسات القبطية، وهو ما تناوله الباحث المصري الصديق نبيل منير في كتاب “تعريب صلوات الكنيسة القبطية- القرن الثالث عشر؛ أولاد العسال”، والصادر عن دار جذور للطبع والنشر 2025.
بقيت الكنيسة القبطية من خلال طقوسها وألحانها الكنسية خيطًا رفيعًا ممتدًا متصلًا بطيف من الموروث الحضاري المصري، تجلي في العديد من طقوسها التي “عَمَّدتها” من موروثها المصري، خاصة فيما يرتبط بشخص السيد المسيح، في تأكيد لكونه ملكًا عليها، فاختارت الألحان التي كانت تقال للملك المصري القديم في مناسبات ميلاده وتتويجه وتجنيزه ودفنه، أعادت اللحن بعد صياغته قبطيًا لتؤديه في مناسبات ميلاد وتجنيز ودفن الرب يسوع المسيح، واستكملته بلحن يوناني في مناسبة قيامته.
ومازلنا نتذكر التفاعل الشعبي المصري مع الألحان المصرية الفرعونية القديمة التي واكبت موكب نقل المومياوات بأداء مبهر للفنانة المصرية السبرانو أميرة سليم- أبريل 2021. وكان تفاعلًا وجدانيًا لافتًا رغم اختلاف اللغة، لكنه الحنين الجيني.
تصادفنا في هذا السياق ثلاث ألحان كنسية، الأول لحن يقال في استقبال الملوك، ويعرف بلحن إبؤورو
وهي كلمة قبطية تعني يا ملك السلام
، ويؤدي بعدة طرق منها ما يناسب أجواء الفرح والابتهاج ومنها ما يناسب أوقات الحزن والانكسار؛ لكنه في كل الأحوال يترجم حضور المسيح في المشهد كملك.
يا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا.
فرق أعداء البيعة [الكنيسة]، حصنها بالإيمان بحصون عالية منيعة فلا تتزعزع أبدًا.
عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس.
ليباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا.
نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا.(الكلمات العربية للحن إبؤوؤو)
اللحن الثاني هو لحن بيك إثرونوس
وتعني كرسيك يا الله
، وكان يقال في مراسم وداع ودفن الملوك في مصر القديمة، وقد وضعت عليه كلمات من المزامير تناسب لحظة وداع السيد المسيح.
كرسيك يا الله إلى دهر الدهور،
قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك.
طوبي للذي يتفهم في أمر المسكين والفقير،
في يوم السوء ينجيه الرب،
هلليلويا.(الكلمات العربية للحن بيك إثرونوس)
يُصلىَ اللحن مرتين في أسبوع الآلام؛ مرة في صلوات الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء، وفيها يتكلم المسيح عن الدينونة متى جاء ابن الإنسان في ملائكة القديسين، يجلس على عرش مجده وتجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض
(متى 25).
ومرة في صلوات الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة العظيمة. وفيها -كما تؤمن الكنيسة- نزل المسيح إلى الجحيم وأطلق أبونا آدم وكل الذين رقدوا على الرجاء وترك الأشرار في الجحيم وكأن المسيح جلس على العرش وميّز بين الأخيار والأشرار فنقول له كرسيك يا الله إلى دهر الدهور
حسب القديس بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين.
ولأنه كان يتلى عند الملوك الفراعنة في مناسبتي دفن الملك الراحل وتجليس الملك الجديد، لذلك تجده في الكنيسة يجمع بين نغمتي الحزن في بدايته، والفرح في نهايته. بين موت المسيح وانتصاره على الموت.
اللحن الثالث هو لحن “غولغوثا” وتعني “الجلجثة” وهي الرابية التي نُصِّب عليها صليب السيد المسيح، ويقال في أصله الفرعوني في مراسيم تحنيط الملوك والفراعنة، واعتمدته الكنيسة القبطية ضمن طقوسها على يد البابا أثناسيوس الرسولي (حوالي عام 328 م)، بعد أن أعادت صياغة كلماته بما يتفق وواقعة دفن جسد المسيح، ويُرتل في نهاية يوم الجمعة العظيمة. ويحكي أبرز معالم تلك اللحظات.
الجلجثة بالعبرانية، والإقرانيون باليونانية،
الموضع الذي صُلبت فيه يارب،
بسطت يدك، وصلبوا معك لصين، عن يمينك وعن يسارك، وأنت كائن في الوسط أيها المخلص الصالح.
المجد للآب والابن والروح القدس.
فصرخ اللص: اليمين قائلًا: اذكرني يا رب، أذكرني يا مخلصي، أذكرني يا ملكي، متى جئت في ملكوتك.
أجابه الرب بصوت وديع: اليوم تكون معي في ملكوتي.
الآن وكل آوان وإلى دهر الدهور، آمين.(الكلمات العربية للحن غولغوثا)
كان حرص الأقباط وكنيستهم على تضمين طقوسهم وصلواتهم بعض من الألحان المصرية الملوكية القديمة من الحضارة الفرعونية، نوع من التأكيد على التواصل مع الجذور المصرية، وعلى حرصهم بوعي على تراثه، وكانت الاختيارات مدققة يتأكد فيها عقيدتهم في المسيح يسوع وشخصه في ترجمة وجدانية للاهوت التجسد، تبقىَ ما بقي الوجدان والإبداع.
ربما ينبهنا هذا إلى تقصيرنا في اكتشاف عمق وأصالة كنيستنا وبعدها المصري الذي تترجمه في عبادتها.
صدر للكاتب:
كتاب: العلمانيون والكنيسة: صراعات وتحالفات ٢٠٠٩
كتاب: قراءة في واقعنا الكنسي ٢٠١٥
كتاب: الكنيسة.. صراع أم مخاض ميلاد ٢٠١٨