بعيدًا عن الماراثون الموسمي الذي ينطلق عقب كل حدث طائفي، أو هكذا يُطلق عليه، فيما هو في حقيقته عمل إجرامي بحصر المعنى، لكنها أنساق استقرت، وكدنا نعرف ردود الفعل على تباينها، بين صامت ومتهلل ومستنكر ومحلل ديني، وانتهازي سياسي، فضلًا عن دكاكين حقوقية متسلقة لما تقتات عليه، وينفض السامر، فكل شيء عندنا يُنسى بعد حين.
فكرت مليًا في أن انسخ واحدة من مقالاتي أو مداخلاتي المتلفزة بامتداد أربع عقود وربما أكثر، ذات صلة بأحداث مماثلة، وأعيد نشرها بعد تعديل تواريخها ومواقع الأحداث مع الاحتفاظ بتوصياتها المتكررة، ومعها تتكرر البيانات الرسمية التي تتراوح بين إنكار الوقائع، أو روايتها بقراءات مسطحة، تنفض يدها من مسؤوليتها عنها وتُحمّلها لكيانات تستهدف السلام الاجتماعي ووحدة الوطن، وتشيد بقوة النسيج الاجتماعي وسلامته، وتذهب إلى مفردات الاستهداف الصهيوأمريكي، والمؤامرات الكونية!!.
أبرز من تبنى هذا التوجه كان الرئيس الراحل، أو قل الرئيس المؤمن، أنور السادات في إدارته لأزمة أحداث الزاوية الحمراء ـ 17 يونيو 1981 ـ وهي واحدة من أعنف الأعمال الإجرامية في مسلسل استهداف الأقباط، وقتها، انطلاقًا من أنه يراها مجرد خلاف بين جارين في بناية، يحدث كل يوم، وحكى عن سقوط مياه مسح أرضية شقة على غسيل شقة أسفلها، ليتحول الأمر إلى “خناقة” تصادف اختلاف طرفيها في ديانتهما، ثم يقفز على الأحداث ليتهم جهات عديدة بتأجيج الحدث ليصل إلى فتنة طائفية، وكان عادلًا في توزيع اتهاماته بين شيوخ الفتنة والكنيسة وفي مقدمتها البابا شنودة، واللافت أن كل الأسماء والشخصيات التي ذكرها شملتها اعتقالات سبتمبر من نفس العام.
لم تتغير الذهنية التي تدير هذه الأحداث، وهذا ما يكشفه بيان وزارة الداخلية الأخير عن أحداث قرية “نزلة الجلف” بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، وفيه يؤكد على حدوث مشاجرة بين عائلتين، نشبت بينهما نتيجة ارتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى، وحسب البيان: حاول البعض إضفاء الأبعاد الطائفية حيال الواقعة لاختلاف الديانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وبالعرض على النيابة قررت حبس الشاب على ذمة القضية. وأعقب ذلك تصالح العائلتين خلال جلسة صلح عُرفية وفقا للعادات والتقاليد السائدة بالقرية
.
ولم ينتبه البيان إلى متغير تقني جعل الأحداث متاحة في كل يد، وتأتي موثقة، صوت وصورة، التي أشارت إلى تهجير الأسرة القبطية، واحدة من أطراف الواقعة، خارج نطاق القرية، ولم يشر البيان حتى إلى إجراء تحقيقات حول هذا الكلام، نفيًا وإثباتًا.
المنطلقات باقية دون سعي لتجفيفها، فمازال الفرز الطائفي عنصرًا فاعلًا في المجتمع، على أصعدة مختلفة، رغم إنكاره، وينعكس هذا على الحياة اليومية، خاصة في محافظات الصعيد، وفي مقدمتها المنيا، بلد المتناقضات، لولا طيف من عقلاء الأمة، يسعون في بسالة للدعوة لدولة المواطنة اتساقًا مع الدستور، وما زالت الأصوات الأمينة تلح في تفعيل النص الدستوري بالتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض
. (مادة 53 من دستور 2014)، وفيها يُحسب الحض على الكراهيَة جريمة يعاقب عليها القانون.
في هذا السياق أتوقف عند ثلاث أمور؛ أولها “الجلسات العرفية”، وهي من مسماها تستند إلى ما استقر في العرف، وهو مرحلة في التطور القانوني تراجعت مع اكتمال المنظومة القانونية، وتأتي في أحوال كثيرة، منها ما حدث بواقعة “نزلة الجلف” افتئاتًا على القانون وإهداره، لأنها أصدرت أحكامًا وعقوبات بغير نص في القانون، في حين هناك قاعدة قانونية تقول إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وحسب الواقع المَعِيش تتحول تلك الجلسات إلى جلسات إذعان، يتلقى الطرف الأضعف أحكامها ويخضع لها في انكسار وخنوع، تجنبًا لما هو أسوأ.
وفي بحث عن هذه الجلسات أكد على أنها تنتهك الدستور في أحيان كثيرة، مثل فرض قيود على حرية العقيدة أو التهجير القسري، وهو ما يعتبر جريمة بموجب الدستور، وأنها تفتقر إلى ضمانات التقاضي العادل، وقد تكون آلية للقضاء على الضعيف وإهدار حقوقه، خاصة عندما يكون هناك فراغ أو غياب أمني. وينتهي البحث إلى أن القانون المصري يعترف بالتحكيم العرفي كآلية لحل النزاعات، ويوثق الأحكام العرفية، ويحمي حقوق الأطراف من خلال الإجراءات القانونية، ولكنه ـ القانون ـ في الوقت نفسه يسعى إلى الحد من انتهاكات الجلسات العرفية، خاصة في النزاعات الطائفية.
الأمر الثاني أن هذه الجريمة واحدة من تداعيات التحول الدراماتيكي في التوجه العام الذي اجتاحنا مع عقد السبعينيات من القرن الماضي، مع طوفان المد الديني السياسي، وقيل وقتها أنه أعيد إحيائه لمواجهة الحضور اليساري والناصري وقتها، وإن كانت الأحداث التالية جاءت لتؤكد أنه تحول جاء عن قناعة النظام بحتمية تديين الفضاء السياسي والعام، وفقًا لمتطلبات تحالفاته الإقليمية آنذاك، التي بدأت بالمصالحة مع جماعة الإخوان، وإفساح مكانًا لها في صدارة المشهد السياسي، وسيطرتها على مفاصل تشكيل العقل الجمعي، ثقافة وتعليمًا وحتى إلى آليات الإبداع، الكتاب والسينما والمسرح والمظهر الحياتي، وكان الثمن فادحًا، لعل أبرز تجلياته اغتيال رأس الدولة بعد مصادمته مع التيار الذي أحياه بعد أفول.
كان الأقباط هم الرقم الصعب الذي يعرقل تحقيق إقامة الدولة الإسلامية، حلم وسعي تلك الجماعة وما تفرع عنها من جماعات راديكالية عُنفية، فكان أن توجهت تلك الجماعات إلى استهدافهم والتضييق عليهم، وتشهد مصر سلسلة من الأعمال الإجرامية ضدهم، في قرى ومدن الصعيد، وتسمى “أحداثًا طائفية” لترسيخ شيوع مسؤولية أطرافها عنها، فتتحول من توصيفها جنائيًا إلى “مصادمات مجتمعية” يمكن حلها بعيدًا عن القانون.
اللافت هو خفوت وظهور هذه الأعمال الإجرامية وفق طبيعة علاقة هذه الجماعات مع النظام، تصالحًا وتصادمًا، والشاهد أن ثورة 30 يونيو كانت واحدة من تجليات الصدام، لأنها انحازت إلى الدولة المدنية، وأعلنت وقتها أن مصر وطن لكل المصريين، ومن لحظتها لم تكف أبواق تلك الجماعات عن إعلان عدائها للدولة، وترجمته في عديد من الأعمال الإرهابية، وكان الأقباط في صدارة المستهدفين، باعتبارهم ـ وبامتداد عقود ـ العصب الملتهب في المشهد المصري، واستهدافه يأتي بردود فعل تتجاوز الإقليم، وفي سياق إفساد ما يمكن أن يدعم الدولة من إنجازات على الساحة الدولية، ومنها نجاحها في ترتيب مؤتمر شرم الشيخ الخاص بإنهاء الحرب في غزة، تتفجر عمدًا أحداث نزلة الجلف الأخيرة، استغلالًا لما صارت عليه الذهنية العامة من تطرف فكري ورفض للآخر كنتيجة طبيعية لتديين الفضاء العام وآليات تشكيل العقل الجمعي بمنهج ورؤية التيارات المتطرفة. ولهذا أظن أن ما يحدث في المنيا، ليس عفو الخاطر. إنما هو مدبر ضد الدولة لإجهاض ما حققته على الساحة الدولية، ليجعلوا من الأقباط مِخْلَب قط لتفجير السلام الاجتماعي.
الأمر الثالث هو ما يتعلق بمطالب البعض بتدخل الكنيسة وإعلان شجبها واستنكارها لأحداث العنف تلك، وإدانتها على صمتها، وهي مطالب قد يبدو أن لها مبرراتها، لكنها مؤشر على أن مفهوم الدولة المدنية مازال غائمًا، فبينما يرفضون تديين السياسة وقياس الحقوق والواجبات على أرضية دينية، يعودون للمطالبة بدور سياسي للكنيسة، ويستنجدون بها كممثل ووكيل سياسي عن الأقباط، في حين هذه مهمة الدولة بمؤسساتها الدستورية الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، تأسيسًا على كون الأقباط “مواطنون مصريون كاملي المواطنة”، وعليهم ـ الأقباط ـ التيقن من كينونتهم هذه ويناضلون عبر القنوات السلمية لتأكيدها في مواجهة سعي إقصائهم واستبعادهم، والانتقاص من مواطنتهم، وأتذكر مقولة للصديق الراحل سليمان شفيق “أن الأقباط في 30 يونيو خرجوا بالكنيسة للوطن”، وكانوا بغير وصاية رقمًا فاعلًا في نجاح الثورة.
الكرة في ملعب الدولة ـ المؤسسات والأجهزة ـ لتعيد الوطن إلى مربع الدولة المدنية، وتضمن حقوق مواطنيها المستقرة لهم، وقد نص الدستور في ديباجته، نكتب دستورًا يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز
، وتنص مادته الرابعة على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور
، فيما يتأكد نفس المعنى في مواد عدة:
(مادة 8) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون
.
(مادة 9) تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز
.
ومن ثم فعليها أن تعيد هيكلة منظومات التنشئة بوعي وجدية، التعليم والإعلام والثقافة، بتنقيتها من التوجهات الإقصائية التمييزية والمتطرفة لبناء جيل جديد يدرك ويؤمن ويعيش المواطنة لنلحق بركب الدول التي خرجت إلى النهار.
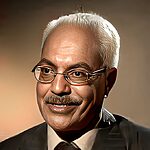
كمال زاخر
صدر للكاتب:
كتاب: العلمانيون والكنيسة: صراعات وتحالفات ٢٠٠٩
كتاب: قراءة في واقعنا الكنسي ٢٠١٥
كتاب: الكنيسة.. صراع أم مخاض ميلاد ٢٠١٨

