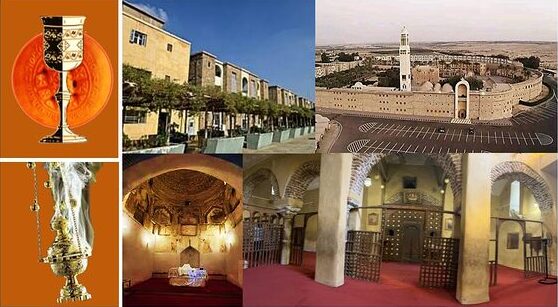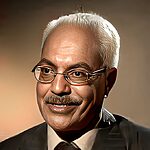بحكم طبيعة المرحلة العمرية حين عَرفَت أقدامنا الطريق إلى دير الأنبا مقار، كان شغفنا يدفعنا للتعرف عليه، البشر والحجر، خاصة أنه كيان يلفه الغموض، يكاد يكون منقطع الصلة بالعالم خارجه، فلا أخبار عنه في الإعلام، ولا وجود لرهبانه خارج أسواره، وتخلو قائمة أساقفة الكنيسة في ذاك الزمان من منتسبين له، بل اللافت أن ثمة أساقفة كان اختيارهم مكافأة لهم لأنهم قفزوا فوق أسواره، ولجأوا إلى دير الأنبا بيشوي، وأعلنوا رفضهم لسياسات ديرهم الأول، الأمر الذي حُسب انتصارًا للقيادة الكنسية آنذاك.
كان البعض الآخر من رهبانه قد تركوه واتجهوا إلى دير الأنبا بيشوي، لتمسكهم بالرهبنة دون أن تزاحمهم طموحات أخرى، بعد معاناة مع قيادات الصف الثاني الذين أُسند إليهم تدبير شؤونه في غياب الأب متى المسكين، في فترات اعتكافه خارجه، أو داخله في فترات انشغاله بتدوين كتبه التعليمية واللاهوتية.
كانت معاناتهم مردها افتقار مدبري الدير للتوازن الذي كان عند الأب متى بين الأبوة والإدارة، كانت رؤيتهم أن الشدة هي أفضل منهج للإدارة حتى لو عوقت التزامات رهبانه بنذورهم وبنائهم النفسي والروحي. وأن الطاعة فوق القوانين أو التدابير الروحية التي تبني الراهب.
هذه الجماعة من الرهبان الذين ذهبوا إلى دير الأنبا بيشوي، بعضهم تمسك بشكله الرهباني المقاري، وبعضهم غيّره إلى وضعهم الجديد، لكن جلهم هربوا من الرسامات الأسقفية بل وبعضهم بقي على شكله الرهباني دون أية رتبة كهنوتية حتى رتبة الشماسية.
بلورت وشكلت كتب وعظات الأب متى المسكين رافدًا أساسيًا في تجسير الفجوة مع فكر الكنيسة الأولى والآباء، خاصة وأنها ترجمت زخم التعليم الآبائي عن لغته الأصلية (اليونانية) أو القبطية، وليس عن لغات وسيطة، بعد انقطاع معرفي معهما امتد لقرون، بفعل التحول من اليونانية لسانًا وثقافة إلى القبطية، بانحيازات قومية أشعلتها صراعات مجمع خلقيدونية (451م)، ثم في القرن الحادي عشر الميلادي يأتي الانقطاع المعرفي الثاني بعد استتباب الحكم للعرب، ومنعهم للأقباط التحدث بغير العربية، فكان تحول الأقباط لها قسرًا، لتدخل الكنيسة والأقباط في نفق مظلم طال، وإن تخلله شهب تحاول إنارته لكنها كانت تفتقر للمراكمة والديمومة.
وكان أن استقدم الدير معلمون متخصصون في اللغة اليونانية، لتعليمها لرهبان الدير، وانعكس هذا على منتجهم الفكري في العديد من الكتب التي أصدروها. ووجدت لها مكانًا بجوار كتب الأب متى.
طلبنا من الدير أن يسمح لنا بالإقامة بالدير يومان كاملان أو أكثر، وجاءت الموافقة، مكثنا في رحابه نحو ثلاث أيام، الجمعة والسبت والأحد، فيما يسمى بالخلوة، خصصوا لنا غرف في المكان المعد لذلك في الدور الثاني بالقرب من القلالي، كانت تعليماتهم الالتزام بضوابط الدير، وقلة الحركة، وعدم الضوضاء، والاشتراك في قداس الأحد، وكانت لنا جلسات مثمرة مع الأب الراهب مسؤول “الخلوة”، ونشهد له بغزارة علمه وسعة صدره، واحتماله لمشاغباتنا الفكرية وأسئلتنا الشائكة، وتم توزيعنا في توقيتات العمل لمشاركة الرهبان في العمل اليومي بمشروعات الدير المختلفة.
في فجر الأحد يدق جرس الكنيسة معلنا بَدْء صلاة التسبحة، يتم إيقاظنا لنعد أنفسنا للذهاب لكنيسة الدير الرئيسية (كنيسة الأنبا مقار الأثرية)، نذهب والظلام باق، نتلمس طريقنا وندخل الكنيسة، لنجد فيها نفر من الرهبان يصلون وظهورهم لحائط الكنيسة، كان اللافت أنهم يقفون متباعدين، وعندما يفد راهب يقف في مكان يعرفه، حتى اكتمل حضورهم، واكتمل صفهم، لم يكن بالكنيسة سوى دكتين أو ربما ثلاث، كانت مخصصة لشيوخ الرهبان، من الكهول.
تبدأ صلوات التسبحة، في تناغم وانضباط وطبقة صوتية واحدة لا يشذ عنها واحد، وكأنك أمام فريق إنشاد يسجل صلواته في ستوديو صوت، كانت أغلب الصلوات باللغة القبطية، التي تألفها آذاننا، لكننا لا نفهم كلماتها، ونحاول جاهدين أن نتابعها من خلال كتب التسبحة التي تضمها في نهرين أحدهما قبطي معرب والثاني ترجمة عربية لها، ما أن تنتهي التسبحة حتى يبدأ القداس، وتتنوع الصلوات فيه بين القبطي والعربي، ويتخلله القراءات، وتشمل (البولس) قراءة من رسائل القديس بولس، ثم (الكاثوليكون) قراءة من الرسائل الأخرى التي يضمها العهد الجديد، ثم (الإبراكسيس) قراءة من سفر أعمال الرسل، ثم (المزمور) قراءة من مزامير داود النبي، ثم (الإنجيل) قراءة من أحد الأناجيل الأربعة، وهي قراءات يومية تغطي السنة الليتورجية، ولها تقسيماتها وترتيباتها ومقسمة ومرتبة بوعي لاهوتي تعليمي موقعة على مناسبة اليوم في الحياة الكنسية والحياة العامة ومواسمها المناخية والحياتية، ويضمها كتاب يسمى القطمارس، وهي كلمة معربة عن اليونانية (كاتاميروس) وتعني حسب الفصل.
يعقبها صلوات شجية تستعرض بإيجاز مدقق، علاقة الله بالإنسان، منذ خلقه، وتَعرِض لتطور تلك العلاقة من لحظة وجود أبوينا، آدم وحواء بالجنة، فالعصيان، والخروج منها، وسعي الله للعناية بهما، وبالبشرية، ومواصلة افتقاده لهم عبر سلسلة من الأنبياء، حتى حدث تجسده وتأنسه، وصولًا إلى الصليب والموت والقيامة، الذي بموته وقيامته رد أدم إلى رتبته الأولى وصالح السمائيين مع الأرضيين، وفتح لهم الملكوت مجددًا.
وتتضرع الكنيسة في صلواتها من أجل سلام العالم وكل الخليقة، وكل ما فيها البشر واحتياجاتهم، ومن أجل المرضى والراحلين والزروع والمياه والرؤساء وسلام هذا العالم، وسلام الكنيسة، ثم تعود الكنيسة لتذكرنا بالحدث الأعظم والعهد الذي أقامه الله معنا عندما جلس مع الكنيسة الأولى (تلاميذه)، وأسس معهم سر الشكر (الإفخارستيا) عهدًا جديدًا، يدوم إلى يوم مجيئه، ثم تدعو الكنيسة كل الحضور ليشتركوا في التناول من الأسرار المقدسة.
لم نكن وقتها قد اتفقنا على التقدم للتناول لكننا وجدنا أنفسنا نقف في طابور المتقدمين للتناول، هكذا.
في هذه اللحظة تذكرت حديث التلميذين اللذين قصدا بلدة عمواس، يائسين بائسين، جراء أحداث الصلب والموت والدفن، وقد ظهر لهم الرب دون أن يعرفاه ربما لشدة الحزن والانكسار، يدور بينهما وبينه حوار ممتد، ثم يخبرنا الإنجيل أنهم اقْتَرَبُوا إِلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ إِلَيْهَا، وَهُوَ تَظَاهَرَ كَأَنَّهُ مُنْطَلِقٌ إِلَى مَكَانٍ أَبْعَدَ. فَأَلْزَمَاهُ قَائِلَيْنِ:«امْكُثْ مَعَنَا، لأَنَّهُ نَحْوُ الْمَسَاءِ وَقَدْ مَالَ النَّهَارُ». فَدَخَلَ لِيَمْكُثَ مَعَهُمَا. فَلَمَّا اتَّكَأَ مَعَهُمَا، أَخَذَ خُبْزًا وَبَارَكَ وَكَسَّرَ وَنَاوَلَهُمَا، فَانْفَتَحَتْ أَعْيُنُهُمَا وَعَرَفَاهُ ثُمَّ اخْتَفَى عَنْهُمَا، فَقَالَ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ:«أَلَمْ يَكُنْ قَلْبُنَا مُلْتَهِبًا فِينَا إِذْ كَانَ يُكَلِّمُنَا فِي الطَّرِيقِ وَيُوضِحُ لَنَا الْكُتُبَ؟»
. [1]
وعندما جلسنا مع الأب الراهب كان سؤالنا عن تفسير تقدمنا للتناول دون اتفاق، فلم تكن من عاداتنا قبلها، أن نفعل هذا بالضرورة في كل قداس، فكان الدرس الأول أن حضورنا القداس لا يستقيم بدون الاشتراك في التناول، فنحن أمام سر أسرار الكنيسة، ثم بدأ يفسر لنا، أننا حضرنا للصلاة وما زالت مشاغل العالم الذي جئنا منه تشاغلنا، وعندما حضرنا التسبحة راحت الصلوات وألحانها تخرجنا شيئٍا فشيئًا من دائرة تلك المشاغل، بفعل وتأثير مناخ الصلاة التي وجدنا أنفسنا فيه، الهدوء الصوت الخفيض الأداء الروحاني، انسحاب الظلمة وانبلاج النور المتدرج، عندما بدأت صلوات القداس، كان الانتباه مركزًا على الصلوات وتدرجها، حتى إلى التماهي معها، وحين جاءت الدعوة للاشتراك في وليمة الإفخارستيا، كان وجداننا متعلق بمن دعانا لنشترك في جسده ودمه اللذان هما مأكل حق، ومشرب حق. وبهما يتأكد ثباتنا فيه وثباته فينا، حسب كلام الرب يسوع نفسه.
سألناه عن مشاهداتنا عن ترتيب وقوف الآباء الرهبان، فقال إن هذا ترتيب رهباني متوارث، أن يقف الراهب وفق أقدميته في الرهبنة، يلي من سبقه فيها، ويسبق من ترهبن بعده، بغير مزاحمة أو اختيار المتكأ الأول.
سألناه عن سر هذا الدير وكيف استطاع أن يحتفظ بهذه الصورة المبهجة، وكيف نجح ـ وقتها ـ في أن يعيد إنتاج الصورة الآبائية التي ارتسمت في أذهاننا، حيث الرهبنة للرهبنة، ولا يزاحمها شهوة الكهنوت، وكيف يحتمل قاصديها انضباطها ونذورها في عالم مختلف، بين التطلعات والضغوط، والفرص البديلة، وكيف تتنازل الـ”أنا” لحساب الـ”نحن”؟.
كانت إجاباته محل سهرة ممتدة استهلكت معظم تلك الليلة، وهو ما سنعرضه في جزء تال.
صدر للكاتب:
كتاب: العلمانيون والكنيسة: صراعات وتحالفات ٢٠٠٩
كتاب: قراءة في واقعنا الكنسي ٢٠١٥
كتاب: الكنيسة.. صراع أم مخاض ميلاد ٢٠١٨